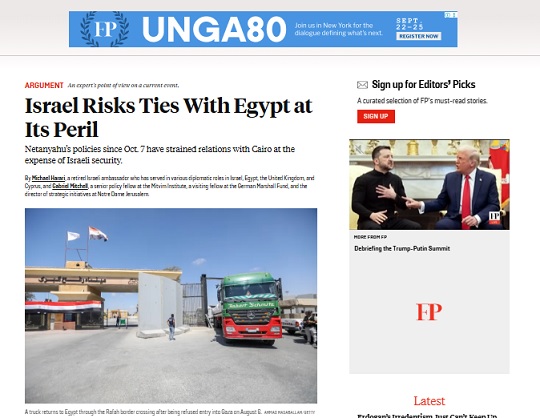* الرمز يمتد عبر الزمن من الإله أوزوريس إلى السيد المسيح، ومن معابد المصريين القدماء إلى كنائس أم الدنيا.. .
* النخلة رمز الانتصار والسلام والقمح رمز الخير والأمن
بينما تمتلئ شوارع القاهرة ببهجة الأعياد، تصطف الأسر أمام الكنائس القبطية، تتزين أيدي الصغار والكبار بسنابل القمح وقلوب النخيل، وتيجان ذهبية اللون، وصلبان ومجوهرات واكسسوارات مضفورة بحرفية من سعف النخيل، يلوّحون بها كما فعلت جماهير أورشليم الحاشدة منذ أكثر ألفي عام، عندما استقبلت السيد المسيح. لكن، خلف هذا المشهد الاحتفالي، تمتد جذور السعف عميقًا في أرض مصر، حضارة وتاريخًا وروحًا.
في أحد الشعانين، لا يُختار أي سعف لصنع الصلبان أو الجدائل، بل يُنتقى "قلب النخلة" تحديدًا: ذاك الجزء الأبيض النقي اللين، الذي يُستخرج من أعماق النخلة، عاشقة الحياة والتي تمنحه بسخاء، وكأن هذا البياض الخالص هو وحده القادر على التعبير عن الطهارة والنقاء الفطري والنية الصافية - كنت أتخيل وأنا طفل صغير في قرية الحمام بمحافظة أسيوط أن النخلة التي لا يؤخذ من قلبها تشعر بالحزن، لهذا كان يحرص والدي على إسعاد جميع النخل بقدر الإمكان - ولعل في هذا الرمز الطبيعي، انعكاسٌ للطلب الإلهي الذي ورد في سفر الأمثال: "يا ابني، أعطني قلبك، ولتلاحظ عيناك طرقي". فالقلب، كما قلب النخلة، هو ما يُطلب ليُقدم، وما يُفتش عنه، والعبرة هنا في العمق لا في المظهر الخارجي.
في أغلب الثقافات، عاش الإنسان بجوار النخلة، يأكل تمرها، ويُظِلّ بظلّها، ويبني بها بيته. وفى القرآن الكريم ذكرت النخلة في سورة مريم "وهزي إليكِ بجذع النخلة"، وهي اللحظة التي تجلى فيها العطاء الإلهي لمريم العذراء.

لا يحمل المسيحيون السعف كمحاكاة لتحية واستقبال السيد المسيح في أورشليم فقط، بل كرمز للانتصار، والاستعداد الروحي لأسبوع الآلام. فالسعف الأبيض النقي اللين "قلب النخلة" يرمز للقلب الطاهر، وللقداسة، وإعلان للنصرة على الخطيئة. "الصديق كالنخلة يزهو" كما يقول المزمور. هكذا يتحول السعف في أحد الشعانين إلى أكثر من زينة أو طقس: يصبح فعل محبة إنساني للخالق، وتقدمة قلب مفطور على الخير، وتطهير داخلي يليق بالموسم الذي يستعد فيه الإنسان لاستقبال القيامة من الداخل أولًا.
تبدأ قصة النخلة الأولى قبل آلاف السنين، حينما روى المصريون القدماء أن الإله أوزوريس كان أول من غرس النخلة في أرضهم. لم تكن مجرد شجرة، بل مقياسًا للزمن: جذعها عام، وجريدتها شهر، وسعفتها يوم. وفي حضن مقابر الرزيقات من عصور ما قبل الأسرات، عُثر على مومياء ملفوفة بحصير من السعف، وعلى فسائل نخيل دُفنت مع الموتى، كأنما تحمل الرجاء في الخلود. بهذا المفهوم تعد النخلة حلقة وصل بين عالمين، ولها مكانتها وخصوصيتها في مصر القديمة. وفي مقابر توت عنخ آمون (1350 ق.م)، وُجد تمر لا يزال صالحًا للأكل، ونبيذ (عرقي البلح) محفوظًا في جرار من الفخار، وقطع كعك محشوّة بعجوة لا تزال رائحتها تعبر العصور. كان النخل - وكذلك القمح - حاضرًا في الزراعة، والطقس، والطعام.. إلخ كأمن غذائي وتعبيرًا عن حالة الاستقرار والسلام الذي ميزت الحضارة المصرية القديمة والانتصار للمعنى الإنساني في الحياة.
وحتى في بناء العمارة: أعمدة المعابد حاكت جذوع النخل، وتيجانها استوحت سعفه. وحتى وقت قريب، وإلى الآن، النخلة في القرى المصرية رفيقة حياة. من جريدها صنعت الكراسي والأقفاص ومن جذوعها صنعت الأسقف، والليف تحول إلى حبال لربط البهائم وجمع المحصول . كما تستخدم في صناعة المشنة والشندة والمشقة .. إلخ بالإضافة إلى مخزون البلح طوال العام، وساعد على ابتكار وجبات مثل البلح بالسمن ومشروبات وحلويات وغيرها. حتى الأطفال اتخذوا منها بعض الألعاب مثل سِفر تريكو، وربطوا حبالا بين نخلتين متقاربتين لعمل مرجيحة للترفيه.

اكتسب عيد الشعانين مظهرًا مصريًا شعبيًا، لا يُحتفل به فقط في الكنائس، بل أصبح ملمحًا واضحًا في الشوارع، وبين المسلمين والمسيحيين على حد سواء. يشتري بعض المسلمين سنابل القمح للخير والبركة والتفاؤل. ليس مستغربًا إذن أن المصريين القدماء هم أول من قدّموا للمسيحية البلابيصا/ أو البلاميصا الذي عرف بفانوس رمضان فيما بعد، كما قدموا القصب والقلقاس في عيد الغطاس، وقدموا الكنافة والقطايف في رمضان، والفسيخ والبصل في شم النسيم. فكانت علاقة المصري القديم مع الطبيعة إنعكاسًا للعلاقة مع الروح. في أحد السعف، لا يحتفل المسيحيون بذكرى دينية فقط، بل هناك بعد ثقافي مضمر، لنعيد اكتشاف شجرة حفظت لنا مذاق التاريخ، وقوام الحياة، وروح الانتصار. النخلة هي شجرة المصري القديم، وشجرة الإنسان الذي عرف كيف يقتطع من الطبيعة ما يسمو به في حياته، وطقوسه، وأعياده، وأغانيه..
في أحد السعف، يلوّح الرعية أيضًا بعروسة القمح، القمح الذي تشكل وعي المصري القديم. فبعد اكتشاف الزراعة، كان القمح أحد أولى البذور التي زرعها المصري القديم، وجعل من مواسم زراعته وحصاده مواسم أعياد مقدسة، يشارك فيها الملك نفسه ككاهن أعلى، ويحصد السنابل بيديه، رمزًا للخصب والخلود. ولم يكن القمح مجرد غذاء، بل كائنًا مقدسًا يرتبط بالإله أوزوريس، إله البعث والحساب وهو رئيس محكمة الموتى عند قدماء المصريين، من آلهة التاسوع المقدس الرئيسي في الديانة المصرية القديمة، الذي صُوّر بلون أخضر دال على البعث والقيامة. طقوس الحصاد، بما فيها الدرس، والتذرية، والتخزين، كانت تُؤدى برفقة الأغاني، وتُختتم بطقس "عروسة القمح"، حيث تُضفر السنابل في شكل علامة الحياة (عنخ) وتُقدَّم للإله. وكان الفلاحون يتركون "البروكة" من القمح لأي عابر سبيل، إيمانًا بأن العطاء يجلب البركة.
وإذا تأملنا في تداخل هذه الرموز، سنرى كيف يتلاقى سعف النخيل وسنابل القمح في رمز واحد: الحياة المتجددة، والانتصار على الموت، وتقدمة القلب. فكأن الشعانين ليست مجرد ذكرى لدخول المسيح أورشليم، بل موسم زرع داخلي، وحصاد روحي، يربط الأرض بالسماء، والبذرة بالقيامة. كل عام ومصر كلها بخير وسلام.
---------------------------------
بقلم: هاني منسي
* كاتب وناقد