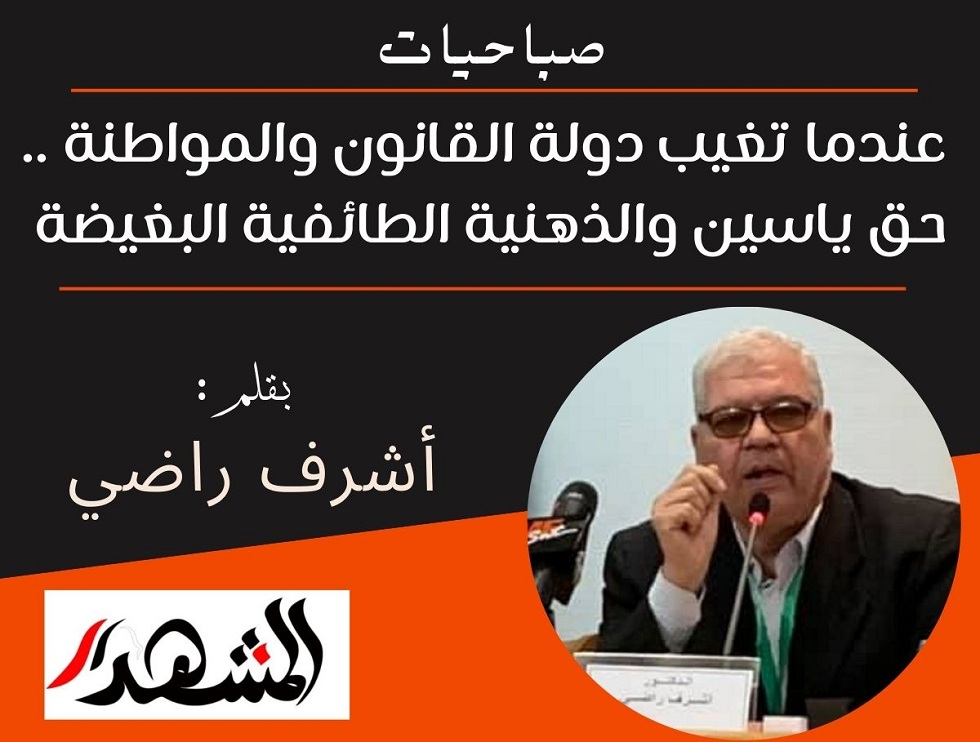عندما يصبح مضارب عقاري رئيساً للولايات المتحدة ويدير شؤون أقوى دولة في العالم، فمن المتوقع أن يتأثر بثقافة بيئة الأعمال التي جاء منها عند النظر، ليس فقط إلى مشكلات العالم، وإنما أيضاً إلى الحلول التي قد يقترحها للتعامل مع هذه المشكلات، وأن يعلو الحرص على تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب من هذه الحلول أي اعتبارات أخرى، ومن الطبيعي أن ينظر إلى العالم باعتباره فرصة عقارية، وألا يجد غرابة في ذلك، وقد لا يفهم منطق من يعارضون اقتراحاته أو تصوراته.
تشير تقارير إعلامية صدرت بمناسبة اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص مستقبل الإعمار في غزة، إلى أنه سبق وأن قدم اقتراحات مماثلة في فترة رئاسته الأولى، من بينها عرض مماثل اقترحه على كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية. هناك أيضاً أسس أخرى في الثقافة البرجماتية (العملية) المهيمنة على الثقافة الأمريكية ورؤيتها للعالم، تحكم تصورات ترامب ورؤيته، وفي مقدمة هذه الأسس فكرة أن لكل شيء قيمة أو ثمنُا، وبالتالي فإن أي شيء يمكن شراؤه بالمال، وكان هذا التصور واضحاً في العرض الخاص بغزة.
السؤال الرئيسي الذي شغل كثيراً من المراقبين والمحللين هو كيف استطاع ترامب حصد كل هذه الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، وكيف تمكن من العودة إلى البيت الأبيض رغم عدائه الواضح للمؤسسة الأمريكية الحاكمة وللدولة العميقة المتمثلة في الحكومة الأمريكية الاتحادية، وانقلابه على القيم الأمريكية. ويرى كثير من المراقبين أن الفوز الذي حققه إنما يعبر عن تحولات عميقة داخل المجتمع الأمريكي، سيكون لها تأثيرات بعيدة المدى على الولايات المتحدة وعلى العالم، بسبب ما قد تحدثه من فوضى في دولة بحجم الولايات المتحدة ونفوذها الهائل في مناطق كثيرة في العالم وتأثيرها على مصالح كثير من القوى في دول العالم المختلفة، من خلال قرارات يتخذها مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أو الرئيس الأمريكي. وبسبب هذا الوضع الفريد والاستثنائي للولايات المتحدة تتآلف قوى كثيرة داخل الولايات المتحدة وخارجها، للتعامل مع قرارات ترامب التي يصفها كثير من المراقبين بأنها قرارات متهورة وغير مدروسة.
والسؤال أين تقف النخب الحاكمة في العالم العربي في هذه المعركة؟
ثمة تقارير أشارت إلى دعم كثير من الأنظمة الحاكمة في العالم العربي لترامب، مالياً وإعلامياً وسياسياً، في فترة رئاسته الأولى وكذلك في حملته الانتخابية، رغم أحاديثه شديدة الفجاجة التي تفضح نظرته العنصرية للعرب، حتى قبل أن يصبح حلمه في رئاسة الولايات المتحدة معلوماً. وهذا الموقف في حاجة إلى دراسات معمقة لفهم هذا السلوك، ولفهم هذا الخضوع الذي أظهره كثير من الحُكَّام العرب في مواجهة إملاءاته في فترة رئاسته الأولى، أو ما يظهرونه من خوف من تأثير سياساته على مناصبهم.
ثمة علاقة غريبة بين ترامب، الذي يحسد الحُكَّام العرب الذين يتمتعون بصلاحيات مطلقة في مواجهة شعوبهم، رغم الصلاحيات الواسعة وشبه المطلقة التي يمنحها الدستور الأمريكي للرئيس، وبين هؤلاء الحُكّام الذين يدافعون عن ترامب في مواجهة خصومه الديمقراطيين داخل الولايات المتحدة وخصومه خارجها. ثمة قطاع آخر من المثقفين في العالم العربي يدعمون ترامب بسبب كراهيتهم للثقافة السائدة في مجتمعاتهم. في الحقيقة، إن هذا السلوك يفضح حقيقة موقف هؤلاء الحُكَّام وتلك النخب من إسرائيل التي تؤدي وظيفة مهمة في ترويع شعوب المنطقة من خلال سياساتها الوحشية ضد الفلسطينيين، والتي توفر سقفاً عالياً لما يمكن أن يصل إليه الحُكَّام في التعامل مع معارضيهم في الداخل.
في إحدى زياراته للولايات المتحدة، سأل صحفي أمريكي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بعد انتخابات عام 2005، متى ستصبح مصر دولة ديمقراطية؟ وأجابه أن ذلك لن يتحقق إلا بعد حل القضية الفلسطينية، التي لا يتوقع لها حلاً قريباً. وبدا التوتر واضحاً عليه في رده على سؤال آخر عن موقفه لو كان في وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه "إرهابا مسلحاً" على حد قول الصحفي. مثل هذه الإجابات تكشف الدور الوظيفي الذي يلعبه الصراع مع إسرائيل في تثبيت سلطة الحكم الاستبدادي في دول المنطقة على غرار ما شهدناه في حكم حزب البعث في كل من سوريا والعراق وحكم رجال الدين في إيران، وهو الأمر الذي يكشف عن طبيعة الترتيبات بعد الحرب العالمية الثانية للتعامل مع موجة التحرر الوطني التي اجتاحت كثيراً من المستعمرات.
إن ما حدث في الجزائر بعد الإطاحة بحكم الرئيس أحمد بن بيلا يفضح كثيراً من هذه الترتيبات التي رعتها الولايات المتحدة، بصفتها وريثاً شرعيا للإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس، وربما يفسر أيضا جانبا كبيراً من التوتر بينها وبين فرنسا التي ظلت تدافع بشراسة عن خصوصية علاقاتها بمستعمراتها السابقة.
في سياق هذه الترتيبات تدور كثير من حلقات الصراع مع إسرائيل، وتختفي وراء ستار الشعارات البراقة والمواقف العنترية الكثير من السياسات الواقعية التي تكشف التحالف الموضوعي بين المشاريع الاستبدادية في العالم العربي وبين المشروع الصهيوني، على نحو يبين كيف أن هذا الصراع يعبر بشكل كبير عن طبيعة "أزمة الديمقراطية وأزمة السلام" التي تعيشها شعوب المنطقة، والتي لخصها كتاب للمثقف المصري الراحل أمين المهدي حمل هذا العنوان.
وعي جديد لحركة تحرر جديدة
الموقف العام للمثقفين المصريين والعرب من أمين المهدي وكتاباته، والذي يتحمل المثقف الراحل قدراً من المسؤولية عنه ربما بسبب أسلوبه الاستفزازي، يعكس إلى حد كبير مدى ما تعرضت له عقول المصريين وأيضاً العرب بسبب حصار الأنظمة القمعية للعقل والثقافة وحرية التفكير والإبداع. وتناول هذه القضية الكاتب الراحل، فتحي غانم في كتاب له بعنوان "معركة بين الدولة والمثقفين"، صدر في سبتمبر عام 1995، عن سلسلة "كتاب اليوم" التي تصدرها مؤسسة أخبار اليوم. ربما يثبت صدور الكتاب الذي كان عنوان فصله الأول "كيف سيطرت المخابرات والمباحث على عقول المصريين؟"، الفرضية الأساسية التي وضعتها الباحثة السويدية، مارينا ستاك، التي ألفت كتاباً عنوانه "حرية الخطاب الأدبي في مصر في عهدي عبد الناصر والسادات"، والتي ناقشها الكتاب. تقول ستاك إنه حتى في أكثر النظم استبداداً تظل هناك مساحة ما متاحة للتفكير الحر والإبداع. ربما كان نشر الكتاب عملاً بنصيحة لنقيب الصحفيين الراحل مكرم محمد أحمد التي ذكرها غانم في كتابه بضرورة إنهاء القيود على حرية التعبير في مصر لمواجهة الأفكار الظلامية، بعد محاولة لاغتيال النقيب الراحل.
إن موقف الأنظمة الاستبدادية من المثقفين المستقلين، ومن الثقافة بوصفها فعلا إبداعيا، الحرية هي شرطه الأساسي، بدءاً بالنازية والفاشية وغيرهما من نظم شمولية وانتهاء بالطبعات الرديئة للنظم الاستبدادية التي تعتمد على ترهيب المعارضين وفرض الحصار على كل فكر مغاير وبالطبعة الأحدث للشعبوية التي يمثلها ترامب وأشباهه من ساسة غارقين في العنصرية والعداء للفقراء والمهاجرين، لم ينشأ من فراغ وإنما مصدره الأساسي هو المعركة على الوعي التي تُستخدم فيها استراتيجيات تتمحور حول خلق قضايا زائفة لتغييب القضايا الأساسية التي تمس مصالح المواطنين وحرياتهم الفردية والعامة.
إن معركتنا مع إسرائيل هي بالأساس معركة وعي ومعرفة، ولا يمكن تحقيق أي تقدم فيها بدون العلم والحرية. إن الصيغ المختلفة والمعاصرة لشعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، التي تقمع أي رؤية معارضة وتدعو إلى التفكير النقدي وإعادة النظر في أساليبنا في الحرب أو في السلام، والتي تحاصر كل رأي ينتقد المقاومة "المسلحة"، والتي تستخدم فيها أسلحة التخوين والتكفير واتهامات الانتهازية والانهزامية والاستسلام، وتفتش عن أسباب زائفة لتفسير هزائمنا المتكررة في هذا الصراع الممتد، هي نقطة البداية لنشوء حركة تحرر وطني جديدة، في فلسطين وفي العالم العربي.
علينا أن نطرح بوضوح السؤال المحوري، عما إذا كانت المشاريع التي تطرحها الفصائل الإسلامية المختلفة يمكن أن تكون جزءاَ من حركة التحرر الوطني الجديدة هذه؟ لا بد من طرح هذا السؤال ومناقشته وتحليل مواقف الفصائل المنتمية لما يعرف بالإسلام السياسي والتي تتصدر المشهد في الوقت الراهن، بعد الهجوم الذي شنته حماس وفصائل المقاومة الأخرى في السابع من أكتوبر عام 2023. كمقدمة لهذا النقاش الموسع الذي أدعو إليه، أطرح ثلاثة أسئلة يتعين التفكير فيها وتقديم إجابات صادقة لها.
السؤال الأول، يتعلق بالخلفيات الأيديولوجية التي تنطلق منها هذه التيارات في تفسيرها للهزائم المتكررة للعرب والمسلمين في مواجهة القوى الأوروبية والغربية منذ صدمة الحداثة التي أحدثتها الحملة الفرنسية على مصر؟ بعد هزيمة عام 1967، خرج علينا بعض المفكرين الإسلاميين، مثل الجزائري مالك بن نبي، ومشاهير الشيوخ المرتبطين أيديولوجيا بفكرة الخلافة الإسلامية وبمشروع جماعة الإخوان المسلمين الذي خرجت من عباءته فصائل الإسلام السياسي على اختلاف توجهاتها بدءا بحزب التحرير الإسلامي، وانتهاء بالفصائل الشيعية المرتبطة بالمشروع الإيراني، بفكرة أن الهزيمة كانت بسبب ابتعاد المسلمين عن الدين في ظل نظم حكم وُصفت بأنها "علمانية" وتروج لنظريات إلحادية مثل الاشتراكية والقومية. وصف بن نبي هذه الهزيمة بـ "الهزيمة العربية المباركة"، وهناك من صلى شكراً لله على هذه الهزيمة التي اعتبروها بداية للصحوة الإسلامية، التي تُرجمت عملياً بغزو الفكر الوهابي السلفي لمجتمعات الثورة، مدعوما بالثروة التي هبطت على منشئه. وفي ظل هذا الترويج حُجبت تفسيرات أخرى للهزائم بدءا من نكبة 1948، تُشير إلى أن إسرائيل انتصرت لأنها أخذت بشروط الحداثة سواء في تنظيم الدولة على أساس ديمقراطي، أو الاهتمام بالعلم، وهي الفكرة التي طرحها المفكر الفلسطيني قسطنطين زريق في كتابه "معنى النكبة" الذي صدر بعد حرب 1948 وكتابه الآخر "معنى النكبة مجدداً"، الذي صدر بعد 20 عاماً، في أعقاب هزيمة 1967، والأستاذ أحمد بهاء الدين في مقالاته في جريدة الأهرام وصحف أخرى وفي كتبه. يخفي هذا السؤال سؤالاً أخر حول طبيعة صراعنا مع إسرائيل، والذي يوصف بأنه صراع حضاري، ولكن يجب أن نعرف ما الذي يعنيه الصراع الحضاري، وهل هو صراع ديني يأتي في إطار ما يراه البعض، خصوصاً المنتمين لتيار الإسلام السياسي، صراعاً تاريخياً ممتداً بين المسلمين والغرب؟
من الملاحظ أن نتنياهو أشار في أكثر في مناسبة إلى مفهوم الصراع الحضاري ووضع حربه على غزة في سياق الدفاع عن الحضارة الغربية لتبرير الجرائم الوحشية التي يرتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وقال مراراً في مخاطبة الدول والمجتمعات الغربية إن إسرائيل تخوض حرباً مصيرية ووجودية ضد البربرية والهمجية التي تمثلها حركة حماس للدفاع عن الحضارة الغربية، وأنه يخوض هذه المعركة نيابة عن الغرب للدفاع عن حضارته التي لا تهددها حماس وحدها، وإنما يهددها أيضاً مشروع التحرر الوطني الفلسطيني بكل مكوناته، بما في ذلك السلطة الفلسطينية التي تتزعمها حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس، المتهم من فصائل المقاومة الفلسطينية وأنصارها بالخيانة بسبب مواقفه. في الحقيقة، أن هناك أصواتاً وشخصيات داخل حركة فتح، تتحمل المسؤولية عن هذا الوضع، عندما تعاملت بانتهازية مع فكرة "أسلمة" الصراع، خصوصاً بعد سيطرة رجال الدين على الحكم في إيران في أعقاب ثورة 1979، وتنكرت هذه الأصوات للطابع الإنساني والأممي لحركات التحرر الوطني، الذي ميز العمل السياسي لحركة فتح على مدى سنوات، استفادت خلالها من الخبرات الثورية وخبرات حركات التحرر الوطني في العالم. وانتصرت هذه الأصوات بشكل حاسم مع انتفاضة "الأقصى" في عام 2000، التي شهدت بدايات للعمل المسلح ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي الفلسطينية.
السؤال الثاني، يتعلق بموقف تلك الفصائل من المسألة الوطنية، وما إذا كان نضالهم من أجل تحرير الوطن أم مدفوع بغايات أخرى؟ يرتبط بهذا السؤال سؤال آخر يتعلق بتحليل رؤية هذه الفصائل لطبيعة التناقض الرئيسي في الصراع؟ وهو سؤال أصبح مطروحا بإلحاح بعد تمكن تحالف لهذه الفصائل من السيطرة على السلطة في سوريا بعد هروب بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، ويرتبط بهذا السؤال أيضاً سؤال حول ترتيب الأولويات بالنسبة لهذه الفصائل وما إذا كانت رؤيتها لبناء الدولة الوطنية تقدم جديداً فيما يخص علاقة الدولة بالمجتمع وعلاقة الحاكم بالمحكومين، أما أنها ستعيد انتاج الاستبداد ولكن بمسميات وصيغ أخرى، وهل ستكرر تجربة فصائل إسلامية أخرى في إساءة استغلال الانتخابات، بعد أن اختزلت مفهوم الديمقراطية في التصويت ومبدأ استبداد الأغلبية، والعصف بالأقليات السياسية والاجتماعية وحقوقها، ومصادرة الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الفكر والإبداع على أساس مخالفتها لتصوراتها لما يعد سياسة شرعية، أوتفسيراتها ورؤيتها للدين. أن تجربة حماس والفصائل والأحزاب السياسية في سوريا، وإلى حد ما في العراق، تقدم لنا خبرة قد تكون مغايرة لموقف الإسلاميين من المسألة الوطنية، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخبرة تعبر عن تحول جذري في هذا الصدد.
قد يطرح نموذج الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان وموقف إيران، إشكالية ترتيب الأولويات التي تعبر عن رؤيتهم للتناقض الرئيسي، لكن من الصعب معرفة حقيقة موقف الفصيلين في ضوء ارتباطهما القوى بالنموذج الشيعي الإيراني ونظرته للصراع مع إسرائيل المرتبطة بأفكار الشيعة الإمامية المتعلقة بالتضامن مع المظلومين والمضطهدين في العالم، والذي قد يحظى بأولوية تعلو، أحياناً، الأولويات الوطنية. لكن من المهم ملاحظة أن ثمة موازنة جديدة نشأت في فكر حزب الله بعد حرب عام 2006 بين التزاماته كأحد مكونات الصيغة الوطنية اللبنانية ومسؤولياته تجاه اللبنانيين من ناحية، وبين أولويات مناصرة الفلسطينيين في معركتهم وارتباطه بمحور المقاومة الذي تدعمه إيران، من ناحية أخرى. والسؤال الملح الآن، كيف سيتأثر موقف الجماعات والتنظيمات الشيعية المرتبطة بهذا المحور بالتحولات في الموقف الإيراني التي قد تفرضها إعادة ترتيب لأولويات الجمهورية الإسلامية في ضوء المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة وفي ضوء خسارتها حليفا أساسياً برحيل الأسد من سوريا.
السؤال الثالث يتعلق بموقف هذه الفصائل من شعوبها، والتي من المفترض أن تكون الحاضنة الاجتماعية والشعبية لهذه الفصائل والمصدر الرئيسي للقدرات البشرية التي تعد أساساً لبناء المقاتلين المجهزين لخوض المعارك والحروب، ويرتبط أيضاً برؤيتها للغاية النهائية للصراع أو الحرب وموقفها من الأعداء والخصوم، الأمر الذي يرتبط، بدوره، بموقفها من مسألة الحريات العامة والحريات الفردية. الإجابة هذا السؤال هي التي تحدد ما إذا كانت هذه الفصائل جزءاً من حركة التحرر الوطني أم لا؟ ويطرح هذا السؤال إشكالية كبرى في ضوء علاقة حماس السلطة بالمواطنين الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة ونظرتها إليهم، ويرتبط أيضا بموقف الحركة من مسألة المصالحة الوطنية الفلسطينية وتصوراتها لكيفية إدارة الصراع مع إسرائيل في ظل المتغيرات التي ترتبت على هجوم السابع من أكتوبر.
وبينما شرعت إسرائيل في فتح تحقيق يحدد المسؤوليات الداخلية في الهجوم، الذي تعتبره الأخطر في تاريخ الحروب مع الفلسطينيين والعرب، قد يمتد إلى مراجعة كيفية إدارة الحرب في غزة وما ترتب على هذه الحرب من مكاسب أو خسائر، لا توجد أي مؤشرات، إلى الآن، على استعداد حماس لإجراء مراجعة نقدية، ولو من باب استخلاص الدروس والعبر لتجنب تكرار أي أخطاء في مواجهات مستقبلية. وبينما اختلفت أسلوب إدارة إسرائيل للحرب في ضوء ما أحدثته من تأثيرات، وغيرت أسلوبها وسعت إلى تحقيق ما يمكن تحقيقه من نتائج على مختلف الجبهات، والتي تحكم موقفها من إنهاء الحرب، لم يظهر الأداء السياسي لحماس أي تغير، سواء في أسلوب إدارتها للحرب، رغم ما طرأ على استعدادها وجاهزيتها من تطور هائل، لتتراجع بسرعة عن فكرة الحرب الهجومية إلى الحرب الدفاعية متحصنة في الأنفاق التي بنتها تحت الأرض في القطاع وعلى الحدود، كما لم تتغير تصوراتها لكيفية إنهاء الحرب، والتي تعكس شكلت تكراراً لما حدث بعد انتهاء المواجهات العسكرية السابقة مع إسرائيل.
الاستعداد للأسوأ
من المستبعد أن تعود الأوضاع في غزة إلى ما كانت عليه قبل هجوم السابع من أكتوبر، وأن يتم إنهاء الحرب الحالية من خلال إبرام وقف لإطلاق النار يمنح حماس والفصائل المسلحة الأخرى الفرصة لتعويض خسائرها العسكرية وإعادة إعمار ما تهدم من بنية تحتية مدنية في غزة خلال هذه الحرب التي تجاوزت كل تصورات حماس وفصائل المقاومة الأخرى، وانتهكت كل قواعد الاشتباك التي تقرها المواثيق والعهود الدولية. وفيما استفادت حكومة نتنياهو في ظل بيئة دولية ضاغطة، من الدعم الأمريكي اللامحدود الذي قدمته إدارة جو بايدن الديمقراطية على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي، والذي كشف عمق التحالف الأمريكي الإسرائيلي في مواجهة الخصوم والحلفاء معاً، فإن التحولات في واشنطن والتي جاءت بترامب إلى السلطة من جديد، توفر لإسرائيل هوامش غير مسبوقة للمناورة وتحقيق ما فشلت في تحقيقه بالوسائل العسكرية.
اللافت في التحركات الإسرائيلية بعد زوال تأثير النشوة التي أحدثتها وعود ترامب غير المتوقعة أن تتحرك وفق حسابات أكثر دقة من حسابات المغامر الجالس في البيت الأبيض والذي تصور أن في مقدوره أن يشارك إسرائيل في احتلال فلسطين أو أجزاء منها، أو أن يقبل حكام إسرائيل الجدد الذين أظهروا استعدادا لمواجهة الولايات المتحدة في حالة اختلاف رؤية حكامها مع الأهداف التي يتطلعون إلى تحقيقها، وهو أمر لا يمكن فهمه إلا من خلال تحليل العلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. فعلى الرغم من أن حماية أمن إسرائيل يشكل مبدأ أساسياً في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، إلا أنه كثيراً ما تنشأ خلافات بين القيادتين بخصوص تقدير ما يعد في صالح إسرائيل وأمنها أو في تقدير الأهداف التي يمكن لإسرائيل أن تحققها بما لا يلحق ضرراً بالمصالح الأمريكية في المنطقة وفي العالم. وهناك حوادث كثيرة ذات دلالة فيما يخص هامش الاستقلالية النسبي عن السياسات الأمريكية الذي تحرص إسرائيل على الحفاظ عليه. الأمر الذي يعني أن التوافق العام لا يصل إلى حد تطابق الرؤى والتوجهات، لاسيما في ظل التناقضات الداخلية والديناميات التي تغير بشكل مستمر من البيئة السياسية وعلى نحو قد ينتج صداماً بين واشنطن وتل أبيب.
تدرك إسرائيل جيداً أن الالتزام الأمريكي الذي يضمن لها تفوقاً عسكرياً على أي تحالف عسكري مضاد في المنطقة، ومايقدمه لها ذلك التعاون من تدريب وتجهيز للتعامل مع الأشكال المختلفة للمعارك والحروب سواء ضد جيوش نظامية أو ضد جماعات مسلحة تخوض أشكالاً مختلفة من حروب العصابات أو تشن هجمات إرهابية، لا يمكن أن يصل إلى حد يضمن لها التفوق المطلق أو يحقق لها النصر المطلق، ودائماً ما يكون الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل مصحوبا بشروط بحددها سقف الأهداف التي قد تسمح بها الولايات المتحدة التي لديها مصلحة أكيدة في استمرار هذا الصراع من أجل إدارته بما يحقق مصالحها ويتماشى مع رؤى من يحكمونها. تدرك إسرائيل أيضا أنها تتحرك في بيئة دولية معقدة وأن عليها أن تستفيد من التناقضات فيما بين القوى الكبرى وتحرص على إبقاء خطوط التواصل السياسي والدبلوماسي والتعاون الأمني والعسكري مفتوحة مع الجميع في ظل سياساتها الرامية للحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة والتحالف الغربي.
للأسف، لا يوجد في الاستراتيجيات العربية كافة ما يشير إلى امتلاك رؤية لإدارة هذا الصراع المعقدة بما لا يؤثر سلباً على المصالح الوطنية للدول العربية في مواجهة المشاريع الدولية والإقليمية، وغالباً ما تأتي السياسات العربية كردود فعل واستجابات لما يطرحه الآخرون. هذا العيب، الذي بات جلياً في ردود الفعل المختلفة على ما يطرحه ترامب، لا يقتصر على النخب الحاكمة وحدها، وإنما تتشارك فيه النخب الثقافية والفكرية الأوسع والتي لديها تأثير كبير على الرؤى العامة للجماهير. هناك أسباب كثيرة لهذا الوضع تستدعي مقالاً آخر لمناقشتها، كي نتمكن من وضع سياسات للتعامل مع السياسات الإسرائيلية والأمريكية التي تسعى لتنفيذ هذه الوعود وتحويلها إلى أمر واقع.
----------------------------
بقلم: أشرف راضي