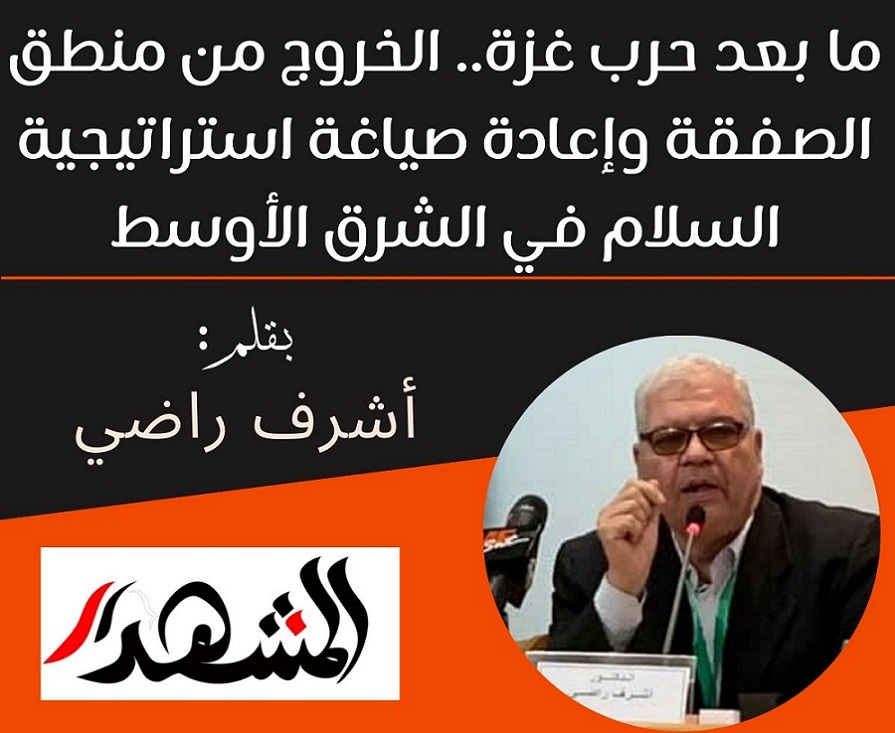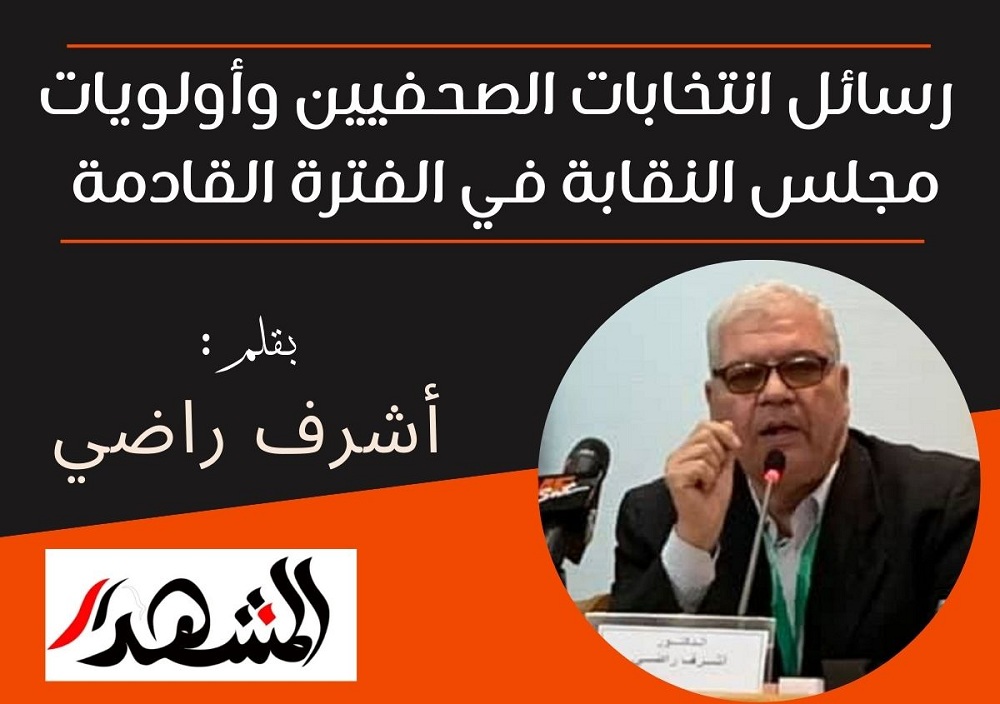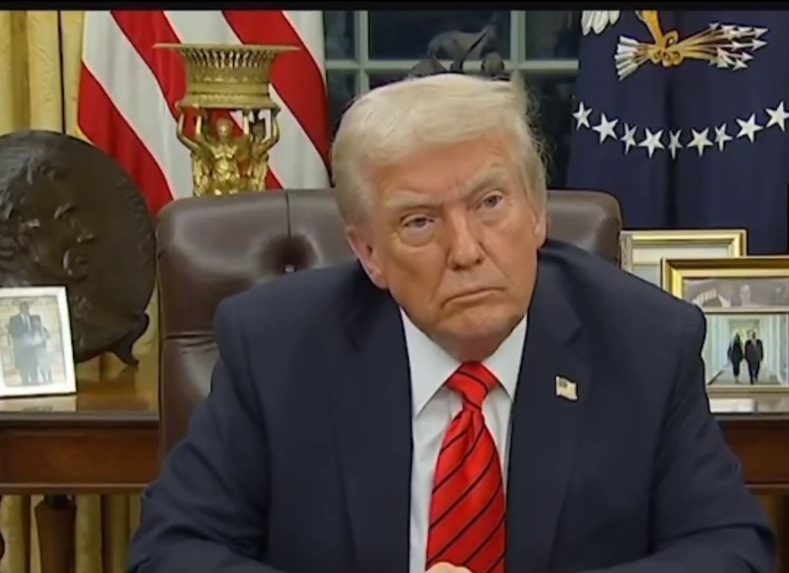"السلام" من الكلمات التي من المتوقع أن تستفز مشاعر الجمهور الواسع في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً ما إذا اقترنت هذه الكلمة بإسرائيل، أو اقترنت بالفلسطينيين إذا نظرنا إلى الأمر بعين العدو. وكثيراً ما لحق بهذه الكلمة وصف مايشير إلى تعذر تحقيقه، فهو إما سلام مستحيل أو مفقود أو ضائع أو وهمي أو زائف أو مفتت أو مراوغ، وفي كل الحالات، هو أبعد ما يكون عن "السلام العادل".
ولا يمكن لعاقل أن يتصور أن تكون هناك أي مساحة، في الوقت الراهن على الأقل، للحديث عن أي مستقبل للسلام في المنطقة، بعد كل هذه المشاهد المروعة للقتل والتدميرالتي يتعرض لها الفلسطينيون والتي نراها عبر الشاشات، أو في ظل مخططات التهجير التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة وفي القدس، ومع تصاعد السياسات الإسرائيلية العنصرية للتعامل مع فلسطيني الداخل المعروفين بعرب 1948، أو الوسط العربي في إسرائيل، مع صعود اليمين المتطرف وهيمنته على الساحة السياسية الإسرائيلية في ظل التدهور الشديد لأحزاب اليسار، والتي تترجم في عمليات للتهجير المستمر للفلسطينيين من المدن المختلطة نتيجة لسياسات اقتصادية واجتماعية تستهدفهم ومحاصرة كل أشكال التعايش اليهودي العربي المشترك في الداخل، وهي سياسات تنقل إسرائيل لتصبح دولة قائمة على الفصل العنصري بامتياز.
وتعثرت جهود السلام منذ فشل مفاوضات الحل النهائي في كامب ديفيد عام 2000، وما أعقبها من تطورات على الساحتين الإسرائيلية والفلسطينية والتي تعزز الادعاء بأنه لا يوجد شريك للسلام على الجانبين، وهو أمر مؤكد في ظل الغياب اللافت لما كان يعرف بمعسكر السلام في إسرائيل، وأمر وارد في المشهد الفلسطيني الراهن في ظل الاستقطاب الشديد بين معسكر المقاومة المسلحة وبين من يتبنون نهج التسوية السياسية وممارسة الضغوط بوسائل سلمية، وهو النهج الذي فقد مصداقيته في أعين قطاعات واسعة من الجمهور الفلسطيني والجمهور العربي، وأيضا لدى الوسطاء الدوليين والإقليميين، في ظل التشدد الملحوظ للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 2000، والتي تهيمن عليها الأحزاب اليمينية التي تتأرجح بين حكومات يسيطر عليها يمين الوسط، وأخرى خاضعة لهيمنة الأحزاب اليمينية المتطرفة، مثل الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، زعيم الليكود، الذي يفعل كل ما يمكن، بما في ذلك مواصلة الحرب في غزة والرضوخ لابتزاز المستوطنين في الضفة الغربية، من أجل الحفاظ علي تماسك حكومته مدفوعاً بالخوف على مستقبله السياسي، إذا ما نجحت الضغوط المتزايدة، خارجياً وداخلياً، في الدفع باتجاه انتخابات عامة مبكرة غير مضمونة النتائج والعواقب.
على الرغم من استمرار القتال في غزة وسعي حكومة نتنياهو لفتح جبهات أخرى للقتال في لبنان وعدوانها المستمر على أهداف عسكرية واستراتيجية في سوريا تزعم أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، واستمرار عدوانها على جنوب لبنان على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله، أنهى هجمات الحزب الصاروخية وبمسيرات على شمال إسرائيل، والتي كانت تستهدف تخفيف الضغط العسكري الإسرائيلي على غزة، وعلى الرغم من فشل جهود الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية في التوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحماس لتبادل الأسرى، تمهد الطريق لهدنة، ولو مؤقتة، في القطاع الذي يعاني النازحون فيه من المجاعة والذي يواجه أزمة إنسانية بسبب الحرب والحصار الذي تفرضه إسرائيل بالقوة المسلحة على دخول المساعدات الإنسانية وعدوانها على قوافل الإغاثة الإنسانية وعلى وكالات الأمم المتحدة العاملة في القطاع، وما يثيره ذلك من غضب عالمي نتيجة لإحساس بعجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان الإسرائيلي، وكان الرهان معقودا على حراك الداخل الإسرائيلي وتكثيف الجهود لإسقاط حكومة نتنياهو باعتبار أن ذلك شرطا ضروريا لوقف هذه الجولة من الحرب الممتدة، أو على وفاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بوعده بإنهاء الحرب في غزة، وهو أمر مستبعد إذا لم تتم الاستجابة لبعض الشروط التي تضعها حماس.
المفاوضات الراهنة ومستقبل عملية السلام
على ما يبدو، سيكون لأي صيغة للتسوية في غزة أثار بعيدة المدى على مستقبل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وهو ما يدركه الطرفان جيداً. وعلى الرغم من أن الموقف الإقليمي وأيضاً التحولات المرتقبة في السياسة الأمريكية بعد فوز ترامب وعودته الوشيكة إلى البيت الأبيض، يجعل ميزان القوة يميل لصالح إسرائيل، إلا أن الأطراف المعنية تدرك على ما يبدو أن أي تسوية لا تعطي للفلسطينيين، بشكل عام، ولفصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس، شيئاً هي تسوية محكوم عليها بالفشل، وعليه يتزايد الإدراك بضرورة التفكير في المستقبل بعد هذه الجولة من المواجهات العسكرية المدمرة والمكلفة لكل الأطراف المعنية.
ويمكن ملاحظة مدى الترابط بين ما يتم طرحه من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة الآن، وبين مستقبل التسوية وعملية السلام في المنطقة. وتعمل هذه النقطة في صالح الطرف الفلسطيني، وتعمل في صالحه أيضاً التحولات الجارية على الساحة الدولية والتي تشير إلى تنامي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات المرتبطة بجرائم الحرب، على النحو الذي يشير إليه قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي بسحب جزء من استثماراته التي تستغل في دعم النشاط الاستيطاني في الأرض المحتلة، والتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية يوم الخميس والذي يتهم إسرائيل بارتكاب أفعال "تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدّد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة".
أحد الإشكاليات الكبرى التي تكشف عنها جهود الوساطة الحالية للتوصل إلى هدنة في غزة، خصوصاً بعد التوصل إلى اتفاق على الجبهة اللبنانية، هي ضمان عدم تكرار ذلك النوع من الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023، والتي يمكن لأي فصيل من الفصائل الفلسطينية أو فصائل المقاومة الأخرى شنها ضد إسرائيل. ترى الحكومة الإسرائيلية الحالية أن الأمر الذي يضمن تحقيق ذلك هو مواصلة الحرب حتى القضاء على حركة حماس والقدرات العسكرية للحركة ولفصائل المقاومة الأخرى، وهو هدف يصعب تحقيقه، على ما يبدو، على الرغم من مستوى التدمير الذي استهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في القطاع. ومن وجهة نظر واقعية، لا يمكن لأي دولة الوصول إلى وضع الأمن المطلق، كل ما يمكن تحقيقه هو مستويات من الأمن النسبي تضمنه سياسات الدولة وسلوكها الخارجي والداخلي، هذا هو الوضع في ظل حقائق العلاقات الدولية. وعليه، فإن إسرائيل في حاجة لمراجعة سياساتها تجاه قطاع غزة وتجاه الضفة الغربية وفي حاجة للتفكير في استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين، وهما من الأمور المستبعدة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية إلا بقدر هائل من الضغوط الأمريكية. وعليه فإن السؤال المطروح الآن، هل ستغتنم الإدارة الأمريكية الجديدة الفرصة السانحة من أجل الخروج من منطق الصفقة الذي يفرز حلولا مؤقتة وجزئية وتصوغ استراتيجية للسلام في المنطقة؟ وهل يمكن صياغة هذه الاستراتيجية دون تصور ما للتعامل مع قضايا الحل النهائي على نحو يحقق مكاسب للفلسطينيين تضمن علاقات مستقرة نسبياً في المستقبل المنظور؟ وكيف يمكن التعامل مع مسألة الحقوق التاريخية؟
الحل الدائم ومسألة الحقوق التاريخية
تجدر الإشارة هنا إلى المتغيرات التي جرت في السنوات الأربع الماضية والتي يتعين على الإدارة الأمريكية القادمة أن تأخذها بعين الاعتبار، وأن تتحلى بقدر من الموضوعية والواقعية يمكنها من إدراك الحقائق في سعيها لتغيير الوضع الراهن كي لا تقدم على أي خطوات قد تكون لها نتائج كارثية في المستقبل. من المؤكد، أن التصور الذي خلصت إليه إدارة ترامب الأولى للحل على أسس جديدة لا تلتزم بالسياسات التي التزمت بها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، فيما يخص الموقف من القدس والمستوطنات وحل الدولتين، لم يعد صالحاً، ويدرك فريق ترامب هذا الواقع، على ما يبدو، إذ استبعد من إدارته القادمة وجوهاً ارتبط اسمها بما كان يعرف، في حينه، بصفقة القرن أو مشروع الدولة الجديدة، الذي يقترح إقامة وطن بديل للفلسطينيين في شمال سيناء أو في الأردن، أو التفكير في حلول أخرى للصراع بعيداً عن فكرة حل الدولتين، لكن ذلك لا يعني التزامه بالموقف الأمريكي الأكثر توازناً في عهد إدارة الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، والذي تبلور في مفاوضات كامب ديفيد الثانية في خريف عام 2000 بين الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود باراك، الذي كان يقود حكومة ائتلافية بزعامة حزب العمل، فقد تغير الموقف الأمريكي في عهد إدارة ترامب الأولى، من مسألة القدس، كما تغير الموقف من المستوطنات التي أقيمت في الضفة الغربية المحتلة في عهد إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض، من خلال تعهد مكتوب قدمته إدارته لتشجيع الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في عملية السلام، يضمن احتفاظ إسرائيل بكتلة المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقدس الشرقية، في أي اتفاق نهائي مع الفلسطينيين.
بالتأكيد، أن التغير المأمول في سياسات ترامب لا تعني أنه سيكون أكثر ميلاً من الإدارات الأخرى لدعم الحقوق المشروعة وغير القابلة للتنازل للشعب الفلسطيني والتي أقرتها الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، لكن ذلك يعني أنه قد يعيد النظر في أي حلول قد تكون مجحفة بشكل فج للحقوق الفلسطينية، على الرغم من نجاح إدارته في فصل مسألة تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين دول عربية عن صيغة "الأرض مقابل السلام" التي كانت عنواناً لأي عملية للسلام لعقود تالية على حرب يونيو عام 1967، والتي أكدتها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة منذ قرار 242، الصادر بعد حرب 1967 مباشرة.
لقد أثار نجاح ترامب في الشهور الأخيرة لولايته الأولى في إبرام اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب، والمفاوضات من أجل إبرام اتفاقيات مماثلة مع السعودية والسودان، مخاوف بشأن مستقبل القضية الفلسطينية، جراء تبني صيغة "السلام مقابل السلام" التي لم ترهن تطور العلاقات الإسرائيلية العربية ودمج إسرائيل كلاعب استراتيجي رئيسي في المنطقة بحل القضية الفلسطينية، والترويج لحلول للمشكلة الفلسطينية لا تستند إلى حقوقهم التاريخية كشعب في أرض فلسطين بحدودها المعروفة منذ الانتداب البريطاني، ولا تدعم بالضرورة حقهم في إقامة دولة مستقلة لهم، وهو الحل الذي لا تقبل به أي من القوى السياسية الرئيسية في إسرائيل في الوقت الحالي.
لقد أقدمت حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى على مغامرة كبيرة في السابع من أكتوبر العام الماضي عندما شنت هجوماً على مستوطنات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة واحتجزت مئات الرهائن الإسرائيليين من أجل مبادلتهم بفلسطينيين تحتجزهم إسرائيل في سجونها، وعلى الرغم من الثمن الفادح الذي دفعه المدنيون الفلسطينيون في غزة جراء هذا الهجوم، إلا أنه أعاد قضيتهم إلى مكانها على رأس جدول الأعمال الدولي. وعلى الرغم من أن الهجوم أتاح لحكومة نتنياهو فرصة لإعادة بناء تحالف سياسي داخلي وخارجي في مواجهة حماس التي جرى تصنيفها كواحدة من المنظمات الإرهابية التي يتجاوز تهديدها إسرائيل ليمتد إلى المجتمع الدولي، إلا أنه كشف أيضاً عن انقسامات أعمق داخل إسرائيل التي تزايدت حول عدد من المحاور وثيقة الصلة بمصالح المجتمع اليهودي في إسرائيل، وبأولويات داخلية، في ظل تزايد اقتناع قطاعات أكبر من الجمهور الإسرائيلي بعدم جدوى التوصل لاتفاقيات سلام مع الفلسطينيين، إذ رأت هذه القطاعات، من خلال تصوير ما جرى في قطاع غزة، أن أي كيان فلسطيني سينشأ نتيجة لهذه الاتفاقيات، سيكون نقطة انطلاق لتصعيد آخر حتى يحقق الفلسطينيين حلمهم التاريخي في إقامة دولة على كامل أرض فلسطين الممتدة من النهر إلى البحر والقضاء على دولة إسرائيل وإقامة كيان فلسطيني إسلامي أو عربي مكانها، وأن هذا الكيان سيكون أداة في يد النظام الإيراني الذي أعلن زعماؤه أن هدفهم النهائي هو القضاء على دولة إسرائيل. وفي ظل هذا التصور، تتعمق أزمة الثقة بين الطرفين الإسرائيليوالفلسطيني، على نحو يعقد المفاوضات الراهنة من أجل التوصل هدنة تنهي حمام الدم في غزة.
غزة والموقف الإسرائيلي من حق العودة
من المرجح أن نتنياهو سيكون مجبراً في نهاية الأمر على حسم موقفه، وعليه أن يختار بين الحفاظ على حكومته والإذعان للمتطرفين الرافضين لوقف الحرب في غزة، والذي يسعون إلى تصعيد المواجهة في الضفة الغربية والترويج لفكرة الحل الأردني وإلى تخريب التعايش القائم منذ عقود بين الوسط العربي الفلسطيني وبين اليهود في الداخل، وأن ينجر خلف اليمين المتطرف ليجعل التهجير واقعاً مستديما في غزة أو يقبل تسوية تمكن أهالي شمال غزة الفلسطينيين من ممارسة "حق العودة" إلى الخرائب التي تبقت من بيوتهم. هذه التسوية قد توفر سابقة لتغير الموقف الإسرائيلي القائم منذ إعلان الدولة في عام 1948، والخاص بمشكلة اللاجئين، إذ أن تمكين النازحين الفلسطينيين في غزة، من حقهم في العودة إلى الجزء الشمالي من القطاع، وهي نقطة تأتي في لب المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، يتعارض، على ما يبدو، مع السياسة الإسرائيلية المتوافق عليها بخصوص التعامل مع مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من الحروب السابقة، والتي تعد إحدى القضايا الشائكة للتوصل إلى تسوية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وهي واحدة من ملفات قضايا الحل النهائي التي حددتها اتفاقية أوسلو.
تقليديا، ترفض إسرائيل، من حيث المبدأ، فكرة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ويرى بعض الأطراف في الحكومة الحالية أن قبولها بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى المناطق التي نزحوا منها أثناء الحرب في غزة، يعني تحولا كبيرا في السياسة الإسرائيلية المستقرة في هذا الصدد، وسيكون لهذا القبول آثار بعيدة المدى على طرفي الصراع الرئيسيين، إسرائيل والفلسطينيين وعلى مستقبل وشكل العلاقات فيما بينهما. لقد نشأت النكبة الفلسطينية في 1948 حين قررت إسرائيل، بزعامة دافيد بن جوريون، أحد زعماء جيل المؤسسين وأول رئيس لوزراء إسرائيل، منع عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هربوا من الحرب أو جرى تهجيرهم قسراً من مدنهم وقراهم إبان المعارك، والعمل على إبقاء اللاجئين الفلسطينيين خارج حدود البلاد، وأتاح الوضع الذي لا يزال هذا الأمر ساري المفعول حتى اليوم، إقامة دولة إسرائيل ضمن حدود معترف بها بموجب اتفاقيات الهدنة لعام 1949، الموقعة بين إسرائيل وبين حكومات الدول العربية التي شاركت جيوشها في حرب 1948.
أقام جزء كبير من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من المناطق التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية في حرب 1948، في مخيمات أقيمت في الضفة الغربية وقطاع غزة الخاضعتين لإدارة أردنية أو مصرية بموجب اتفاقيات الهدنة، إلى أن احتلتهما إسرائيل مع سيناء ومرتفعات الجولان في حرب عام 1967. ومن الملاحظ من خلال تحليل العمليات العسكرية الإسرائيلية في حربها الراهنة في غزة وفي الضفة الغربية، أن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تأني في مقدمة بنك الأهداف الإسرائيلي لأسباب عملية ولوجستية. ذلك أن بقاء تلك المخيمات دليل حي على وجود لاجئين فلسطينيين لهم حق قانوني وأخلاقي في العودة إلى المناطق التي هُجروا منها، كما أن بقاء هذه المخيمات يعني أن الأمم المتحدة طرف، لوجود وكالات تابعة لهم تنخرط في عمليات للإغاثة ولإدارة تلك المخيمات الأمر الذي يضفي على الوضع الدولي للقضية الفلسطينية. كذلك، فإن المخيمات وبسبب طبيعة أبنيتها وكذلك نظراً لتركيبتها الاجتماعية حاضنة أساسية للمقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وآلية أساسية للحفاظ على التاريخ الفلسطيني في مواجهة العمليات الممنهجة إعادة كتابته من قبل إسرائيل في سياق سياساتها لفرض واقع جديد على المنطقة.
قد يكون الطرف الفلسطيني هو الطرف الأضعف في معادلات القوة في المنطقة من حيث موارده الاقتصادية وقدراته العسكرية، لكن من المؤكد أنه الطرف الأقوى من وجهة نظر معادلة القوة الشاملة، لاستناده إلى مبررات أخلاقية وقانونية تدعم حق الشعوب الخاضعة للاحتلال في المقاومة المشروعة لهذا الاحتلال بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك الوسائل العسكرية، وبسبب الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي التي تبطل أي إجراءات قد تقدم عليها إسرائيل لفرض تغييرات في الأراضي المحتلة، والفلسطينيون أيضا طرف قوي لامتلاكهم إرادة للقتال من أجل تحرير أرضهم وقرارهم. وغياب عملية للسلام قد يتيح إسرائيل إجراء بعض التعديلات هنا أو هناك وفرض واقع جديد على الأرض، لكن هذا الواقع الجديد سيظل غير شرعي وطارئ، ما لم يجر تثبيته باتفاق، هذه الحقيقة قد تكون نقطة انطلاق أساسية للتفكير في إعادة صياغة عملية للسلام تتعامل مع الملفات الأصيلة والشائكة في الصراع وتحاول علاج ما ترتب على الحرب الأخيرة من أضرار قد تفتح الطريق لحرب أبدية لا يتصور لها نهاية إلا بتمكن أحد الطرفين من القضاء على الطرف الآخر بشكل كامل.
قد يتصور البعض أن هناك فرصة سانحة لفرض الحل الإسرائيلي المتمثل في ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال فرض القانون الإسرائيلي، بشكل كامل أو جزئي، لكن خطوة الضم هذه كي تفتح الطريق لحل للمشكلة الفلسطينية على غرار حل المشكلة استناداً إلى تجربة استيعاب الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل بمنح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية وحقوق المواطنة، قد يمثل تهديداً لفكرة يهودية الدولة، خصوصاُ أن قطاعات واسعة من الوسط العربي في إسرائيل، بما في ذلك الدروز الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي ويسري عليهم قانون التجنيد الإجباري، ترفض قانون يهودية الدولة وهو قانون أساسي أقره الكنيست إسرائيليفي 19 يوليو 2018، بأغلبية 62 ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت، يُعرِّف إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، ويتعارض هذا القانون بشكل صارخ مع فكرة الدولة الديمقراطية المؤسسة على مبدأ المواطنة، وسيضع إسرائيل في المستقبل غير البعيد، في مواجهة اختيار مصيري آخر بين أن تصبح دولة ديمقراطية يتمتع مواطنوها بحقوق متساوية أمام القانون أو تصبح دولة للفصل العنصري، لتمضي في الطريق ذاته الذي انتهى بالقضاء على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
-----------------------------------
بقلم: أشرف راضي