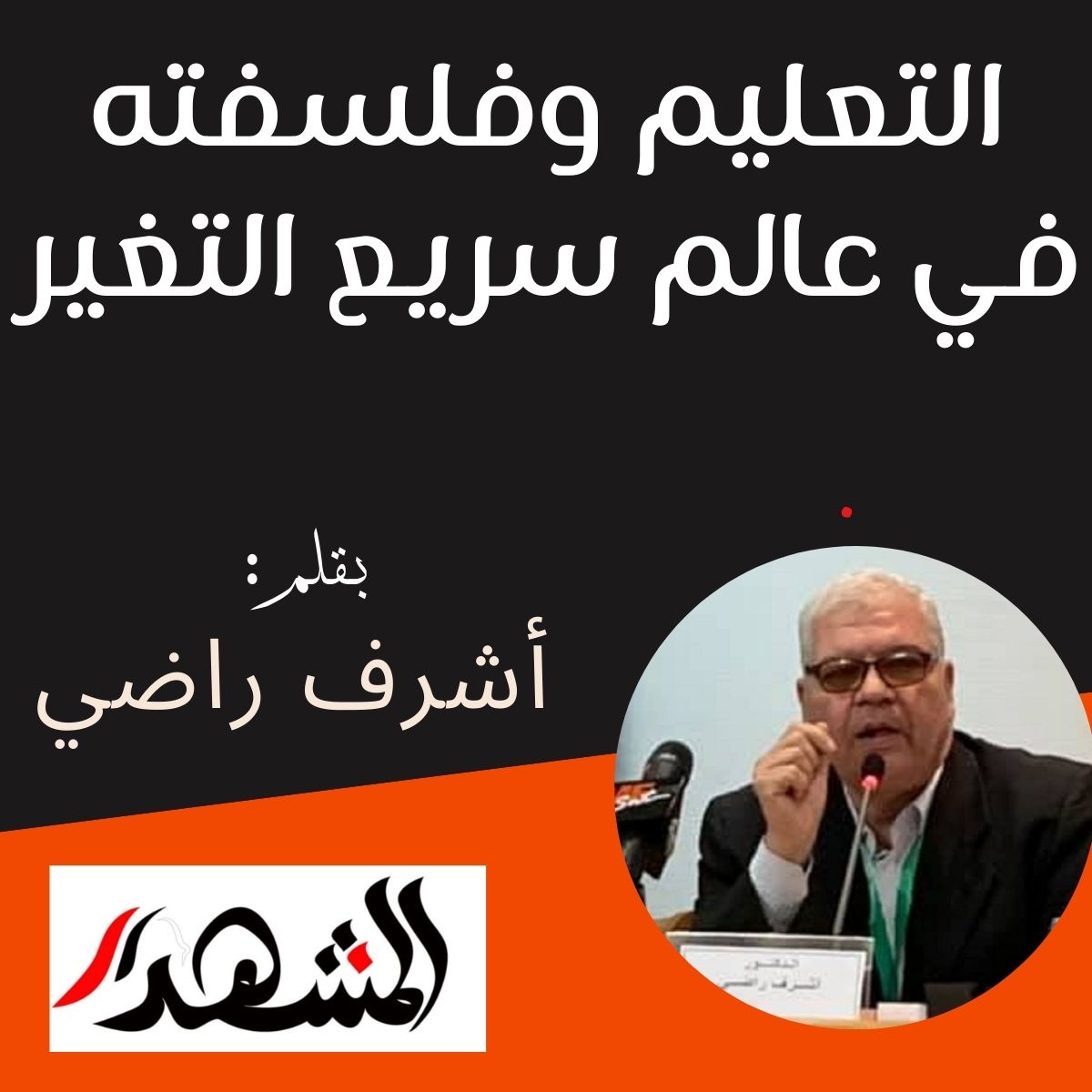أثارت التصريحات المتلاحقة لوزير التربية التعليم والتعليم الفني، عاصفة من الجدل في وسائل الإعلام المختلفة، وأطلقت سيلاً من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما استفزت تصريحات الوزير، وأيضا تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي حول جدوى بعض الكليات وما تقدمه من معارف للطلاب، المثقفين والخبراء، فعقدوا ندوات تفتح النقاش العام حول وضع التعليم العام والتعليم الجامعي في مصر، وطُرحت تساؤلات عديدة بشأن التغييرات التي يجري إدخالها على المقررات الدراسية وعما إذا كانت تمثل حلولاً عملية لأزمة التعليم في مصر، لا سيما أن العقود القليلة الماضية شهدت سلسلة من التغييرات في السياسات التعليمية للدولة، عكست حالة من التخبط أكثر مما ساعدت على التعامل مع أحد الملفات الأساسية المتعلقة بمستقبل مصر. ولم تكشف تصريحات الوزير الجديد التي جاءت في أعقاب اجتماع مع الرئيس، بحضور الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية يوم السبت 27 يوليو، ما يشير إلى ملامح سياسة عامة تخرجنا من حالة التخبط هذه، رغم تطرق الاجتماع إلى جوانب جوهرية في أزمة التعليم.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنه وضعت في هذا الاجتماع الملامح الأساسية لخطة الوزارة والدولة للتعامل مع ملف التعليم، وأن حضور الرئيس الاجتماع إشارة إلى أن التعليم سيحظى بأولوية قصوى وبدعم مباشر من رئيس الجمهورية، أكبر مسؤول في الدولة. ويبدو من تحليل النقاط التي جرى التركيز عليها في ذلك الاجتماع أن خطة الدولة لإصلاح التعليم ستبدأ بالمعلم، وهي نقطة عليها إجماع من الخبراء الذين تحدثوا طويلا في ملف إصلاح التعليم في مصر، والذي احتدمت أزمته في العقود الثلاثة الأخيرة بتأثير عدد من المشكلات والتحديات التي فشلت محاولات حلها على الرغم من أن مشكلات التعليم وتحدياته معلومة جيداً للجميع. لكن هناك عنصر مايزال غائباً، وهو العنصر الخاص بالفلسفة الحاكمة للتعليم، والتي تساعد في تحديد كيفية استجابة السياسة التعليمية للمتغيرات السريعة والمتلاحقة في العالم، بتأثير الثورة العلمية والتكنولوجية، والتحولات العميقة الجارية في بنية الاقتصاد السياسي العالمي. وغياب مثل هذه الفلسفة سبب رئيسي لتخبط السياسة التعلمية.
التعليم والمستقبل
العلاقة بين التعليم والمستقبل واضحة في أذهان المثقفين والنخبة، منذ أن تناولها بالتفصيل الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر"، الصادر عام 1938، والذي ركز بشكل أساسي على التعليم كركيزة لمستقبل مصر بعد حصولها على الاستقلال، واهتم بدور التعليم في صياغة التوجهات العامة للنخبة المتعلمة في مصر. ولم يخرج طه حسين في كتابه عن التوجه الذي اعتمد لمشروع بناء الدولة الحديثة في مصر، منذ عهد محمد علي، إذ ربط طه حسين مصر بأوروبا، ثقافياً وفكرياً، لكنه أضاف لهذا الارتباط بعداً تاريخياً بتركيزه على علاقات مصر التاريخية بكل من اليونان وروما القديمة، التي رأى فيها ركيزة ثانية من ركائز الهوية المصرية إلى جانب مصر القديمة وحضارتها الممتدة لآلاف السنين.
كان اهتمام طه حسين بالتعليم، كمسألة مركزية، واضحاً في فصول الكتاب، وربما كان هذا الاهتمام، وامتلاك الرجل صاحب مقولة "التعليم كالماء والهواء" الشهيرة، رؤية للنهوض بالتعليم العام سبباً لاختياره وزيرا للمعارف في آخر حكومة شكلها حزب الوفد (1950-1952)، في إشارة إلى التوجه الذي كانت الحكومة التي أطاحت بها حركة ضباط الجيش في يوليو 1952، تعتزم المضي فيه، وهو توجه التزمت به الدولة المصرية في العقود اللاحقة، استند إلى إيمان النخبة بأن التعليم حق أساسي للأفراد، وأن المهمة الأساسية للدولة الحديثة هي ضمان حصول كل المواطنين على هذا الحق بغض النظر عن مستواهم المادي أو خلفيتهم الاجتماعية، فالتعليم يجب أن يكون متاحاً للجميع كالماء والهواء، وليس سلعة يشتريها القادرون ويحرم منها غير القادرين.
التعليم وهوية مصر الحضارية
ترتبط فلسفة التعليم ارتباطاً واضحاً بمسألة الهوية الحضارية للدولة، وكان ربط التعليم بمشروع للنهضة المصرية، هي النقطة الأخرى المهمة في كتاب طه حسين، الذي رأى أن هذه النهضة تنطلق من تحديد انتماء مصر للعالم المتوسطي أو الحضارة الأوروبية الحديثة، فكرياً وثقافياً، وهي رؤية كانت سائدة لدى النخبة المصرية في ذلك الوقت، تم التراجع عنها بعد يوليو 1952 لصالح الدائرتين العربية-الإسلامية والأفروآسيوية، وكان لهذا التراجع تداعياته على هوية مصر الثقافية والحضارية، فقد فتح التوجه المتوسطي للنخبة المصرية الحديثة، الباب لمؤثرات على الثقافة المصرية كانت تعد أحد نقاط القوة المصرية منذ تأسيس الدولة الحديثة، لجسر الهوة الكبيرة بينها وبين مجتمعات ارتبطت معها تاريخياً على الضفة الأخرى من المتوسط، وكان لا بد من الانفتاح مرة أخرى على هذه المجتمعات.
وكان للتراجع عن هذا التوجه المتوسطي تأثيرات بعيدة المدى ليس فقط على علاقات مصر وتوجهاتها الخارجية، وإنما أيضاً على السياسات الداخلية، نتيجة للتركيز فقط على المكون العربي الإسلامي في صياغة الشخصية المصرية، وحذف مكونات وأبعاد أخرى لعبت دورا في صياغة هذه الشخصية. على الرغم من تداخل عوامل كثيرة في تشكيل هوية المجتمعات، إلا أن مسألة الهوية غالباً ما تكون اختيارا للنخبة. لقد أفرز مشروع الدولة الحديثة في مصر، الذي تأسس على انفتاح مصر على أوروبا والاستفادة مما حققته من نهضة في العلوم وفي المعرفة، وعلى انفتاحها على شعوب المنطقة المجاورة، نخبة بلورت الفكرة المصرية الحديثة في مشروع "مصر للمصريين"، الذي جعل "المواطنة" التي لم تكن معروفة بهذا المسمى في ذلك الوقت، أساساً وركيزة للارتباط بمصر كحاضنة ووطن لمن استقر على أرضها وعمل من أجل نهضتها، وحاول التعامل مع ما يطرحه التنوع العرقي والقومي واللغوي من تحديات من أجل تعزيز فكرة المواطنة.
لم تكن لدى النخبة المصرية التي كانت تسعى من أجل استقلال مصر عن بريطانيا، تلك الحساسية التي ظهرت لدى التيار المناصر لفكرة الخلافة الإسلامية والمناهض التغريب والمعادي للحداثة، بوصفها مشروعا أوروبيا بامتياز، والتي يًعد التفكير العلمي والتعليم الحديث أحد منجزاتها.وكانت نخبة العشرينات والثلاثينات تقيس مدى تطور المجتمع المصري ورقيه بمدى اقترابه من المثال الأوروبي، لا لشيء إلا بسبب ما حققته أوروبا من نهضة، وواصلت هذه النخبة نهج السعي للاستفادة من النهضة الأوروبية على الرغم من المواجهة الثقافية والعسكرية مع دولها. وعلى هذا النهج سار طه حسين الذي اجتهد في مسألة تحديد موقع مصر ثقافيا وحضاريا، فرأى أنها دولة تنتمي إلى ذلك العالم الحديث، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دلالة، لكنها لا تنفصل في الوقت نفسه عن جذورها المتمثلة في الحضارة المصرية القديمة وتأثرها بفلسفة اليونان والقانون الروماني، ولا عن المؤثرات الثقافية، القادمة من المنطقة العربية والإسلام.
التعليم بين التنشئة واكتساب المعرفة
بينما كان طه حسين مدركاً، هو وأقطاب النخبة المصرية في ذلك الوقت، للدور الذي لعبته اللغة والدين في تعزيز إحساس المصريين بالانتماء للشرق وثقافته، إلا أنه كان واعياً كذلك بأهمية اتصال مصر بدول البحر المتوسط، وتحديداً باليونان القديمة، وانعكس ذلك الإدراك لأهمية اللغة في الاهتمام بدراسة اللغة العربية وتطويرها لكي تصبح وسيلة للتفكير مواكبة للتطورات الحديثة في المعرفة والعلم. ولم تبد النخبة الجديدة، المتأثرة بتيار مناهضة التغريب والدفاع عن الثقافة الوطنية، ذلك الاهتمام بالجانب المعرفي للتعليم وإنما ركزت على الجانب التربوي المتعلق بالتنشئة على حساب التفكير العلمي، وشرعت في إصلاح للتعليم يهتم بالتكوين المعرفي للمعلم لتمكينه من القيام بهذه المهمة التربوية، من خلال التوسع في إنشاء كليات للتربية لإعداد المعلم، وتحول مسمى الوزارة المسؤولة عن التعليم من وزارة المعارف العامة إلى وزارة التربية والتعليم، وهي المسؤولة عن وضع سياسات التعليم العام قبل الجامعي، في حين أسندت مهمة الإشراف على التعليم الجامعي إلى وزارة أخرى، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لينقسم التعليم نتيجة التغير المؤسسي بين سعيه للتنشئة وبين دوره كوسيلة أساسية من وسائل اكتساب المعرفة.
قد يثور تساؤل حول علاقة هذا الطرح التاريخي لتطور النظرة للتعليم في مصر بالوضع الراهن أو بمستقبل التعليم في عالم يشهد تغيرات سريعة لها تأثيرات بعيدة المدى على المجتمعات يرصدها علماء الاجتماع في سياق رصد ملامح مجتمع المخاطرة العالمي، التي باتت تثير الشك في قيمة ما نتعلمه. وأشار عالم الاجتماع الألماني أولريش بيك (1944-2015)، الذي اهتم بدراسة الاقتصاد السياسي لعدم الاستقرار من خلال نموذج "مجتمع المخاطرة" على المستويين المحلي والعالمي، إلى أن التحولات الجارية في سوق العمل والانتقال بشكل تدريجي إلى العمل اليدوي المرتحل، تجعل المعرفة التي اكتسبها الإنسان خلال مسيرته التعليمية شيئاً عديم القيمة ولا تقدم في الوقت نفسه دليلا مرشداً إلى نوع المعارف التي يتعين على المرء اكتسابها من أجل الحصول على فرصة عمل. وقال معلقا إن "المرونة" التي بات يمتلكها صاحب العمل تعني أن العلم والمقدرة باتا قديمين ولا أحد يعرف ما الذي يمكن للمرء تعلمه كي تكون هناك حاجة لما يعمله الفرد في المستقبل".
وتزيد التحولات التكنولوجية مع الدخول في عصر الروبوت والذكاء الاصطناعي الوضع صعوبة. صحيح أن هذه التحولات تفتح المجال واسعاً أمام فرص جديدة للعمل، وتشير سلسلة من البحوث والدراسات إلى العدد الهائل من الوظائف التي تتيحها مجالات التكنولوجيا الجديدة، لكن ذلك يتطلب إعادة هيكلة مستمرة للمقررات التعليمية، لكن لا يوجد من بين هذه الدراسات أي توصيات تتعلق بالدراسة المنظمة والمنهجية لفروع معرفية وأكاديمية، بل العكس تماماً فإنه يجري التوسع في دراسة الدراسات الإنسانية والاجتماعية ودراسة اللغة والألسن وتطويرها، لأنها تقدم معارف أساسية لكل التطورات المنتظر أن يشهدها العالم في السنوات القليلة الماضية.
من الخطورة بمكان الانطلاق، فقط، من انطباعات وتوقعات غير مدروسة ولا تسترشد بالبحوث والدراسات، خاصة بمستقبل سوق العمل للاندفاع في تصريحات تشكك في جدوى بعض الكليات الجامعية، مثل الآداب والتجارة والحقوق، ولا يعني تشجيع الشباب وحثهم على دراسة البرمجيات وعلوم الكمبيوتر لضمان الحصول على فرصة عمل، إهدار قيمة تخصصات دراسية أثبتت الدراسات أهميتها لمواكبة التحولات الجارية بتأثير الثورة العلمية والتكنولوجية. ولا يمكن فهم مثل هذه التصريحات إلا من خلال فهمنا لغياب الفلسفة الموجهة لخطة الحكومة والدولة للتعامل مع جوانب أزمة التعليم.
والحقيقة أن صدور مثل هذه التصريحات بثير تساؤلات حول مستوى السياسة التعليمية وجودتها. غير ما أثارته تلك التصريحات من جدل ونقاش عام وما سببته من حالة استنفار مجتمعي على مستوى النخب المثقفة، يعكس مدى محورية مسألة التعليم لدى المصريين على مختلف شرائحهم الاجتماعية وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية، ويعبر عن إدراكهم بارتباط مسألة التعليم بالمستقبل، وقلقهم المتزايد لعدم جدوى مستوى إنفاقهم على تعليم أبنائهم، سواء من خلال مؤسسات التعليم العام الجامعي وقبل الجامعي، أو من خلال التعليم الخاص المحلي والدولي. لكن التركيز فقط على تحليل تكلفة التعليم، سواء على مستوى الأسر أو على مستوى السياسات العامة، لا يساهم في حل المشكلة، خصوصاً مع عدم الوفاء بالاستحقاق الدستوري الخاص بالنسبة المقررة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على التعليم.
التعليم: أي نوع من الاستثمار مطلوب
إن التوسع الهائل الذي شهده التعليم في مصر في العقود الثلاثة الأخيرة، والذي بسببه تعددت لدينا النظم التعليمية على نحو يزيد من حدة الانقسامات الاجتماعية والثقافية ولا يساهم في تعزيز المواطنة ونشر ثقافتها، يدفعنا إلى التساؤل عن نوع الاستثمار المطلوب من أجل إدخال إصلاحات جذرية في التعليم قبل فوات الأوان. لقد كان التعليم في عقود سابقة وسيلة أساسية من وسائل الحراك الاجتماعي في مصر، وهو في العالم آلية أساسية من آليات توزيع الفرص بشكل أكثر عدالة على المواطنين، على نحو يسمح باكتشاف المبدعين والموهوبين في المجتمع ومنحهم الفرص للتعلم والترقي، ومنح المجتمع فرصا للاستفادة من قدراتهم الذهنية في التنمية والتطور. وإذا عدنا إلى تجربة عميد الأدب العربي، طه حسين، الذي ولد في قرية من قرى محافظة المنيا لأسرة غير ميسورة، أو لسيرة العالم المصري مصطفى مشرفة، سنجد كيف أتاح التطور الحادث في نظم التعليم مع افتتاح الجامعة المصرية بجهود أهلية، الفرصة للفقراء للتعلم وإفادة مجتمعهم المحلي ومجتمع العلم العالمي.
إن النهوض بالتعليم أحد أدوات السياسة العامة التي توصي بها مؤسسات التنمية الدولية في الأمم المتحدة وخارجها، لمكافحة الفقر. وهناك العديد من الدراسات التي تثبت الدور الإيجابي الذي يلعبه التعليم في الحد من نسب ومستويات الفقر في العالم. فالتعليم لم يعد في مدارس ومذاهب التفكير المختلفة سلعة أو خدمة تقدم لمن يدفع الثمن، على الرغم من تزايد توجه الليبرالية الجديدة الداعم لتحويل التعليم إلى سلعة ومشروع لجني الأرباح على حساب الناس، إلا أن هذا النمط من التفكير الذي بات يؤثر في سياسات كثير من الأحزاب السياسية في أوروبا لم يصبح مهيمنا على السياسات العامة التي تركز على تحسين مراكز دولها في مؤشر تلبية الاحتياجات الأساسية التي بات التعليم احتياجا أساسياً. ولم يجد مثل هذا التفكير فرصة للتطبيق إلا في الدول النامية التي تراكمت لدى بعض شرائحها الاجتماعية ثروات نتيجة للاقتصاد القائم على الريع أو الالتحاق ببعض حلقات الاقتصاد العالمي.
ربما توفر بعض الاستثمارات الخاصة فرصة للدراسة قي كليات بعينها للميسورين والمؤهلين مالياً، لكنها تحرم آخرين من الفقراء الموهوبين من الاستفادة من هذه الفرصة، كما أن التعليم العام الخاص والجامعات الخاصة لم تسهم في حل مشكلة التعليم ومخرجاته، بل أضافت جوانب وأبعاداً جديدة للمشكلة وطرحت على المجتمع تحديات ومشكلات جديدة وأفقدته الثقة في مستوى التحصيل والتدريب الذي يتحصل عليه الطالب الذي درس في هذه المدارس والجامعات الخاصة، وغالباً ما تكون الدراسة فيها قناة أساسية من قنوات نزيف الأدمغة والعقول الذي تعاني منه مصر وغيرها من بلدان نامية، دون أن يعود ذلك بأي نفع أو فائدة على الدولة والمجتمع. هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في الاستثمار في التعليم العام والتعليم الجامعي في مصر كي نضمن أن يزيد هذا الاستثمار من تكافؤ الفرص ويعطي مردودا أفضل للعملية التعليمية وتحسين مؤشرات التنمية والأداء الآخذة في التدهور.
مقترحات لتحسين الوضع
لا بأس في الخطوة الأولى التي اتخذها وزير التربية والتعليم الجديدة والتي تتمثل في إعادة الدور الرئيسي للمدرسة، واتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بمراكز الدروس الخصوصية وفي التركيز على التدريب والتأهيل لمكونات العملية التعليمية، وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين، وهم الركيزة الأساسية للمنظومة التعليمية. لكن بعض القرارات التي اتخذها بخصوص بعض المقررات الدراسية وإضافتها للمجموع في الثانوية العامة، تشير إلى عدم القدرة بعد على التعامل مع تلك السنة المفصلية التي تشكل كابوسا لكثير من الطلاب وأولياء الأمور لأنها تحدد مصير أبنائهم ومستقبلهم. وفي تقديري أن المشكلة ستظل قائمة، طالما استمر غياب النظرة الشاملة للتعليم في مصر، والتي تعد مسؤولة إلى حد كبير عن ذلك الوضع المتردي الذي باتت عليه السياسة العامة للتعليم.
إن نقطة البدء قد تكون في حل سلسلة من التناقضات الأساسية في نظامنا التعليم وأولها التناقض بين وزارة التربية والتعليم، التي أضيف إليها التعليم الفني، وبين وزارة التعليم العالمي، فالوزارتان تعملان في اتجاهين متعارضين، إذ يركز التعليم العام قبل الجامعي على الجوانب المتعلقة بالتنشئة، في حين أن الطالب الذي ينتقل إلى التعليم الجامعي، المرتبط بالبحث العلمي، والذي يهتم أساساً باكتساب المعرفة بشكل متخصص ومنهجي، يجب أن يكون مؤهلا معرفيا ومدرباً على التفكير على نحو يعظم من استفادته من التعليم الجامعي. ولا يمكن إحراز تقدم طالما استمر هذا التضارب بين الوزارتين، وإذا لم يكن هناك مع وزارة القوى العاملة، على نحو يسمح لبرامج إصلاح التعليم العام قبل الجامعي بحل هذا التعارض بين مخرجات التعليم العام ومخرجات التعليم الجامعي وارتباط ذلك بسوق العمل ومتطلباته وبمؤشرات التنمية.
ولا توجد مؤشرات قوية إلى الآن تشير إلى تحسن مستوى التنسيق بين الوزارات الثلاث، رغم التوسع في برامج ومنح التعليم الفني.
---------------------------
بقلم: أشرف راضي