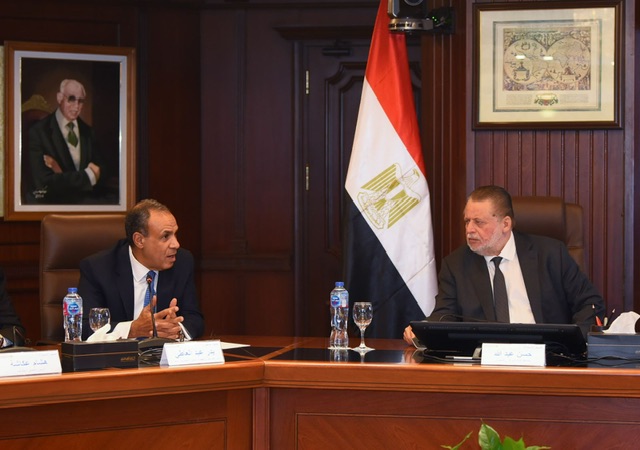مع نهايات ثمانينات القرن الماضي وانفجار غزة أولًا ثم الضفة الغربية بعدها والذي عُرف بعدها بالانتفاضة الأولى (عام 1987)، واستمر لعدة سنوات، كان هناك عدد ضخم من منظمات السلام الإسرائيلية والدولية غير الحكومية تعمل مع مثيلتها من المنظمات الفلسطينية في الداخل والخارج الفلسطيني للوصول إلى تفاهم حول سلام عادل وشامل للقضية التي شغلت العالم لفترة طويلة، وقد شاركت كثير من المنظمات العالمية وحتى حكومات أوربية مثل حكومة النرويج والنمسا و إيطاليا ـ في فترة من فترات حكم الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والحزب الشيوعي الإيطالي زمان عنفوانه ـ في دعم هذا التلاقي الفلسطيني الإسرائيلي ليس فقط بالمال بل وبالجهد المعنوي أيضًا؛ وذلك بإتاحة كثير من الموارد من أجل إنجاح هذه اللقاءات وتشجيعها على المضي قدمًا للتوصل إلى تفاهم بين الطرفين يؤدي إلى سلام، ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، وهو الشعب الوحيد الذي كان وقتها وما زال حتى الآن تحت الاحتلال.
وفي هذا الوقت كان زخم الكتابة عن القضية الفلسطينية قد بلغ قدرًا كبيرًا من الحرفية والانتشار؛ حيث قامت كثير من مراكز الدراسات في جميع أنحاء العالم، وفي العالم العربي وخاصة الفلسطينية منها، وكذلك الإسرائيلية، بنشر القضية كل حسب رؤيته لها بالطبع.
هذا ويمكن اعتبار ما كُتب عن القضية العربية الإسرائيلية والفلسطينية الإسرائيلية قد فاق كل الكتابات حتى الدينية والأيديولوجية مجتمعة ـ عدا كتابات كارل ماركس والتي تتصدر القائمة بالطبع.
ومع تلاقي محاوِرين من الفلسطينيين والإسرائيليين والكثير من المهتمين بالصراع من كافة أرجاء العالم، كان هناك زخم من نوع آخر تعلَّق بتحريك القضية دون وسيط، فلقاء الأعداء ـ والذين أصبحوا بعدها أصدقاء ـ كسر كثيرًا من التابوهات (الممنوعات) ليصبح بالإمكان الحديث عن كل شيء يخص الصراع، وعن كل ما هو ثقافي ومجتمعي وسياسي.
وكانت هذه اللقاءات هامة وعلامة على طريق السلام الذي كان منشودًا، حتى أنه خلال هذه اللقاءات كان هناك مجال لأحاديث تناولت ـ على عادة الشرق والشرقيين ـ أحوال العائلات والمشاغل الشخصية والرؤى المستقبلية لأولاد الطرفين على شاكلة «هموم مفضوحة» كما وصفها أحد المشاركين فيها أمامي.
وكانت نهاية مرحلة الدولة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفيتي قد سَبَّبَت تقلصًا كبيرًا في زخم هذه اللقاءات؛ حيث تحولت اهتمامات المشاركين (عدا الفلسطينيين) إلى متابعة ما يجري في بلدان الكتلة الاشتراكية التي تفككت خلال فترة قصيرة (1985-1990)، ومعها تحولت دول رائدة إلى دويلات، وتفتت دويلات صغيرة إلى أكثر من دويلة، وتحول معها عالم الحرب الباردة إلى عالم أُحادي القوة، ومعها صارت الولايات المتحدة الأمريكية (كما قيل وقتها) هي القائد لمسيرة «العالم الحر»، خاصة بعدما كَتب أحد الأكاديميين بها ما يعني إننا في ذلك الوقت نعاصر (نهاية التاريخ).

هذا وقد تناول كثير من مثقفي العالم هذه المقولة وناقشوها لتبيان الخطأ أو الحقيقة التي تتضمنها، ولكن التريث والانتظار في ذلك الوقت كان هو سيد الموقف.
ولو أضفنا حادثة البُرجَيْن (11 سبتمبر 2001) وحرب العراق (2003) إلى ما حدث في بدايات تسعينات القرن الماضي نجد أن تأثيرها على أي لقاءات فلسطينية إسرائيلية كان واضحًا، ولم يعد أحد يهتم بالشأن الفلسطيني إلا الفلسطينيون، وقلة من العرب الرسميين ومناهضي النفوذ الأمريكي في العالم؛ مما أثَّر على ما كان يُسمى بحركات السلام الإسرائيلية خاصة واللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية عامة، ومعها أُعلنت حقبة السلام الأمريكي في المنطقة، فالولايات المتحدة الأمريكية أمكنها ـ ويمكنها دائمًا ـ أن تتدخل بين الفرقاء، وتتوسط بينهم، وتفرض الرأي، وتمول، ولكن كان شأن تحزبها لفريق دون الآخر عامل من عوامل التشكك في مصداقية مساعيها، والريبة مما كان ـ وما زال ـ يُطرح من طرف مسؤوليها وقادتها.
ومن جهة أخرى كان الزلزال السياسي الذي مس أسس الطبقة السياسية الحاكمة في إسرائيل مع نهاية سبعينات القرن الماضي وجاء بحزب الليكود اليميني إلى السلطة عام 1977، كان له دور كبير في تغيير أصول اللعبة السياسية فيها، فهذا الصراع حول أمور الحُكم والحكومة داخل إسرائيل تحوَّل إلى صراع حول مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ أي حول السلام مع الفلسطينيين، وهنا اكتشف اليسار الإسرائيلي ـ المخلوع عن السلطة التي شكَّلها منذ تأسيسها للدولة حتى ذلك التاريخ ـ إنه يمكنه الالتفاف حول السلطة اليمينية الجديدة عن طريق تشجيع المنظمات غير الحكومية وتسهيل تمويلها عن طريق المنظمات العالمية، وتشكيل رأي عام يعضد مواقفها في إمكانية التخلي عن بعض الأراضي المحتلة ـ لا كلها ـ مع وضع البعض الآخر ـ لدواع أمنية ـ تحت السيطرة الإسرائيلية الدائمة (مثل مشروع الجنرال العمالي ايجال إيلون).

وهنا لعبت المستوطنات «الدفاعية» ـ التي شجَّع حزب العمال الإسرائيلي الحاكم وقتها على إقامتها على طوال نهر الأردن وغور الأردن منذ نهاية ستينات وبداية سبعينات القرن الماضي ـ دورًا كبيرًا في هذا المشروع الاستيطاني الأمني (لا الديني الوطني)، مقابل مشروع استيطاني ديني وطني اعتمدت عليه تحالفات الليكود مع الأحزاب الدينية، وبدايات تجمعات الاستيطان الديني والوطني، والذي ينادي ويعمل جاهدًا على طمس الخط الأخضر الفاصل بين إسرائيل والأراضي المحتلة أولًا، ثم الاستيلاء على التلال الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها لمنع أي تفاهم يمكن أن يحدث حول مستقبل تلك الأراضي.
ولم يكن ذلك هو منتهى مخطط الليكود وحلفائه في الأراضي المحتلة، بل زادوا عليها الاستيلاء على الأضرحة الشعبية الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة بحجة أنها تخص اليهود؛ كضريح راحيل في بيت لحم، ومغارة المقام الإبراهيمي في الخليل، ومغارة نابلس، والأهم هنا العمل على فرض السيطرة على باحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، كما نعرف القصة وروايتها صهيونيًّا وهي التي لم تكن مطروحة خلال فترة سلطة حزب العمال.
من هنا كان الصراع يدور هنا بين سلطة إسرائيلية جديدة ممثلة في الليكود وتحالفاته الدينية والوطنية المتطرفة، وهي التي تملك تصورًا جديدًا عن كيفية حل مشكلة الأراضي ولا تذكر معها فلسطينيتها، وتعمل على الاحتفاظ ـ وبكل ثمن ـ بكل الأراضي، وليس لديها إلا تصور واحد هو السلام مقابل السلام.
من هنا كان تجريم الكنيست الإسرائيلي عام 1985 لأي نوع من اللقاءات الشخصية للإسرائيليين مع الفلسطينيين وتجريم رفع العلم الفلسطيني.
أما الجانب المخلوع عن السلطة ممثلًا في حزب العمال والنقابات كالهستدروت وأحزاب الكيبوتسات الموحدة كحزب المابام ـ وكذلك الحزب الشيوعي الإسرائيلي الذي كان رائدًا في لقاءاته مع الفلسطينيين بطبيعة تكوينه اليهودي العربي منذ إنشاء الدولة ـ والتي كانت تروِّج لضرورة إنهاء الصراع مع الفلسطينيين على قاعدة بعض الأرض مقابل كل السلام (لم تكن الدولة الفلسطينية تشكِّل جزءًا من مقولة بعض الأرض)، وعليها كان لها أن تشجع اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية كبالونات اختبار تضع التصور الإسرائيلي على الطاولة وتسمع المحاوِر الفلسطيني للنهاية، ثم تحاول أن تصل به إلى قناعة بأن فكرتها ممكنة التطبيق، وإلا كان لهم أن يتعاملوا مع محاوِر أكثر عنفًا وتشددًا هو المحاوِر اليميني الذي كان يرفض التعامل مع أي منظمة تمثل الفلسطينيين، ويفضل التفاوض مع الدول العربية واحدة بعد الأخرى (كما يجري الآن).
والحقيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت متواجدة وبقوة في معظم اللقاءات التي جرت في بعض عواصم العالم الأوربية مثل فيينا وجينيف وبوخارست على سبيل المثال، واستمعت بواسطة ممثلين عنها أو قريبين منها لما كان يطرحه الإسرائيليون، وكان لي شرف حضور بعض هذه اللقاءات من منتصف ثمانينيات القرن الماضي إلى حرب العراق عام ١٩٩٣، وكانت هذه اللقاءات تُدار كما لو كان الجمع مكونًا من أصدقاء يبغون هدفًا نبيلًا هو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
وكان مؤتمر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني ـ والذي كان يُعقد سنويًّا وبالتناوب بين مركزي الأمم المتحدة في فيينا وجينيف ـ هو البوتقة التي شملت كل التيارات من يسارية (ممثلة بالأحزاب الشيوعية الفلسطينية والإسرائيلية) إلى يمين الوسط (ممثل بحاخامات من أجل السلام وممثلي الأحزاب العربية في إسرائيل مثل حزب عبدالوهاب دراوشة "الديمقراطي العربي" الممثل في الكنيست آنذاك) ويسار الوسط (ممثلة في بعض أعضاء حزب العمال الإسرائيلي وممثلي حزب المابام الاشتراكي الإسرائيلي وأحزاب عربية إسرائيلية تمثل كتلًا مستقلة ولها تمثيل في الكنيست أيضًا).
ولك أن تتخيل لقاء شباب من فلسطين الداخل من مصابي يوم الأرض في 30 مارس عام 1976 شخصيًّا، وكنا نحتفي بهذا اليوم كل عام في عالمنا العربي دون أن نلتقي أو نتعرف على أحد من المشاركين في هذا اليوم المعروف في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن ترى بأم عينيك مسؤولًا فلسطينيًّا مثل نبيل شعث (ممثل منظمة التجرير الفلسطينية وكانت وقتها في تونس) يدلي بحديث لجريدة ها آرتس الإسرائيلية، ومجموعة فلسطينية تلتف حول توفيق زياد وتناقشه حول كيفية التنسيق الإعلامي والحزبي بين فلسطيني الداخل والأراضي المحتلة، أو أن ترى مسؤولًا فلسطينيًّا يجلس ويحاور مع شارلي بيطون أحد زعماء حركة اليهود الشرقيين (النمور السود)، أو أن تلتقي أوري أفنيري محرر جريدة (هذا العالم) ومكسيم جيلان الناشر لجريدة هامة كانت تُعنى بالصراع في باريس، أو تجلس ضمن جماعة لمناقشة الكاتب والناشط اليهودي الإنجليزي أوري دافيز ليشرح نظريته التروتسكية عن القوميات والصهيونية بوجه خاص، ثم تستمع في الجوار إلى القيادية حنان عشراوي تُلقي محاضرة تختصر فيها المعاناة الفلسطينية للجمع الخليط، وترى ماتي بيليد الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي يروي تجربته عن خدمته البائسة في قطاع غزة وتحوله للسلام، وترى الرجوب بعد الإفراج عنه يجلس ويروي لمجموعة من النشطاء الإسرائيليين عن معاناته الطويلة في السجون الإسرائيلية، وفي النهاية كان ليل فيينا أو جينيف يضم بعض هذا الجمع لاستكمال الحديث في مطاعم ومقاهي هذه المدن، وتتم فيها تبادل البطاقات الشخصية بغية دوام التواصل، وكان ذلك يبشِّر بالخير أو بإمكانية إنهاء الصراع.

ولا شك أن 13 سبتمبر عام 1993 كان يومًا تاريخيًّا لمن أراد أن يسمع أخبارًا طيبة عن مسرى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فقيام محمود عباس بالنيابة عن منظمة التحرير، وإسحاق رابين بالتوقيع عن إسرائيل في حضور ورعاية الرئيس الأمريكي كلينتون، فيما سُمي وقتها بالاتفاقات أو التفاهمات التي أعقبتها أوسلو 1 ثم أوسلو 2، وبها وضع جدولًا للسير على طريق إنهاء الصراع لم يكن حلمًا لمن اشترك في لقاءات الفلسطينيين والإسرائيليين في مدن أوربا المذكورة أعلاه، بل واقعًا كان لا بد منه.
ولكن هذا التحول الدرامي تحوَّل إلى معضلة على طريق حل المشكلة الفلسطينية، فالمحاوِر الإسرائيلي كان يناقش فواصل كل جملة، ونقاط نهايات الجمل ـ وصفها المستشار النمساوي السابق برونو كرايسكي بأنها لا تعبِّر إلا عن طريقة تفكير محاميي جيتو وارسو ـ أو مسرحية هزلية تعمل على إرهاق المحاوِر الفلسطيني، وتدعوه لليأس من الوصول إلى حل ولو وسطي، بينما اللعب من طرف الجانب الإسرائيلي يدور على عنصر الوقت الذي يستغله لفرض حقائق من طرفه على الأرض.
ومن هنا كان من الضروري على المحاور الفلسطيني أن يفهم أن إسرائيل تعمل جاهدة على التخلي عن الكتل السكانية الفلسطينية الكبيرة ـ وغير المرغوب فيها من طرفهم ـ وتركيزهم في مساحة محدودة من الأراضي ـ أو المدن الفلسطينية الخالصة ـ وتقوم في نفس الوقت ـ وبالتذرع بالاتفاقات الموقعة ـ بتولي المسؤولية الأمنية عن باقي قطاعات السلطة الفلسطينية، وتسمح بإقامة المستوطنات اليهودية عليها وتوسيع إقليم القدس ـ أي بتهويده ـ حثيثًاً، أو كما عبَّر حاييم وايزمان خلال عهد الانتداب البريطاني على فلسطين عن مدرسته الصهيونية العملية التي تملك كثيرًا من الوقت لتنمو بالتدريج: «فبقرة بعد بقرة، ودونم من الأرض بعد دونم من الأرض».
وعليها فإن فشل الحوار وفشل الاتفاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليس بالصدفة بل مقصودًا، فمن يبني المستوطنات ويطمس الهوية ويلاحق الشباب ويمنع توفير وسائل الحياة اليومية لا يحتاج شريكًا فلسطينيًّا للحوار؛ لأنه لا يريد هذا الشريك وبدونه لا يكون سلام.
----------------------
بقلم: د. عادل السيد *
* أستاذ العلوم السياسية في جامعة انسبروك بالنمسا