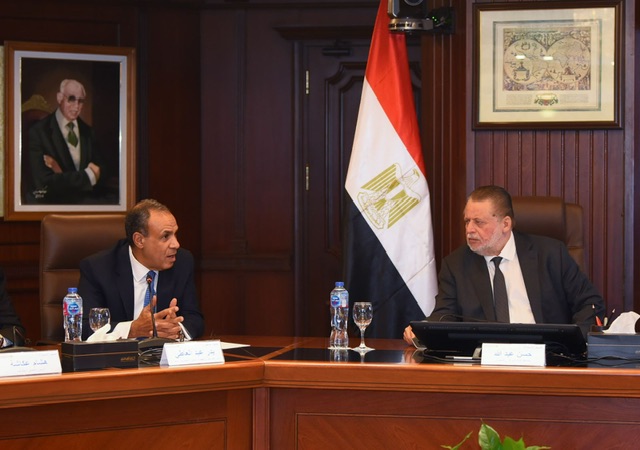تعرفت خلال دراستي للعلوم السياسية في دولة النمسا على عدة كتب مهمة لعدد من الكُتَّاب اليهود والإسرائيليين مثل زئيف شترنهيل وإيلان بابَّه وآفي شلايم وبيني موريس ومائير فيلنر وغيرهم، وتعلَّقت موضوعات البعض منهم بالأساطير المؤسِّسة لدولة إسرائيل أو بالتطهير العِرْقي أو برواية اللجوء الفلسطيني الكبير عقب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى مع قيام الدولة عام ١٩٤٨ وما تلاها من السنين حتى عام ١٩٥٣.
وكان الكاتبان زئيف شترنهيل ومائير فيلنر- وكان الأول أستاذًا جامعيًّا عمل في جامعات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وكان الأخير واحدًا من مؤسسي الحزب الشيوعي الإسرائيلي ونشيطًا من نشطائه مع رفاقه العرب داخل وخارج إسرائيل- من أوائل المتعاملين مع التاريخ الآخر أو معالجة التاريخ المروي رسميًّا بطريقة أكثر صدقًا مما تُدلي به الرواية الإسرائيلية الرسمية- هذا وأذكر أن كتبهما تعلقت بطريق مباشر أو غير مباشر مع موضوعات أطلقوا عليها الأساطير المؤسِّسة للدولة، أو الرواية الإسرائيلية للظروف التي قامت عليها الدولة، وكيف قامت أجهزة الدولة الدعائية بتقديمها للرأي العام العالمي والقارئ الأوربي لا كوجهة نظر لما جرت عليه الحرب العربية الإسرائيلية الأولى عامي ١٩٤٨-١٩٤٩ بل كحقيقة لا شك فيها، حتى عُدَّت هذه الرواية هي الحقيقة التي لا شك فيها، وعليها ترسخت هذه المعلومة أو تلك في الذهنية الأوربية على شكل لا يدع مجالًا ـ ولو ضيِّقًا ـ لقبول الرواية العربية المخالفة.
وبناء على هذه السردية أو الرواية أو الأساطير كما وصفها كل من شترنهيل وفيلنر في كتابهما فإن وجهة النظر الإسرائيلية الرسمية (التي لا تعرف الكذب) تتمحور حول وقوع الدولة الوليدة في محيط هائل من العداء العربي، وأن هؤلاء العرب مصممون على إلقاء اليهود في البحر، وأن كل حروب إسرائيل هي حروب مفروضة عليها (وظهرها للحائط)، وتحارب هذه الحروب من أجل البقاء وحماية اليهود الملاحَقين في كل أنحاء العالم.
ومن حيث إن كتابي شترنهيل وفيلنر قد تضمنا كثيرًا من الحقائق المخالفة للرواية الإسرائيلية، وفي نفس الوقت متقاربة مع الرواية العربية، فقد أتاحت كتابتهما للقارئ الإسرائيلي أولًا، والأوربي الغربي ثانيًا، فرصة التعرف على الروايتين الإسرائيلية والعربية، ليس من أجل أن يساندوا هذا الجانب أو ذاك، بل ليفهموا كيف يُدار الصراع إعلاميًّا عن طريق فبركة أساطير لكسب الرأي العام العالمي.
من هنا كان عنوان كتابهما هو (الأساطير الصهيونية التي قامت عليها دولة إسرائيل).
والحقيقة أني كنت قد أهديت كتاب الكاتب زئيف شترنهيل لمكتبة جامعة انسبروك عند تقاعدي عن الخدمة فيها، ولكني عندما حاولت استعارة كتاب فيلنر لم أجده بين كتب المكتبة، وعند سؤالي عنه قيل لي إنه مفقود - مثله مثل بعض كتب الفيلسوفة حانا أرندت وخاصة كتابها (الكتابات الصهيونية)، وهو الناقد لممارسات القيادات الصهيونية عبر تاريخها- مما يدلل على أن هناك يدًا خفية تعمل على نزع الكتب المميزة من بين صفوف الكتب لحرمان القارئ من المعلومة، وهذا ـ وعن حق ـ جُرم بيِّن لا يُغتفر.
أما أول الروايات أو الأساطير الإسرائيلية التي ذكرها كل من شترنهيل وفيلنر في كتابهما فكان قد تعلَّق بالحرب العربية الإسرائيلية الأولى عامي ١٩٤٨-١٩٤٩ وماهية الصهيونية (الأيدلوجية المؤسسة للدولة) حيث أسمتها دعاية الدولة بأنها وعليها كانت الصهيونية حركة تحررية، والحرب العربية الإسرائيلية هي حرب التحرير.
أما الصهيونية بناء على الدعاية الصهيونية فكانت هي الإيديولوجية التي قامت عليها الدولة، دولة اليهود، وبناء عليها عملت الدولة ـ وما زالت تعمل ـ على بناء وطن قومي ليهود أوربا المضطهدين بناءً على قاعدة العودة إلى وطن الآباء أولًا، ثم على الحق في تقرير المصير ثانيًا.
وبناء على الدعاية الصهيونية فإن الصهيونية كحركة تحررية لا تعمل فقط على تحرر اليهود من العتق الأبدي، بل إنها تعمل أيضًا على تحرير جيرانها العرب بما تُتِيحُهُ لهم من إمكانيات تمكنهم من استرداد حقهم في تقرير مصيرهم أيضًا.
وتمثَّلت هذه الإمكانيات ـ طبقًا لتلك الرواية ـ فيما يُسمى بالرخاء الاقتصادي والوسائل الحضارية التي تمكِّنهم من التخلص مما هم عليه من جهل وتخلف، ومن ثم الارتقاء إلى مستوى حضاري مرغوب.
ومن الملاحظ هنا أن ما ذُكر عن الرقي الحضاري هذا كان إحدى المقولات المعروفة لقوى الاستعمار الأوربي (بريطانيا وفرنسا على سبيل المثال) خاصة في مناطق غنية بالموارد المادية والبشرية مثل الهند ومصر والعراق وسوريا وأخيرًا فلسطين الغنية بالروحيات.
وهنا لا تختلف الرواية الصهيونية ـ في فكرها المؤسس ـ عن الفكر الاستعماري الأوربي، وخاصة أنها نبعت من نفس القاعدة الفكرية.
وبخصوص هذه الأسطورة المؤسسة لفكر الدولة أذكر مقولة الفيلسوفة حانا أرندت بخصوص وعود الصهاينة الأوائل أمثال حاييم وايزمن وموشيه شطريت ودافيد بن جوريون وقبلهم جميعًا تيودور هرتسل، وصبَّ في خانة تقدُّم الشعوب بواسطة حزمة من الهدايا المادية والحضارية، بأنه ليس إلا هراءٌ استعماري، فكيف لفكر تحرري وحركة تحررية أن تعمل على تحرير شعوب كاليهود والعرب وأن تسمي نفسها حركة تحررية وهي تتعاون مع المستعمر البريطاني التي عمل بدأب شديد على محو وطنيات البلاد التي احتلها، فهل سمعنا عن أن بريطانيا عملت على تنمية مقومات الوطنية الهندية أو المصرية أو الفلسطينية؟ فما نعرفه عنها أنها كانت تعمل جاهدة على هدم كل وطنيات البلاد التي احتلتها لتقيم عليها إمبراطوريتها التي لا تغرب عنها الشمس، فقيام هذه الوطنيات يعني زوال الاستعمار وبالتالي زوال الصهيونية أيضًا.
وشبَّهت حانا أرندت تعاون الحركة الصهيونية مع بريطانيا وضد مصالح المواطنين الأصليين ـ وهم الفلسطينيون ـ بمن يستخدم حَبْلًا ليُنقذ نفسه، ولكنه بهذا الحبل شنق اليهود وورطهم في عمل شائن في حق الشعوب العربية والفلسطينيين بوجه خاص.
ولا شك أن تجربة الأقلية العربية الفلسطينية التي بقيت على أرضها داخل الدولة ومثَّلت مشكلة فلسطينية داخل الكيان الصهيوني الجديد، لم تنل من هذه الأسطورة الصهيونية شيئًا البتة، حيث وُضِعَت منذ اليوم الأول لقيام الدولة تحت الإدارة العسكرية، واستمر ذلك لما يقرب من العشرين عامًا (منذ عام ١٩٤٨ إلى ما بعد حرب عام ١٩٦٧) بحجة أنها تشكل طابورًا خامسًا للعالم العربي، ومن هنا حَرَّمت إسرائيل على الأقلية العربية فيها التواصل مع عمقها العربي الطبيعي.
من هنا قامت سلطات الإدارات العسكرية المتلاحقة بتقييد حركة الفلسطينيين بتصاريح الانتقال حتى لو كان التنقل من قرية إلى قرية مجاورة ومصادرة أجهزة الراديو من كل البيوت الفلسطينية لمنع تواصلهم بأي حال من الأحوال مع جوارهم العربي، بل وحرمتهم أيضًا من ممتلكاتهم بناءً على القانون الموضوع بالخصوص لهذا الأمر، ألا وهو قانون الحاضر الغائب، فالحاضر هو الفلسطيني، والغائب هو نفس الفلسطيني، والمُصادر هو الأرض التي تخص الحاضر؛ لأنه بعُد كيلومترًا واحدًا عن أرضه وبيته، وعليها صودرت بصفته قد أصبح غائبًا.
وبالإضافة إلى كل ذلك فرضت الدولة عليهم نظامًا تعليميًّا ذا محتوى صهيونيًّا عقيمًا يبجِّل الدولة؛ يحتفي بالصهيونية وينشد نشيدها الذي لا يمثِّله، ويعمل على نزع الصبغة الوطنية الفلسطينية والعربية عنهم.
ولا شك أيضًا في أن ما كان وما زال يمنع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل من الاندماج فيها هو ما اتبعته الجماعات الصهيونية الحاكمة للأقلية اليهودية خلال فترة الانتداب البريطاني (١٩٢١-١٩٤٨) وحتى اليوم من سياسات التهويد لكل من مصادر العمل والقوى العاملة والسوق، فالأرض ـ سواء كانت أرضًا للبناء أو للزراعة ـ أصبحت بحيازتها من قِبَل اليهود شأنًا يهوديًّا قوميًّا، وبالتالي فهي لا تخضع لقواعد السوق المعروفة بالبيع والشراء، فحصول اليهود من سلطات الانتداب المتواطئة على أراضي أو شرائها من بعض العوائل الفلسطينية الغير متواجدة أصلًا في فلسطين جعل ملكيتها محصورة حصرًا تامًّا على اليهودي فقط، ومُنِع الفلسطيني من إمكانية حيازتها مرة أخرى، وكان ذلك قبل قيام الدولة هو العامل على الحصول على أراضي متواصلة تتيح قيام دولة لمواطنيها من اليهود فقط، وبذا أصبحت الدولة في خدمة يهودها فقط وليست في خدمة كل مواطنيها.
وبالحصول على الأراضي وحصر ملكيتها على اليهود- كما سبق الذكر- حصرت الحركة الصهيونية قوى العمل على العمال والزراع اليهود فقط، ولنا أن نتخيل تبعات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني في فترة الانتداب وتشكيل الكيانات الاقتصادية المستقلة داخله.
بعدها بقي السوق هو الحلقة الأخيرة في حلقات التهويد، فالمنتج اليهودي الصادر عن الأرض اليهودية والعامل اليهودي أصبح له احتكار السوق دون بديل، فأين العربي داخل الدولة، ناهيك عن الفلسطيني في الأراضي المحتلة من هذه السياسة العنصرية المؤسسة لدولة أُحادية الفكر والعقيدة والأساطير.
وتعامل كل من شترنهيل وفيلنر في سياق كتابهما أيضًا مع الأسطورة الإسرائيلية المتعلقة بإعلان الحرب على الدولة الوليدة من ست دول عربية وزحف جيوشها إليها لتدميرها وهي التي لم يزد عدد سكانها وقتها عن ٥٥٠ ألفًا من المواطنين ـ كان الكثير منهم من الناجين من محرقة هتلر النازية ـ بعد قبولهم قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم ١٨١ بتاريخ ٢٩ من نوفمبر عام ١٩٤٧.
وللقارئ أن يتخيل أن أوربيًّا شابًّا يقرأ ذلك في منهجه الدراسي عامًا بعد عام لتصبح له تلك المعلومة غير قابلة للتشكيك وليدافع عنها وينقلها كبديهية لا تقبل سماع رواية الطرف العربي.
وكان رد شترنهيل وفيلنر على هذه الرواية متقاربًا حيث قاما بطرح سؤال حول ماهية الجيوش العربية العارمة لكل من اليمن والسعودية في عام ١٩٤٨، وهل كان لهما جيوشٌ قوية ومسلحة كما كان الحال مع الجماعات الصهيونية المسلحة؟، ومن المعروف أن معظم أفراد الجماعات الصهيونية خدم بين صفوف قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية تجهيزًا لهم لتشكيل جيش الدولة المستقبلي.
وتناول الكاتبان المذكوران حالة جيش إمارة شرق الأردن تحت قيادة الجنرال جلوب باشا وبيان خطته الرئيس لتأمين الضفة الغربية تمهيدًا لضمها للإمارة الهاشمية لا لقذف اليهود إلى البحر.
أما عن جيش مصر الزاحف إلى فلسطين مع انسحاب القوات البريطانية عنها فقد وضعه الكاتبان محلًّا للسؤال، خاصة وأن نفوذ بريطانيا فيها وقتها كان قويًّا، وكان تواجدها على امتداد خط قناة السويس لا يسمح بمرور جيش مصري عارم لتدمير الدولة الناشئة، وكان الهدف منه ليس وقف بل إبطاء تنفيذ قرار التقسيم على حساب المواطنين الفلسطينيين العزل.
أما عن سوريا وهي التي أرسلت عدة آلاف من الجنود إلى فلسطين، فكان جيشها في طور الإعداد ومنشغلًا بشدة بأموره الداخلية أكثر من انشغاله بالقضية الفلسطينية، وجاء الانقلاب العسكري الأول في سوريا أثناء هذه الحرب ليدلل على ذلك.
ومن هنا نفهم أن كل من مصر وسوريا أرسلتا قوات رمزية لمنع تنفيذ قرار التقسيم على حساب الفلسطينيين وليس لقذف اليهود إلى البحر.
أما عن جيش دولة العراق وقتها، فذكر الكاتب فيلنر واقعة حدثت قد تدعو للضحك أو للبكاء، فعند وصول الكتيبة العراقية المكونة من بضع مئات من الجنود إلى مدينة (رام الله) الفلسطينية أرسل قائدها أحد ضباطه لسؤال أحد القائمين على إدارة فندق على الطريق إلى القدس عن إمكانية الحصول منهم على خريطة لفلسطين حتى تعرف هذه القوات طريقها إلى ساحة المعركة، فكيف لجيش لم يكن مجهزًا بخريطة لفلسطين أن ينتصر في طبيعة جغرافية لا يعرفها.
وقد قام فيلنر في كتابه بالمقارنة بين قوى الجيوش العربية والجماعات الصهيونية، فوجد أن الكفة تميل للأخيرة، فمجموع تلك الجيوش التي يقال إنها كانت عارمة لم يزد عن ٢٠ أو ٢٥ ألفًا من الضباط والجنود، بينما كانت قوات الجماعات الصهيونية المختلفة تزيد عن الثمانين ألفًا من المتدربين والمتمرسين بالحروب، وبذا دحض فيلنر واحدة من أهم الأساطير الصهيونية عن الحرب العربية الإسرائيلية الأولى.
ومن ضمن ما ذكره الكاتب فيلنر وكذلك الكاتب الجامعي بيني موريس في كتابه المتعلق بقصة اللجوء الفلسطيني الكبير وبالرواية الصهيونية عنه، وهي ما أسمته بـ (الهروب) وعللته بتبعات دخول الجيوش العربية لأرض فلسطين، وهنا ذكر كل من موريس وفيلنر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين وصل مع نهاية الحرب عام ١٩٤٩ لما يقرب من ٧٥٠ ألفًا وتزيد، أما عن عدد الذين أُجبروا من طرف الجماعات الصهيونية على الخروج من ديارهم فوصل إلى ما يزيد عن نصف هذا العدد مع نهاية شهر أبريل لعام ١٩٤٨؛ أي قبل تاريخ انسحاب القوات البريطانية من فلسطين والذي كان مقررًا له ١٥ مايو ١٩٤٨، وهو التاريخ الذي قررت فيه الجامعة العربية التدخل لمنع تنفيذ قرار التقسيم الظالم لأهل فلسطين.
وهنا نرى معه أن الطرد والإجبار على المغادرة لأكثر من نصف عدد اللاجئين قد تم في شكل تطهير عِرْقي قبل بداية زحف الجيوش العربية المتواضعة العدد والعدة على عكس الرواية الصهيونية.
هذا وكان الرأي العام العالمي هو المجال المتلقي لكل من الروايتين العربية والصهيونية عن طبيعة الصراع بينهما، وبينما نجحت الرواية العربية في سبعينات القرن الماضي في كسب ظهيرٍ لها في كل من بلدان إفريقية وآسيا ودول عدم الانحياز ودول المؤتمر الإسلامي ومعظم دول الكتلة الشرقية تحت قيادة الاتحاد السوفيتي؛ مما أدى إلى اتخاذ قرار أممي بدمغ الصهيونية بالعنصرية، نجحت إسرائيل في تأمين مساندة معظم دول أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية لصالح رؤيتها الخاصة بصراعها مع العرب، ولكن التغيرات الكثيرة على مستوى العلاقات العربية الإسرائيلية بقيام علاقات دبلوماسية واتفاقات سلام بين بعض الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وضعف قوى كل من منظمات عدم الانحياز، أدى إلى قبول دول كثيرة ـ ودول عربية أيضًا ـ للتخلي أو اغماض العين عن موقفها السابق من الصهيونية ورغم ذلك لم تتخل الصهيونية ولا الصهاينة عن تلك الرؤية النافية للآخر والدامغة لها بالعنصرية؛ ومعنى ذلك استمرار الصراع على حاله الأول إلى حين تحكم العقل والمصلحة الجامعة لا تلك التي تفرق.
--------------------------
بقلم: د. عادل السيد *
* أستاذ العلوم السياسية في جامعة انسبروك بالنمسا