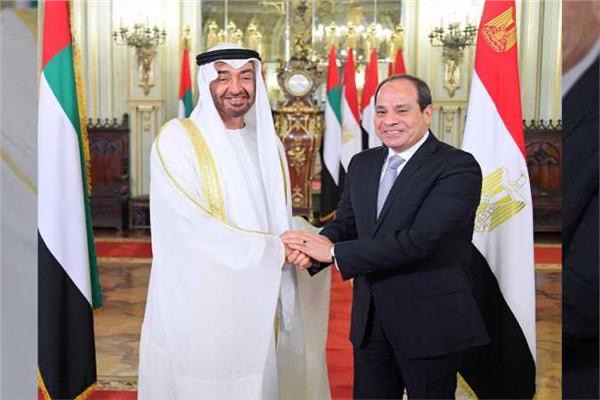الأديبة الجزائرية وهيبة سقاي من الذين جمعوا بين العلم والأدب، وقد أفادها هذا كثيراً في أعمالها الإبداعية والنقدية، وفي هذا تقول "تخّصصّي العلمي المخبري، لم يفقدني حاسّة التطّلع إلى غير حقلي.. أردت أن أستفيد من دراساتي العلمية، في معالجاتي الأدبية، فأضفت على كتاباتي روح الواقعية، التّي أملتها عليّ خبرة الأيّام، وسكبتُ فيها شيئا من الرومانسية، والخيال الحالم بما يبعث على التفاؤل وحبّ الحياة".
هي من مواليد مدينة "قسنطينة" تلك المدينة الساحرة التي تقع في الشرق الجزائري، وهي حاصلة على شهادة الدراسات العليا D.E.S في علم الأحياء الدّقيقة Microbiologyمن جامعة قسنطينة، وتعمل أستاذة معيدة بمعهد جامعي بقسنطينة، كما أنها حاصلة على شهادة في الترجمة العلمية من معهد للترجمة بالإمارات العربية المتحّدة.
وقد سكبت وهيبة سقاي عصارة إبداعاتها على صفحات العديد من الصحف والمجلات في: الجزائر ومصر والإمارات وغيرها.. ولها العديد من المجموعات القصصية والروايات والمسرحيات وقصص الأطفال مثل: "حلم حياتي"، و"دموع أغرقت البحر"، و"جرح أسود"، وغيرها...
في زيارتها الأخيرة لمدينة القاهرة، التقينا، ودار بيننا هذا الحوار الذي جمع بين حديث الذكريات ومناقشة القضايا الأدبية، فتحدثنا عن مشوارها الأدبي، وكيف وفقت بين عملها كأستاذة جامعية في مجال العلوم وبين الكتابة في الأدب الذي ملك عليها كيانها، وأصبحت الكتابة الأدبية بالنسبة لها هي الأكسجين الذي يمدها بالحياة، كما حدثتنا عن تأثير البيئة في عالمها الأدبي؛ لأن البيئة الاجتماعية – كما تقول- هي التربة التّي ينشأ فيها الأديب، وقضايا سوف نطالعها في حوارنا التالي:

*متى بدأت رحلتك مع الكتابة رغم تخصصك الرفيع في دراسة العلوم؟
- إنّ الكتابة عالم سحري نلجأ إليه دائمًا لنفرغ فيه آمالنا وأحزاننا ولواعجنا. عالم مليء بالطقوس الخّاصة والمتعة والإثارة والتشويق، تتداخل فيه الذات بالموضوع، الخّاص بالعّام، والوعي باللاوعي. هي انتماء ومتنفّس للتعبير عن الرأي والمواقف الإنسانية المختلفة.
وكانت البداية وأنا في الطور الثانوي، كنت حينها شغوفة بكتابة الخاطرة ثّم القصّة القصيرة، هي التّي تعبّر أكثر من غيرها من الفنون الأدبية، عمّا يختلج في النّفس البشرية، والوسيلة الفريدة من نوعها التّي يلجأ إليها الأدباء لولوج أعماق القلب، وتصوير شتّى مظاهر الحياة.
كنت أشيّد لأغلب قصصي صرحاً من الحوادث والمصادفات التّي أتعرّض لها شخصياً في حياتي اليومية، فيسعفني الوحي والإلهام في غضون دقائق وأخلق جوّ القصّة التّي أريد وضعها، بشخصياتها وبكّل تفاصيلها.
غالباً ما كان ينتابني هذا الوحي وأنا أسير في الطريق، أو وأنا أتحّدث مع شخص ما، أو وأنا ألاعب أبناء أخي، أو وأنا أصغي إلى وصلة موسيقية.
في أغلب الأوقات، تراني أنفرد بنفسي في غرفتي عند الغروب أو ليلاً، أحاول أن أتذّكر ما اختلج في نفسي من مشاعر نحو أغرب أناس صادفتهم في حياتي، ثّم أتخيّل ما يحدث عندما تصطدم ميولاتهم ورغباتهم بالواقع المرير، فأخلق الشخصيات، وأخلق الموضوع، و أكتب النّص القصصي.
أمّا عن فرصتي الحقيقية قي خوض عالم الأدب، فهي حينما نظمت كليّة الآداب جامعة "الإخوة منتوري" بمدينتي قسنطينة مسابقة أدبية في الخاطرة والقصة والشعر، وبالرّغم من اختصاصي العلمي، شاركت بأجمل خاطرة رومانسية، وكنت بذلك الطالبة العلمية الوحيدة المشاركة في هذا النوع من المسابقات الأدبية والفائزة بالجائزة الأولى.
كان الفوز باهرًا وكانت خاطرتي قمة في الإبداع وأثارت غيرة طلبة كليّة الآداب، ممّا جعل الهيئة المنظمة للجائزة تنشر لي نصّها على صفحات جريدة "الشعب" الجزائرية سنة 1987.
* كيف أفادتك دراسة العلوم في معالجة أعمالك الأدبية و الإبداعية؟
- إنّ كلاّ من الأدب والعلم جنسان مختلفان، والعلاقة التّي تربط بينهما، وإن وجدت، علاقة غريبة بعض الشيء غير مألوفة البتة. فالعلم باختلاف شعبه من طّب وبيولوجيا وغيرها من العلوم الأخرى، يخاطب الخلية والجزيء، وهو يحتكم إلى التجربة والدليل، بينما يخاطب الأدب الروح والفكر والجوارح، مرتكزًا في ذلكعلى الخيال و التصوّرات.
لكن الواقع العملي المعاش يكفر بهذه النظرية التّي يراها مجحفة في حّق الأثنين معا. فالعلم فنّ كما أنّ الأدب فنّ أيضاً، وإذا ما افتقِر العلم إلى الخيال فسيترتب عن ذلك افتقاره للعنصر الجمالي حتماً، كما الأدب المفتقر للتجربة المعتمد على الخيال فقط، سيفقد المصداقية.
إن اختصاصي البيولوجي المخبري يعج بمعادلات معقدة، تحّتم عليّ في أغلب الأحيان معاينة الإعجاز الإلهي في خلق الخلية والبكتيريا والفيروس بتفصيلاتها التكوينية المعقدة، والتنقيب عن المفاتيح التّي تّمكنّني من تسخير هاته التفصيلاتفي قالب كتابي مقنع، فأعثر بذلك على مستراح أطلق فيه العنان لفكري وخيالي، باللجوء إلى المطالعة والكتابة القصصية والروائية على حد سواء.
أنّ كلا من الأدوات الطبية والقلم يمثلان وجها لعملة واحدة، كّل واحد منهما يتكّفل بزرع الصالح واستئصال الفاسد، يداوي فكرة سقيمة رسخت في الذهن، وينقذ من الهلاك روحًا متعَبة تقف على شفا جرف هار، بكلمة نافعة أو بجرعة دواء ناجعة. إنّ تخصّصي العلمي لم يفقدني حاسّة التطّلع إلى غير حقلي، بل منحني الفرصة بأن أستفيد من دراساتي العلمية، في معالجاتي الأدبية، وكان سبباً في أن تميّزت كتاباتي بروح الواقعية، والتّي أملتها عليّ خبرة أيّام طويلة كنت أجلس خلالها أحلل العيّنات بواسطة مجهر، تحوّل فيما بعد لقلم صريح غزير الحبر والعطاء.
*ما تأثير البيئة في أعمالك الإبداعية وخصوصا مدينة قسنطينة التي تعيشين فيها؟
- البيئة الاجتماعية هي التربة التّي ينشأ فيها الأديب، وعلى قدر غني وخصوبة هاته التربة أو فقرها تأتي الثمار. فعلاقة الفرد ببيئته أو بالمكان الذي يعيش فيه تجسد أنموذجاً فريدا للانتماء، ويتمثل هذا في تطبّع هذا الأخير بكّل ما يمّت لهاته البيئة بصلة، أي أنّها علاقة وطيدة بمكان يصبح جزءًا من الكيان البشري، وبزمان يؤكد انتقال الموروث الحضاري والفكري من جينات الأجداد للأحفاد.
إنّ مدينتي قسنطينة، عاصمة الشرق الجزائري، قد عرفت منذ ظهورها على وجه البسيطة بـ"مدينة العلم والعلماء". ويعود الفضل في استقطابها للعلماء وطلاب العلم إلى مؤسس جمعية العلماء والمسلمين الشيخ عبد الحميد بن باديس، الذي قاوم الاستعمار الفرنسي بالكلمة والعلم.
وقد أنجبت مدينة قسنطينة عددا كبيراً من العلماء والمفكرين الإسلاميين من أشهرهم، المفكر مالك بن نبي الذي يعّد أحد أبرز أعلام الفكر الإسلامي العربي في القرن العشرين، ناهيك على كونها مركز من مراكز الموسيقى الأندلسية، ويتميز مطبخهاً بالوجبات التقليدية، وتشتهر منتجاتها بالصناعات الحرفية التقليدية، كالنحاسيات والتطريز بخيوط الذهب.
إنّ مدينتي بمكتباتها الكثيرة، بحركتها الأدبية التّي لا تكّل ولا تمّل، بجامعاتها، بمعاهدها الكثيرة، هي ملهمتي الأولى والأخيرة والتّي أدين لها بكّل نجاح أو خبرة أدبية اكتسبتها من طبيعة قسنطينة الخلابة وجسورها المعلّقة المرتفعة بشموخ على وادي الرّمال، جسور شيّدت على مراحل تاريخية مختلفة، والتّي اشتهرت بها "سيرتا"، كما يحلو لقاطنيها تسميتها، وأصبحت بمقتضاها تعرف بمدينة "الجسور المعلّقة" نسبة لهاته الجسور الفولاذية العملاقة، والتّي تربط شرق المدينة بغربها. من جميع هاته العناصر نشأتُ على حّب الفّن والمطالعة والكتابة، و"قل من تصاحب أقل لك من أنت" كما يقول المثل.

* من أين تستمد وهيبة سقاي موضوعاتها في الإبداع شعراً ونثراً؟
- موضوعاتي القصصية والروائية وحتى مقالاتي أستمدها من الواقع المعاش الزاخر بالمعضلات والمشاكل التي بات يعاني منها الشارع العربي.
إنّه واقع كلّما نظر إليه الأديب أو المفّكر بصفة عامة غالباً ما يخيّم عليه الحزن والأسى، وينتابه غّم عميق وقلق محيق، فيلمس معاناة الشعوب العربية من فقر وبطالة وهدر للثروة الشبابية وفساد إداري وتدّنٍ خطير للعملة، والكثير من المشاكل التّي تحّتم على هذا الأخير ترجمتها لقصص وروايات بلا نهاية، وكذا مقالات ينهيها بأسئلة، لا ولن تأتيه الأجوبة عنها أبدًا.
من وجهة نظري فالأديب، قاصّا كان أم روائياً، يستوجب عليه تسخير قلمه للتغيير والنصح والتربية، وأنّنا نحن معشر الأدباء، نحتاج إلى استعادة الرؤية الجامعة والصائبة في الاتجاه الصحيح، لكي نسير على بصيرة ووعي، لبناء نهضتنا الأدبية بالمواضيع التّي نختارها في كتاباتنا، ولا بد أن نعمل على رفع منسوب الوعي لدى المتلّقي على جميع المستويات، ولنعلم أن أساس التخلف والانهيار الثقافي ينبع مما نكتب ومن نوعية ما نقدّمه للقارئ من نصوص نافعة هادفة، تقترح الحلول الناجعة والعلاج الشافي لمعاناة الفرد بل المجتمع كلّه.
* كيف توفقين بين الإبداع و النقد؟
- إنّ النّقد هو تمحيص العمل الأدبي بشكلٍ متكاملٍ حال الانتهاء من كتابته، فيتمّ تقدير النصّ الأدبيّ تقديراً صحيحاً يكشِفُ مواطن الجودة والرداءة فيه، ويبيّن درجته وقيمته، ومن ثمّ الحكم عليه بمعايير مُعيّنة، وتصنيفه مع ما يشابهه منزلة. هو أيضًا النَّظر في الأثر الأدبيّ وتحليله مضموناً وشكلاً، ثمّ الحكم عليه وتقويمه.
أنا لست بناقدة ولا يمكنني أن ادّعي ذلك. ما كتبته والذّي يبدو للكثير أنّه نقدَا، ما هو سوى رؤى وقراءات ومحاولات، بها عبق النقد لمن يجهل النقد وآلياته وأسسه ومبادئه وهي لا تحمل من النّقد سوى الاسم.
* هل نعيش زمن الرواية وهل تواري الشعر بعد أن كان ديوان العرب؟
- الرواية الحديثة مفتوحة على كل الاحتمالات. وربما هذا ما يجعل الزمن هو زمن الرواية بامتياز، كون الرواية تستطيع أن تهضم في معدتها كل أشكال الأدب والفن.
وبحكم الزمن أو العصر الذي نعيش فيه تغير ترتيب الفنون الأدبية بالنسبة لبعضها البعض، ومن ثم بعد أن كان الشعر هو ديوان العرب في فترة من الفترات الماضية، أصبح هناك إعادة لترتيب هذه الفنون حسب مستويات صعودها وهبوطها بين الفنون الأدبية، كما هو الحال بالنسبةلبورصة العملات بالضبط.
ومن هذا المنطلق، أرى أنّ الرواية في زماننا باتت تحتل المرتبة الأولى بينما، تراجعت جميع الأنواع الأدبية الأخرى، من دون أن أعني بذلك أي نيل أو إساءة لها أو التلميح بإقصائها من الساحة الأدبية، التّي لا يكتمل جمالها إلاّ بكافة الأنواع الأدبية مجتمعة.
الشعر فن أرقى من الرواية كونه تعبير جميل عن النفس الإنسانية في أصفى حالاتها، و لقد ترّبع على عرش الإبداع العربي في عصور القديمة البعيدة.
أما في هذا العصر، عصر العلم والصناعة والحقائق، فكان لا بد لنا من فن جديد، يحاول التوفيق بين شغف الإنسان الحديث بالحقائق وحنينه وتوقه للخيال، أو لواقع حيالي يسعى بنفسه أن يرسم ملامحه من خلاله.
لذلك كانت الرواية فن الطبقة التي توّلدت من التغيير، وفي فضاء المكان الذي كان ساحة لهذا التغيير. هي فن الثقافة العربية الحديثة بامتياز، وهي سلسلة من الأحداث تُسرد بسرد نثري طويل يصف شخصيات خيالية أو واقعية وأحداثاً على شكل قصة متسلسلة، كما أنها أكبر الأجناس القصصية من حيث الحجم وتعدد الفصول والشخصيات.
* القدوة في حياتك؟
- القدوة هي المثال الأعلى في التصرّفات والسلوك والأفعال الذي يُقتدي به الشخص، بحيث يُطابق القول العمل ويُصدّقه، ويكون القدوة بالنسبة لأتباعه مثالاً سامياً وراقياً، فيعملون على تقليده وتطبيق نهجه والحذو حذوه، وينبع تقليدهم إياه من الإرادة والقناعة الشخصيّة للمقتدي، لا بالضغط الخارجي أو الإلزام من جهة القدوة بذلك,
والهدف من إتباع القدوة هو السعي للرقي لأعلى مستوى من الأخلاق والعلم والمعرفة.
للقدوة صفات خاصة كالنجاح، وإتباع المنهج الصحيح، والهمة والعزيمة، صفات يجب أن تتوافر في الشخص تؤهله لهذا الأمر الجلل، وفي هذا السياق يعتبر البحث عن القدوة إحدى مشاكل العصر الحديث خاصة لدى الشباب، فالمشكلة التي يواجهها هذا الأخير، ليس في غياب القدوة فحسب، بل إنها تتمثل في غياب القدوة الحسنة الصالحة التي تكون عونا للمرء على النجاح والتفوق، هذا إذا استثنينا الفئة التي يمكن أن تصنع لنفسها دربا وتشق طريقا للنجاح دون الاقتداء بشخص معين، وهذا لا يكون إلا لدى أصحاب العزيمة والهمة العالية، أضف إلى ذلك ما يحتاجه هذا الأمر من يقظة وحذر لا يتوافران عند الكثيرين من شبابنا الذين غرقوا في دوامة الانفتاح المعرفي والثقافي، الأمر الذي جعلهم مؤهلين ومهيئين في كثير من الأحيان لاستقبال ثقافات ومعارف غريبة عن معتقداتهم ومبادئهم، لتفضي بهم في نهاية المطاف إلى الاقتداء بشخصيات قد لا تحمل أيا من صفات القدوة الحسنة، مما يعود عليهم بالسوء والوبال على حياتهم وتصرفاتهم وشخصياتهم.
هذا من جهة تعريفي للقدوة، أمّا بالنسبة لي كأديبة وباحثة علمية، فأنا لا أؤمن بالقدوة في المجال العلمي الأدبي. قدوتي هي اجتهادي وسعيي لتحقيق ذاتي في الميدان الثقافي المعرفي الذّي وقع اختياري عليه ليس إلاّ.
لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن اقتدي بأي شخص كان، أنا أجهل الظروف الذّي أوصلته لما هو فيه من نجاح و رفعة علمية، ظروف تختلف اختلافا تاما شاملا عن ظروفي أنا.
كيف لي إذا أن أقتدي به ومسار نجاحه، يختلف حتمًا عن المسار الذّي وضعته أنا لنجاحي في حياتي العلمية الأدبية.
ربّما يكون الهدف الذّي قد وضعه هو لا تشابه بينه و بين الهدف الذّي أرنو إليه وأسعى لتحقيقه على أرضية، هي بعيدة كلّ البعد في طبيعتها، عن الأرضية التّي اتخذّها هو للارتقاء لأعلى درجات الرقّي والتميّز.
وتظّل خير قدوةٍ على وجه الأرض رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ثم الأنبياء والمؤمنين، وقد كان رسول الله مربياً عظيماً وهادياً بأخلاقه وحكمته وسلوكه، فهو قرآنٌ يمشي على الأرض، لقوله تعالى: (َقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا)، ويا لها من قدوة!
-------------------------------------
حوار - أبو الحسن الجمال
* المحاور كاتب ومؤرخ مصري