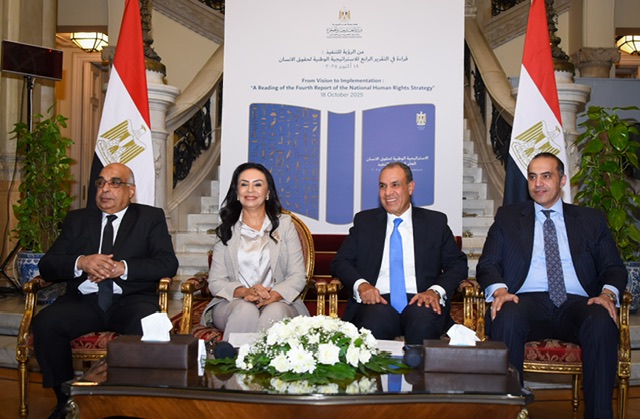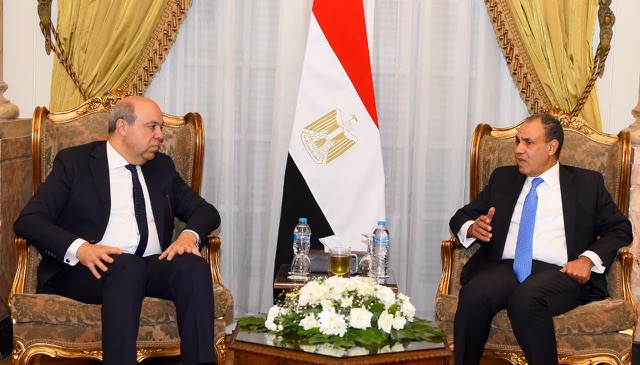وَقفْت وحدي، على حافة الحياة أنظر إلى عالم أوشك على الفناء. أتأمل تلك الوجوة المُلثَمة التي تَفِر من الموت بقناع هزيل ليس قادراً وحده، على درء الخطر المُتربِص. المحاكاة اليومية أصبحت قيد الأغلال والمحاذير. هناك من يُطبق الإجراءات بفزع يَلتهِم روحه وينزَع عنه بقايا الحياة المتاحة، وهناك من سئم التكبيل وآثر أن يحيا ما تبقى له فى رحاب الماضي غير عابيء بالمستقبل. أسفل الكمامات لَمحْت الانطفاء يختبىء إلى جوار الملامِح المُجهَدة، حيث تتوارى ابتسامات تُكافِح الانقراض.تحشد العيون قدراتها لتوجيه رسائلها بعد أن باتت مُنفردة فى ساحة خاوية بلا ملامح تؤازر صيحاتها. الأقنعة الواقية التهمت وجه البشرية وطمست قدرته التعبيرية، وتركته يشبه الألوف وسط غوغائية الطرقات وزحام الغرباء.
أخذْت أُطالِع الأوجُه؛ المُضطرب منها وغير المُكترث. المُلتزم حد الاقتراب من الموت، والمُستهِتر حد الانغماس فى الحياة. المُتعقِل حد الاكتئاب، والمتوحدٍ حد الانعزال.. الجميع راكضون على خط النار، ولكن درجة إحساسهم بالاشتعال متفاوتة. وفى ذات يوم أثناء مطالعتي بعض التقارير على المنصات الإلكترونية، لمحت تقريراً يطرح تساؤلاً حرجاً حول تأثيرات الوباء على علاقاتنا الانسانية وما قد تتسبب فيه إجراءات التباعد الاجتماعي من تغيير فى سلوكيات الأشخاص. والتساؤل عما إذا كان شبح الموت والتباعد الاجتماعي سينال من قيمة "الحب" ويطعن فطرتنا الانسانية ككائن اجتماعي من الطراز الأول أم ستظل مشاعرنا وعواطفنا أقوى من الخوف اللا إرادي من الموت؟!
والواقع أنني التفتت إلى حقيقة هامة، ربما لا يزال لم يمسسها يد التغيير كأشياء كثيرة تغيرت فى حيواتنا جراء الوباء. على أقل تقدير، بقيت قيمة "الحب" الوحيدة المٌقاوِمة نسبياً لـ"نوبات" التقلُب الشعوري الناجمة عن "إعصار كورونا". فلا يزال "الحب"- عند البعض- هو الضمانة الوحيدة القادرة على الإفلات من هذا الجحيم، ولو على المستوى اللحظي. ليست مزايدة على أوجاع البشرية، وإنما ترياق بديل حال احتجبت كل الطرق المؤدية للنجاة. "الحب" بمفهومه المجرد ورحابته المعنوية هو الذى يقهر لحظات الوحدة ويخلق تلك النجاة التى هددت بعدم الإتيان. الحب والرحمة بكل صورهما وأشكالهما، ليس فقط ما بين البشر، حتى وإن كانت تجاه حيوانتنا الأليفة. ذلك الشعور الخالص بالقرُب والحرص على الأخر، يمنح الطمأنينة والسلام رغم اقتراب الخطر، بل ويخلق خطوطاً دفاعية يمكنها قهر هزائم النفس. يرسم دروباً بلا قيود للخلاص تتلاشى معها مخاوف المستقبل. ببساطة لأنه يدعك تستغرق في نقطة ضوء هاربة من ظلام العزلة في عالم قرر الانتحار دون فرصة للمداولة، وكأنك توصد أبوابك عليك ولا تدرك الجحيم بالخارج.
تلك المشاعر الإيجابية يمكنها اقتيادك إلى مساحة أخرى ليست متاحة وسط اللحظات الراهنة. تلك الأحاسيس الباقية على قيد الحياة، يمكنها تقزيم وساوسك وتعظيم مكاسبك اللحظية البسيطة. "للحب" طاقة نجاة تعجز عن تقديمها كل الحلول المنطقية والاجراءات العقلانية. ذلك السلام النفسي لا يفوح إلا من هذه القارورة العتيقة، وكأنه المسكن القوي الذى يتناوله أصحاب المرض العُضال، كى يتجاوزون قضمات الألم. لقد صارت المشاعر وسط فوضى هذا الزمان بمثابة القنينة السحرية التى قهرت المس الشيطاني الآني، الياسمينة البيضاء التى نجت من حرائق الحياة والمحارة المختبئة التى غفت بداخلها أخر مظاهر إنسانيتنا المتآكلة. لقد صارت "مشاعرنا" الشراع الوحيد الذى تهتدي به جحافل الموشِكين على الغرق، والجندول اليتيم غير المثقوب على صفحة المحيط الثائر. فمَن أراد اللحاق بالعربة الأخيرة فى قطار النجاة، ليبحث له عن مليمترات سانحة فى خندق الأحاسيس، لربما قُدِر له البعث وهو على قيد هذه الحياة المؤجلة.
-----------------------
بقلم: شيرين ماهر
من المشهد الأسبوعي