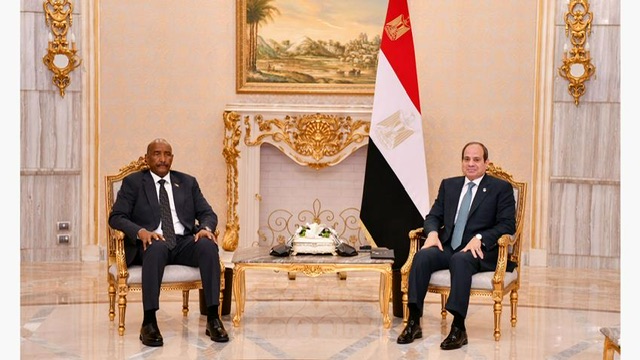شكى لي صديق من أنَّ ابنه يقول له:
"إنَّ كلَّ رفاقي إمَّا أدمنوا أوْ انتحروا، فاحمدْ ربَّك أنَّني لمْ أفعلْ هذا أوْ ذاك حتَّى الآن!"
قال الابن ذلك لأبيه كتهديد مبطَّن أثناء إلحاحه عليه أنْ يدفع له رسوم الدراسة في الخارج لأنَّه ما عاد يطيق الحياة في مصر. وحين قال له أبوه إنَّ الحياة كفاح وإنَّ الإنسان لا بدَّ له من أن يقاسي ويصبر ويحتمل من أجل أنْ ينجح ويثبت ذاته، قال الابن:
"وهلْ لا بدَّ لي من أقاسي لا لشيء سوى لأنَّك قاسيت؟!"
أحسستُ بأنَّ أمير الشعراء أحمد شوقي يبكي الآن في قبره، وهو القائل:
وطني لوْ شُغلتُ بالخلد عنه
نازعتني إليه في الخلد نفسي!
والأرجح أنَّ مصطفى كامل أيضًا ينطح جدران قبره، وهو القائل:
"لوْ لمْ أكنْ مصريًّا لتمنيَّتُ أنْ أكون مصريًّا، فأنتِ أنتٍ الحياة ولا حياة إلَّا بكِ يا مصر!"
وكذلك يقينًا حال شاعر النيل- المهدَّد الآن- حافظ إبراهيم، وهو القائل:
كمْ ذا يكابد عاشقٌ ويلاقي
في حبِّ مصرَ كثيرةِ العشَّاق
إنِّي لأحمل في هواك صبابةً
يا مصر قدْ خرجتْ عن الأطواق!
وترحَّمتُ على الزمن الذي كنَّا نشعر فيه بالتقصير في حقِّ آبائنا بالرغم من أنَّهم لمْ يوفِّروا لنا الرفاهية التي وفَّرناها لأبنائنا، لكنَّني لمْ أدنْ هذا الشاب وأمثاله ولمْ أعتبرْه من الجاحدين. إنَّ هذا الشاب- وملايين مثله من أبناء الطبقة الوسطى- ممَّن ليسوا بجوعى أوْ محرومين أوْ مشرَّدين، لكنَّهم بالرغم من ذلك ناقمون وكافرون بآبائهم وأوطانهم يعانون من اليأس والإحباط الناجميْن عن القهر. والقهر ليس سياسيًّا وحسب، وإنَّما هو أيضًا اقتصاديٌّ واجتماعيٌّ فالإنسان يعدُّ نفسه مقهورًا إذا أحسَّ بأنَّه لا يستطيع أنْ يغيَّر أيَّ شيء لا في حال وطنه ولا حتَّى في حال نفسه. وهؤلاء الشبَّان الغاضبون ليسوا واهمين أوْ مبالغين فيقينًا إنَّ واقع الوطن خانق ومستفزٌّ، ويقينًا إنَّ الطرق كلُّها مغلقة والآفاق كلُّها مسدودة لأنَّهم أسرى مجتمع متجمِّد طبقاته الاجتماعيَّة راسخة في هرم طبقيٍّ فرعونيٍّ جاثم على الصدور لمْ يتزحزحْ منه حجرٌ واحد منذ عصر بناة الأهرام، بينما الشبَّان يريدون مجتمعا مثاليًّا وبشرًا من الملائكة، ويشقيهم أنْ يجدوا المجتمع أبعد ما يكون عن المثاليَّة ويفجعهم أنْ يجدوا كثيرًا من البشر أقرب إلى الشياطين منهم إلى الملائكة.
أجل الشبَّان يائسون، ولكنْ هلْ هذا هو اليأس الوحيد الذي يحسُّه البشر؟
إنَّنا- كبشر- يائسون من أنَّنا سوف نحيا إلى الأبد، ويائسون من أنَّ البشريَّة ذاتها سوف تحيا إلى الأبد، بلْ ومن أنَّ هذا الكون نفسه سوف يدوم إلى الأبد، وبالرغم من ذلك ما زال البشر يعملون ويكدِّون لأنَّ القعود عن العمل سوف يضاعف ألف مرَّة من بؤس هذا المصير المحتَّم لأنَّ كيفيَّة الحياة هي الأمر المهمُّ وليس كيفيَّة الموت. فعلينا أوَّلا أنْ نتناسى هذه المحتَّمات ونطرحها خلف ظهورنا كيْلا تشلَّنا، بلْ وأنْ نجعلها حافزًا لنا على ألَّا نهدر هذا الوقت القصير الذي قدِّر لنا أنْ نحياه فوق هذه الأرض، وأثمن وأقصر ما فيه أيَّام الشباب.
والشبَّان حائرون، وفي حيرتهم يضيعون أزهى سنوات العمر التي يكون الإنسان فيها متفجِّر الطاقات والقدرات قادرًا على الكفاح ومناطحة الصخر لأنَّ الشباب الباكر هو ما يحدِّد ما سوف نكون عليه طوال عمرنا من فشل أوْ نجاح أوْ سعادة أو بؤس، على الرغم من أنَّ الشباب الباكر هو أيضًا المرحلة التي لا نستطيع فيها أن نقرِّر أيَّ طريق نختار وهو المرحلة التي نتعرَّض فيها لأسوأ الإحباطات، وتلك هي المعضلة.
لكنَّ ذلك لمْ يمنعْ من صمَّموا على النجاح والترقِّي والبروز من المضيِّ في طريقهم الوعر. أتذكَّر بعض زملائي الذين كان آباؤهم بسطاء أوْ كانوا أيتامًا في كليَّة احتشدتْ بأبناء كلِّ الواصلين في مظاهرة مستفزَّة للثراء والنفوذ وطبقيَّة صارخة فاجرة. لمْ يكنْ لهؤلاء الزملاء أدنى أمل في التألُّق وسط هذا المجتمع المتعالي المغلق في وجوههم، لكنَّهم أصرُّوا على ألَّا تطأهم الأقدام وبالفعل لمْ تطأهم الأقدام بلْ وطأوا هم كلَّ التحديَّات، وهم الآن من أشهر أستاذة الطبِّ في مصر وأعلاهم مناصبًا.
لأنَّ هناك بعض الحقائق الثابتة التي لا تتغيَّر وهي من سنن الحياة الراسخة، فلا أحد يحقِّق شيئًا بلا كفاح وبلا معاناة، ولا أحد ينتصر انتصارًا كاملًا أوْ يسعد سعادة صافية لا تشوبها شائبة، وحتَّى هذه المكاسب المنقوصة التي نحقِّقها بشقِّ الأنفس ليستْ بدائمة. ولا أحد يبلغ أبدًا حتَّى آخر يوم من عمره حال الرضا بما حقَّق أوْ يتمُّ حتَّى آخر يوم من عمره كلَّ مشاريعه المعلَّقة، بلْ يفارق الناس كلُّهم الدنيا وهم في حسرة على أنَّ الوقت لمْ يكنْ كافيًا.
ثمَّة أيضًا حقيقة أخرى لا يمكن التغافل عنها: أنَّ مئات الأجيال ضحُّوا بحياتهم من أجل تحرير مصر وكرامتها، وهذه حقيقة تاريخيَّة مشرِّفة رغم ابتذالها في الأفلام والمسلسلات- وكان أقسى ما يعاقب به الاستعمار مقاوميه أنْ ينفيهم خارج مصر لأنَّ المصريَّين طوال تاريخهم الطويل جدًّا اعتبروا النفي دائمًا عقوبة أقسى من الموت، بينما يعتبر الجيل الحاليُّ أنَّ البقاء في مصر هو الأسوأ من الموت، فما سرُّ ذلك الانقلاب المرعب من الضدِّ إلى الضدِّ؟
إنَّ الإنسان لا يتردَّد في التضحية من أجل وطنه طالما كانت التضحية مجدية وطالما ظلَّ في النفوس أملٌ حتَّى لوْ كان الأمل للأبناء والأحبَّاء وسائر بني الوطن أنْ تكون التضحية هي ثمن حريَّتهم أوْ ثمن إنقاذهم من البؤس. أمَّا حين ينعدم الأمل- وقدْ أوحتْ مجريات الأمور في العقد الأخير بانعدام الأمل- فإنَّ الإيثار يُعدُّ تغفيلا والتضحية تُعدُّ حماقة والبقاء في الوطن يُعدُّ انتحارًا فلا يفكِّر الإنسان إلَّا في القفز من السفينة الغارقة ولا يشغله سوى نجاته الشخصيَّة وخلاصه الشخصي.
ويقينًا أنَّ من أسباب إحباط الشباب أيضًا إخفاق انتفاضتهم التي شبَّتْ في بداية العقد الحالي، والتي بعث نجاحها الأوَّليُّ آمال هذا الجيل اليائس وآمال أكثر المصريِّين. غير أنَّ الشبَّان المتمرِّدين وجدوا أنفسهم ساعة الفعل والتضحية في جانب وبقيَّة الشعب المحافظ الحذر في جانب، وأخطأ الشبَّان خطأ قاتلًا حين توهَّموا أنَّ تغيير الحاكم وحسب سوف يحوِّل مصر إلى سويسرا، ونسوا أنَّ الحاكم ليس إلَّا إفراز مجتمع مثل الهيدرا كلَّما أطحتَ برأس نبت مكانه على الفور عشرة رؤوس، وأنَّ لمصر معضلاتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ والمتغلغلة في لحم الوطن مثل سرطان. ومن هنا أتى الإحباط لأنَّ التوقُّعات كانت بمعزل عن الواقع وفوق الإمكانيَّات ونظرتْ إلى الأوضاع نظرة رومانسيَّة أعمتها عن جسامة العقبات وطول الطريق. ولا شكَّ في أنَّ الجهل هو أدهى تلك العقبات وأعصاها على العلاج، وأنَّه أبو كلِّ الشرور التي يعانيها الوطن من فقر ومرض وفساد إلى آخر القائمة التقليديَّة لأمراض مصر المزمنة. والجهل ليس الأميَّة- وإنْ كانت الأميَّة جهلًا بالطبع- فكلُّ أميٍّ جاهل، وليس كلُّ جاهل بأميٍّ إذْ قدْ تلقى الطبيب الجاهل والمهندس الجاهل والمدرِّس الجاهل ويتجلَّى جهل هؤلاء في أحاديَّة المعرفة والنظرة وفي انعدام الوعي. وما من شكٍّ أيضًا في أنَّ أبشع أنواع الجهل وأضرَّها هو جهل المواطن بحقوقه وبواجباته.
لكنَّ الشبَان كانوا كلَّما تذكَّروا مشكلة خرجوا في مظاهرة، والآن ثبت أنَّ المظاهرات ليستْ حلًّا سحريًّا للمشكلات، وبدأتْ نهاية الحلم حين خذلتها الأغلبيَّة غير الثوريَّة يوم أتتْ بالإخوان وهم جماعة رجعيَّة متزمِّتة متحجِّرة الفكر تؤمن بالطاعة المطلقة انطلقتْ مجالسها التشريعيَّة الرجعيَّة تصوغ مزيدًا من القيود المكبِّلة حتَّى للأنفاس وتعالوا على الشعب بوصفهم المطهَّرون وسواهم الأنجاس فكان لا بدَّ من الإطاحة بهم، لكنَّ ذلك أجهز على الثورة وردَّ الأوضاع إلى أسوأ ممَّا كانت عليه فتحسَّر الناس على الماضي ولعنوا الثورة والثوَّار فكفر الشبَّان بآبائهم وبمجتمعهم وبوطنهم.
إنَّ تراكم الأوضاع اليائسة المنهكة المحبطة خلق شبابًا عاجزين عن الكفاح، حائرين في اتِّخاذ القرار، متعجِّلين لا يطيقون مزيدًا من الصبر لأنَّهم رأوا آباءهم بلْ وأجدادهم الذين صبروا وكافحوا وتحمَّلوا وضاعتْ كلُّ تضحياتهم هباءً، بلْ وتردَّتْ الأحوال من سيِّء إلى الأسوأ ثمَّ إلى الأسوأ الذي ليس من بعده سوء وهو البؤس المطلق والفقر المُدقع.
وهذه الأوضاع أفرزتْ على مدى الأجيال مجتمعًا أشدَّ جهلًا ممَّا كان عليه يحتقر العلم وطريقه الطويل غير المجدي، ويستهتر بالقيم أكثر ممَّا كان مستهترًا، ومنعدم الضمير أكثر ممَّا كان منعدما. وهذا الحال البائس اليائس لا يخصُّ دولة بعينها، بلْ يعمُّ كلَّ دول العالم الثالث، ويسحق مستقبل كلِّ شباب العالم الثالث. سوف تجده في مصر وتجده في كلِّ الدولة العربيَّة غير النفطيَّة وتجده في الفلبِّين وتجده في الهند وفي دول أمريكا اللاتينيَّة وحتَّى في روسيا وأوروبا الشرقيَّة.
والموقف المنطقيُّ العادل تجاه هذه الظاهرة المدمِّرة- الأشبه بغضب يونس وهجره موطنه بعدما يئس من إصلاح قومه- ليس الاكتفاء بالتنديد بالخيانة المزعومة المتَّهم بها الشبَّان المارقون على أوطانهم والفارون منها، لكنَّه التساؤل عمَّا جعل هؤلاء الشبَّان يؤمنون إيمانًا راسخًا لا يتزعزع بأنَّ البقاء في أوطانهم نوعٌ من الإعدام أوْ الانتحار، وعمَّا يغريهم بالفرار من أوطانهم مهما كان الثمن وحتَّى لوْ لمْ يتمُّوا دراساتهم التي لمْ يبقَ على نهايتها إلَّا بضعة شهور بالرغم من مخالفة ذلك الطبيعة البشريَّة التي تجعل كلِّ إنسان لا يطمئن إلَّا في وطنه ولا يحنُّ إلَّا إليه ولا يذوق للسعادة طعمًا إلَّا فيه.
ليس الحلُّ أيضًا بمحاولة إنعاش الروح الوطنيَّة المُحتضَرة بالأغاني الحماسيَّة أوْ بطوابير الصباح التي نهتف فيها بحبِّ الوطن بينما الهاتفون موقنون بأنَّ الوطن أوذي وامتُهن يوم أوذي المواطنون وامتهنوا، فلا كرامة لوطن طالما أنَّ مواطنيه أذلَّاء لأنَّ الوطن ليس سوى مواطنيه.
في النهاية فإنَّني لا أقول لأيِّ شاب: هاجرْ أوْ لا تهاجرْ، أوْ كافح أوْ لا تكافحْ أوْ اصمدْ أوْ لا تصمدْ لأنَّ كلَّ هذه القرارات شخصيَّة تمامًا ولا يتَّخذها أحدٌ نيابة عن أحد. كلُّ ما أرجوه من أيِّ شاب ألَّا يعزو نجاحه أوْ فشله إلى أمِّه أوْ إلى أبيه- أوْ إلى إنسان غير نفسه- فلا أحد ينجح أحدًا أوْ يفشل أحدًا، والطريق الذي يمضي فيه الإنسان من ساعة فتح عينيْه على هذه الدنيا حتَّى ساعه إغلاقهما هو طريقه وحده وعليه أنْ يمضي فيه وحده لأنَّ في العالم من الطرق بعدد ما فيه من أحياء.
فلا يعتذرنَّ إنسان عن فشله بأنَّ أباه لمْ يساعده أوْ بأنَّ أمه لمْ تسانده إذْ كم من العظماء بلا آباء أو أمَّهات أوْ أخوال أوْ أعمام، والناس- وإنْ كانوا قدْ يعزون نجاح شخصٍ إلى أبيه أوْ أمِّه أوْ حسبه أوْ نسبه- غير أنَّهم لا يعزون فشل الشخص إلَّا إلى الشخص وحده، فهلْ سمعت عن قائد عسكريٍّ هُزم في معركة ثمَّ نُسبتْ الهزيمة إلى أبيه أوْ إلى أمِّه، أوْ مجرم برَّأته المحكمة لأنَّه كان بلا أمٍّ أوْ بلا أب؟!
ولا يغرَّنك النجاح الوهميُّ الذي يُحرَز لأبناء الواصلين المتبلِّدين فإنَّه لا يفرحهم ولا يرضيهم عن أنفسهم فرحة ورضا من يصنع نجاحه بنفسه، وبلْ لا يجعلهم يحترمون أنفسهم ولا يجعل الآخرين يحترمونهم حتَّى لوْ تظاهروا بذلك إذْ لا يخفى عليهم وعلى غيرهم أنَّهم أقزام.
------------------
بقلم: د. أحمد زكي