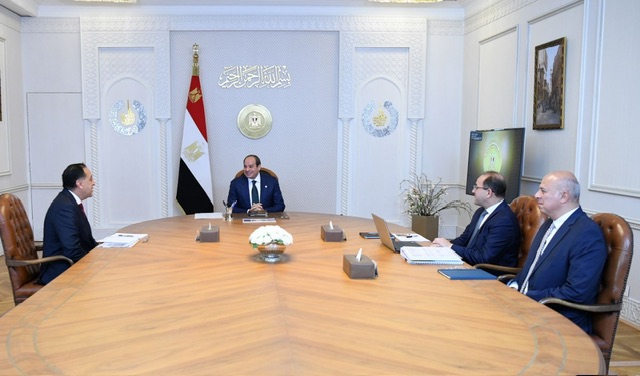نَوّارَة.. وسِفْر العَودة للحلم وسبائك الأصفر والأشعار والخوف والمقابر.. في واحةٍ أفلتتْ من الجَنة
"طائر النار" ينهض مِن رقدته بعد اثنين وأربعين عاماً
كما النَّوّارَة *؛ كان إدراكي يتفتَّح بهدوءٍ وتَؤدة، فقد احتفظتْ مُخَيلتي مُذ نعومة ذكرياتي في بيت والدي"الحاج طه" -رحمه الله- باللون الأصفر المُبهج؛ ذلك الذي يَسرُّ الناظرين، لم أكن أعي سِرّ احتفاء بيتنا به، فتارةً أراه مستديراً به شَقٌ يُغلِق بحنوٍ بالغ على آخَر يماثله؛ متراصٍ في صفوفٍ بعنايةٍ فائقةٍ في صندوق أنيق؛ تعتَرشه أوراق شجرٍ ذات لونٍ سُندسيٍّ فخيمٍ يثيرُ ارتياحاً وانتعاشاً في النَّفْس، ومرةً ألمحه مُختالاً مُتباهياً مزهواً بسطوعه داخل زجاجاتٍ وقوارير قدَّرتْها أمي تقْديراً، وتارةً ثالثة أنظُره يفترش بساطاً ناعماً لامعاً؛ ينتظر بتوقٍ - لعدة أيام متعاقبة - إشراقة الشمس الذهبية في شُرفة بيتنا، فيزداد وهجاً يخطف الأبصار؛ لحظتها يتناهى لمسامع الصغار تحذيرات أمي المتكررة: إيّانا والاقتراب مِن أصْفرها!
في تلكم الأيام المتوهجة؛ يكاد باب البيت يأبَى على الغلق لكثرة الزائرين والجيران والأقارب الراغبين في ودِّ أصفرنا! فها هي أمي بابتسامتها الرائقة تغدو وتروح حاملةً في كفيها بعضاً منه؛ تعطيه بترحابٍ شديدٍ لمن يَوده، وما إن تفرغ يداها حتى تعاود الكَرَّة ثانيةً وثالثةً ورابعةً؛ إلى أن يكفّ الجميع عن المجيء ويُوصد الباب؛ ساعتها يتملكني العَجب، فأرنو إليها أُسائِلها لأفهم ما غمُض عليّ، فتُربتُ على كتفي باسمةً: (إنه المشمش يا حبيبتي)!
تُكمِل أمي:
"تلك الثمرة التي تزورنا خمسة وعشرين يوماً فقط في شهر مايو/أيار مِن كل عامٍ، فأبوكِ وَرِث عن جَدكِ أرضاً غِراسها المشمش والبرتقال بقرية "العَمَار الكبرى" بالقليوبية؛ وكما ترين نحتفظ ببعضها لنأكله؛ فنتركه مُغطى بأوراق شجر "الزَّنْزَلَخَت" حتى يتم نُضجه تماماً، وبعضه نُحيله لعصيرٍ يكفينا طوال العام حتى الموسم القادم، وما تبقّي نهصره ونغليه؛ ثمَّ نصبُّه على مفارشٍ بلاستيكيةٍ شفَّافةٍ؛ نظيفةٍ؛ مدهونةٍ بقليلٍ مِن زيت الزيتون فيصير "قمر الدين" وهو ما تَرينه زاهياً يجف أمامك تحت أشعة الشمس، ولا يفوتنا أن نهدي الأصدقاء والجيران والأقارب الذين يترقبون حِينَه مِن كل عام".
الآن تنجلي الغَبشة وتتضح الرؤية، أعودُ مستفسرةً: "كيف أتقنتِ تلك المهارة وأنت ابنة مدينة المنصورة ولم يسبق لك العيش في الريف أبداً؟! تضحك أمي مُتباهيةً بشطارتها: (تعلمتُ مِن نساء عائلة أبيك أثناء زياراتنا المتبادلة؛ حتى تفوقتُ عليهنَّ بشهادة الجميع).
أُسِرُّ لنَفْسي أمْراً: أنَّي لتلك الفاكهة الصغيرة-المعدودة الأيام- بتبوّءِ تلك المكانة الفريدة؟! فكان أول درسٍ يرسخ بوعيي: أنَّ العِبرة بالقيمة لا بالحجم ولا بطُول المُكُوث والبقاء.
اعتادتْ أمي الذهاب للسوق لتبتاع أغراض البيت مُصطحبةً إياي، وألِفْتُ رؤيتها مُتهللة الأسارير ساعة تصافح بعض النسوة اللاتي تصادفهن مُبادرةً إياهن بسؤالها المكرور: (إنتِ مِن العَمار الكبرى؟ طيب؛ بلِّغي السلام لفلان وفلانة؛ فقد أوحشانا؛ ولم نراهمْا مُذ زمن)، أُدهَشُ؛ كيف عرفَتْ أمي أنهنَّ مِن ذات القرية؟ تلمحُ بفطنتها السؤال بعيني فتجيبني: (العَمار الكبرى هي القرية الوحيدة المعروفة بزيِّ نسائها الخاص، يحبونه ويعتبرونه تراثاً وعلامةً تميزهنَّ، ولا يرضين عنه بديلاً أو تحويلاً).
تقبضُ الوالدة على معصمي بحماسٍ مفاجيءٍ؛ وتُسرع الخَطو صَوب "سوق الذهب"، فتتناهى إلى مسامعنا إيقاعات طبولٌ وصوْت مزامير وعزفٌ خاص بالأعراس اعتدناه، وإذ بجموعٍ غفيرةٍ مِن القرويين يملؤون محل الصَّاغة الشهير، والصائغ يعرض كمَّاً كبيراً مِن المشغولات الذهبية الباهظة الثمن، وطيف ابتسامةٍ هنيئةٍ مطمئنةٍ تعلو شفتيه انتشاءً؛ فأهل العريس حتماً سينقدونه مبلغاً مالياً كبيراً جرّاء "الشَبكة الذهبية" التي ستختارها العروس.
تسرعُ الأم بهمَّةٍ وهي تحثُّ صغيرتها على العَدو قائلة: (تعالي نُهنيء عروس العَمار)! وقبل أن أرفع حاجبيي مُعجبةً بفراستها ومتعجّبةً في ذات اللحظة؛ تضحكُ بصوتٍ خفيضٍ: (معروفٌ عن أهلِ العَمار أنهم أغنياءٌ مُترفون، فأكثرهم يمتلكون حدائق "مَشامِش"، وتجّار الذهب يعرفون ذلك وينتظرون أعراسهم في موسم حصاده مِن كل عامٍ، ودوماً شبكة عروس العَمار أغلى من مثيلاتها مقارنةً بالقرى المجاورة، وقطعاً تُجار الذهب يدركون أنهم سيربحون الكثير في موسم الجَنْي).
هنا.. كان لابد للدرس الثاني أن يترسَّبَ في عقلي الصغير: هناك إذن شئٌ بل أشياء تميز تلك القرية الثريّة تجعل أهلها يفخرون بها وبتراثها وزيّها.
"أهلا ببنْت الأكْرمين"..
تلك تحيتهم الأثيرة دوماً - لي ولأختي حنان - كلما زارنا الأقارب من أهل البلدة، يردفونها بقولهم: (تعالوا البلد لتروها، وتسهروا في "ساقية العَبيّدة"، غير معقول ألا تعرفوا أصْلكم وأرضكم وعائلتكم الكبيرة ذات الشأو العظيم، لكن انتبهوا لابد أن تقولوا "العَمَار الكبرى"؛ فهناك بلدة أخرى تُدعى "العَمار"فقط و"كفر العمار" و"العمار الصغرى)، يضحك والدي مرحباً بهم، فينقلون له أخبار العائلة وهموم الأرض ومشاكل الفلاحين، ومنهم بعض أقاربنا الذين يستأجرون أرضنا؛ فيجيؤون ليُنقدوه القيمة الإيجارية لأرض المشمش والبرتقال؛ نظراً لظروف دراسته وعمله وزواجه التي جعلته يعيش حياته ما بين مدينة المنصورة وبورسعيد وبنها مُذ صغره، فحالت دون قدرته على رعايتها بنفْسِه.
أحببنا مُذ الصِّغر مجالسة الأقارب وأهل البلدة؛ والذين كانت ملابسهم تفوح برائحةٍ نفّاذةٍ خاصة لم نكن ندرك سرّها؛ عرفنا فيما بعد أنها رائحة أوراق الشجر والمزروعات التي يعيشون بين خيراتها الوفيرة وندى الصباح البِكر الذي يبادلهم عِشقاً بعِشقٍ، ودائماً ما كانت تبهرنا أسنان عمّتي "أنعام" - زوجة الحاج دسوقي تاجر الأقمشة المعروف- المصنوعة مِن الذهب؛ والتي يزدان بها فمُها كلما ضحِكتْ أو تهلَّلتْ قسَماتها، فتزيدها أناقةً فوق أناقتها التي اعتادتْها واشتُهرتْ بها، خاصةً حين تتحلى وتتزين بقِرطها المخروطي الجميل وعقدها الذهبي الكبير ذي الحبّات الزيتونية الشكل والذي يملأ مساحة صدرها كله؛ ويزداد بريقه ألقاً فوق زيّها العَماري الشهير المُحاك مِن المَخمل (القطيفة) الأسود الكثيف والناعم المَلمَس، والمُزدان بخيوطٍ ونقوشٍ ذهبيةٍ، ومن طفولتي وعقدها يلفت انتباهي وإعجابي!
مذ نعومة أظفارنا وتَفتُّح أبصارنا ونحن نرى صورة ًبحجمٍ كبيرٍ معلقةً في بيتنا على جدار غرفة استقبال الضيوف لرجلٍ سَمْته وقور؛ يقتعد كرسياً في عَظمة ومَهابة الملوك؛ شديدُ الاعتناء بهندامه؛ بادِي الثّراء، كان الرجل وثيق الشَّبه بوالدي، حتى خِلناه هو ونحن صغار، وبمرور السنوات عرفنا أنه جَدي "محمود"-رحمه الله- فكنّا نتحلق حول الوالد ليحكي لنا: (كان جَدكم مِن كبار الأعيان؛ وقوراً؛ بالغ الاعتناء بمظْهره، يرتدي دوماً الجِبّة والقفْطان، وقد كان ذلك زياً مُتعارفاً عليه يرتديه فقط مُلاك الأراضي الزراعية، ظَل محبوباً بين الناس، حين يرونه راكباً حماره مُتفقداً أرضه؛ يركضون خلفه حُباٌ في مشاهدة هِندامه الأنيق؛ أو رغبةً في مصافحته؛ أو طلباً لقضاء حوائجهم).
يواصل الوالد حديثه:
( كان جَدّكم واسع الاطلاع والمعرفة؛ مُثقفاً؛ أول مَن أدخل المذياع في البلدة، داوم على دعوة أهلها ليجتمعوا في "مَندرة العَبيّدة" لسماع أخبار مصر والعالَم العربي، وفي ذات الوقت كان حريصاً على شراء الصحف اليومية مِن "البَندر/ المدينة" ليقرأ عليهم أحوال الدنيا، فقد كان مدركاً لأهمية الوعي والثقافة، وكم أوقدَ حماس الكثيرين لطَلب العلم، ولم يكن ذلك مِن فراغ).
يُكمِل حديثه:
فجَدي الحاج محمد - رحمه الله- كان قاضياً شرعياً بمحكمة قليوب، وعالِماً فقيهاً، وله إرثٌ- وقْفٌ- كبير باسمه، ولكن لم تستطع العائلة حتى الآن الحصول عليه، والقضايا في المحاكم طالت سنواتها إلى وقتنا هذا، وعنه ورثَ والدي مكتبةً ضخمةً تعجُّ بأمّهاتِ الكتب في مختلف فروع المعرفة، تلك الكتب ورِثتُها بدوري؛ بعضها ترونها بالبيت، والبقية احتفظُ بها في صناديق وأجْولة؛ وفي نيتي التبرع بها لمكتبة الأزهر الشريف، فهي كتبٌ قَيّمة؛ بَيْدَ أنها تحتاج للترميم.
من هنا بدأت أفهم سر حرص والدي على ألا نقرب "أجولة الكتب" التي يراها كنزاً ثميناً يليق بمكتبة الأزهر الشريف.
أيقنتُ أنَّ عادة القراءة في بيتنا لم تكن وليدة المصادَفة، وكذا شغف أبي بمتابعة الصحف اليومية؛ وحفظِهِ القرآن الكريم مُذ حداثة عُمره؛ واهتمامه بالبرامج الثقافية ومتابعة خطابات الزعيم "أنور السادات" لم يكونا مِن فراغٍ، بل هيأ لي عقلي وقتها أنه ربما كان خَط والدي الرائع - والذي يشبه كتابة الخطاطين في جَماله ونَسقه - وليداً لنَهمه وحُبِّه للقراءة! فقد كانت روعة وحُسن خطه مثار حسَد الكثيرين له، لدرجة أن يديه احترقتا بالكامل نتيجة صعق كهربائي؛ وظل شهوراً طوال حتى مَنَّ الله عليه بالشفاء وعادت لطبيعتها؛ ووقر في أذهاننا أنه الحسد ولا شئ غيره.
وهنا آن للدرس الثالث مصاحبتي: "الوعي" الذي هو وليد القراءة قيمة تفوق وتعلو، ولا يُعْلى عليها.
ينثالُ في نفوسنا اعتزازنا بالبلدة والعائلة؛ فنلتفُّ مِن وقتٍ لآخر نسمع مِن أبي ذكريات طفولته المليئة بالمغامرات، وكيف كان يبيت بالمقابر ليلاً هرباً مِن عقاب الشيخ في الكُتَّاب، حتى أنه ذات يوم مشهودٍ كان يجري فوق إحداها فانهار سقفها وسقط وسط عظام الأموات!

الانتحار:
على ذِكر الموت لا أنسى - وأنا بالمرحلة الابتدائية - الحركة غير العادية التي انتابت بيتنا، ووفودٍ الزائرين والأقارب والتجَهّم والدهشة الحزينة تعتريان وجوههم، واضطرار أبي للسفر مراتٍ متواليةٍ لمَسقط رأسه! أدركنا أنَّ خطباً جللاً حلَّ بالعائلة، لم نتبين الموضوع على وجه الدقة، لكن ظلتْ كلماتٌ غريبةٌ عالقةً ببالي: انتحر.. الحريق.. مستشفى الأمراض العقلية.. كان المترجم الخاص للسادات..الصعق بالكهرباء..كافر..كان موسوعة.. شديد الذكاء.. لم يفهمه أحد.. جنازته مهولة تشبه جنازة عبد الناصر.. النابغة.. الناس تخشى ذِكر اسمه..الاشتراكية.
الفضول يعترينا جميعاً، انتظرنا أياماً حتى هدأتْ وتيرتها، ولكن صعُب على والدي أن يشرح لنا - أو ربما أشفق على طفولتنا- ومع ذلك أخذ يواصل حكاياته؛ لكنّا أصررنا على أن يقص علينا مِن أخبار"أحمد عبيدة" ابن عمنا الشاعر وسرّ انتحاره، فنهرنا قائلاً: "لن تستوعبوا الأن، حينما تكبرون ستفهمون"، لكنه هدأ قليلاً وأخذ يسرد لنا كيف أنه ذات مرة ذهب لزيارة ابن عمه الحاج "عبد العليم" - والد الشاعر أحمد - فرآه يرعى شؤون أرضه مُصطحباً صغيره، فلما اقترب والدي مصافحاً الصبي لاحظ ورَماً بارزاً بدماغه "دِمّلاً" فاشفقَ عليه مِن وهج الشمس، واستسمح الحاج "عبد العليم" كي يتركه يعود للبيت ويكفيه دراسته وواجباته المدرسية ولا داعي لتحميله أعباء الزراعة، فيضحك أبوه قائلاً: (وهو الولد راح ينفع في التعليم؟ بُص على "الدِّمّل" اللي طلع في راسه، ده دليل إنه غبي ومش ها يفلح ولا ها يفهم حاجة، خليه يتعلم زراعة الأرض أحسن).. وأعقب ذلك بضحكة ساخرة مجلجلة.
بشغفٍ واهتمامٍ نَحثُّ أبينا ليكمل ما بدأه، يبتسم وعلامات حزنٍ تعلو قسمات وجهه محاولاً مداراتها: "حدث العكس تماماً، فقد نبغ الولد، وظل يساعد أباه في أمور الفِلاحة، وفي عَين الوقت مُقبِلاً على دروسه بهمّةٍ عاليةٍ، وظهرتْ عليه موهبة الشعر؛ وكان مُقبلاً على القراءة بنهمٍ بالغٍ سيّما تاريخ الشعوب وحركات الكفاح لأجل الحرية والمساواة؛ واشتُهِرَ عنه ربْط شَعْر رأسه بخيطٍ مشدودٍ بمسمار في الحائط؛ حتى إذا ماغلبه النوم وترنَّحت رأسه مِن أثر السَّهر والتعب يقوم الخيط بشد رأسه ثانية للخلف؛ فيتنبه مستيقظاً كي يُكمل مذاكرته! فلما توفي والده، انتقل لبيت عمَّته - كانت كفيفة - لترعاه مصطحباً إخوته، ولمِس أعمامه الثلاثة شغفَه الشديد باستكمال تعليمه، فساعدوه حتى التحق بالجامعة؛ وكانت ابنتا "الزعيم جمال عبد الناصر" و"عبد الحكيم عامر" زميلتيه، وبمهارته أتقن ثلاث لغات أجنبية- الإنجليزية والروسية والفرنسية- وبعد تخرُّجه في الكلية عام 1964 عُيّن مُترجماً فورياً بوزارة الخارجية، صار بعدها مُترجماً خاصاً لأنور السادات".

يستطرد أبي:
"رغم تفوقه وتميزه كان فائِق التواضع والبساطة، فحين يستلم راتبه "الكبير حينها" يشتري بقيمته كلها"لحمة"؛ يُنضِجها في بيته؛ ثم يدعو أهل البلدة جميعهم ليطعمهم بنفْسه والفرحة تغمره، وجعل "طُرمبة المياه" في بيته سبيلاً، يملأ منها مَن يشاء ما يشاء وقتما يشاء، وذات مرةٍ خرج متنزهاً على شاطئ الترعة يترنّم بأشعارٍه؛ فقد كان موهوباً في الشِّعر؛ شغوفاً بترديده، وإذ به يرى بعض الفلاحين يعملون؛ فخلع ملابسه؛ وبودٍ شديد تناول فأس أحدهم؛ وأخذ "يعزق" الأرض بدلاً منهم حتى أنهى عملهم كله، فقد كان يتميز ببنية جسده القوية، وبَسطة الجسم التي ورثهما عن أخواله، وكان يتردد عنه أنه يستطيع القيام بعمل ثلاث رجال في وقتٍ واحدٍ، بنية جسده القوية تلك جعلت الأولاد - في صغرهم - يتجنبون عِراكه؛ فحتماً سيغلبهم، لكنهم لم يكونوا يعلمون أنه يحمل قلب طفل.. بل قلب عصفور.
سِفْر العَودة
الحكايات المُشوِّقة عن بلدتنا والتي تتوالى مِن فِيه الوالد جعلتها كحُلمٍ نودُّ تحقيقه، وسنون الحُب تترعرع مُسرعة في قلوب الصغار؛ وشوقنا لزيارتها ينهض مُطلاً برأسه ناظراً إيّاها، وصورة "العَمار الكبرى" تتضح بجلاءٍ في عقولنا: بلدةٌ شديدة الثراء، حبَاها الله بفاكهة المشمش المتميزة النادرة، أهلوها يتمسكون بتراثهم، يعونَ قيمة العِلم والثقافة، أُناسها محبوبون موَقَّرون، يصل صيتهم وشهرتهم للمدن حولهم، وجدي الكبير القاضي الشرعي؛ ووقْفُ العائلة الشهير، وقصة المذياع والصحف التي دخلت على أيادي جدي البيضاء، وابن عمي "محمود" الذي صار بطل مصر في رفع الأثقال؛ وطفقتْ شهرته الآفاق، وابن عمي "أحمد" ذلك الشاعر الذي "أماتوه" منتحراً لشدة ذكائه واطلاعه على أسرارٍ عسكريةٍ وسياسيةٍ قام بترجمتها في "مفاوضات الكيلو 101" عقب حرب أكتوبر المجيدة،ونضاله في صفوف الكادحين، حتى أنه كان يعارض والده حين يراه يشتري قيراطاً زراعياً جديداً! تُراه حقاً لم يلقَ مَن يفهمه - على حد قوله المأثورعنه - أم أنَّ هناك أسراراً توارتْ خلف أبواب عُمْره التي اُوصدتْ وانتهتْ مبكراً؟
بالمرحلة الثانوية كنتُ، حالَ قرَّر والدي- ذات موسمٍ لجني المشمش - أن يصطحبنا لنقضي عدة أيام بالبلدة المُبهرة؛ ونتعرف عن قُربٍ بعائلةٍ نفخر بالانتساب إليها؛ ففي أحد الصباحات البادية الإشراق من شهر مايو/ أيار؛ انطلقتْ الأسرة جميعها بسيارةٍ خاصةٍ في طريقها للـ "الحُلم"، ما إن وصلنا مشارفها حتى طلبَ مِن السائق أن يمهلنا وقتاً لزيارة المقابر، تلك التي لفت انتباهنا وقوعها في مدخل القرية، وبذلك لن يستطيع أحد دخول البلدة دون أن يمر عليها، فهي أول مايصادف المرء،وهو ما لا نجده في القرى الأخرى - كما عرفنا فيما بعد- وحين تتجلَّل أبصارنا بمهابة المكان المُحاط بنبات الصٌّبار، تشير أمي نحو مقبرتين واضحتين عليها "شاهدان" كُتبَ عليهما اسم العائلة، إحداهما للرجال والأخرى للسيدات، إحساسٌ غريبٌ يتسلل لنفوسنا فتمتد أيادينا نُمسك بعضنا البعض، فلأول مرة نزور هدأة الأموات وجلال الموت.
شرَعَ الوالد ينبهنا لقراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والغفران لجميع الأموات، وطفِقَ يردد على مسامعنا أسماءهم الواحد تلو الآخر، بدءاً مِن جَدنا مروراً بـ "أحمد الشاعر"، آه.. أتذكره الأن جيداً وحكاوي والدي عنه، لكن تُرى هل انتهتْ حكايته عند وفاته عند واقعة انتحاره؟ لم أكن أعلم وقتها، ولكن كل ما أدريه أن زيارتناللمدافن تلك لن تكون الأخيرة (ففي القريب بل والقريب العاجل؛ تُوفي أخي "محمود" الشاب ذو الثمانية عشر ربيعاً غرقاً في الأسكندرية، وعاد أبي بنا يزور نفس المقابر، يتلو علينا الأسماء مرة أخرى بدءاً مِن جَدنا؛ لكن هذه المرة منتهياً باسم ابنه البِكر وفلذة كَبده).. قرأنا الفاتحة لأمواتنا وأموات المسلمين كافَّة، ثم أشار والدي نحو مقبرة أخواله؛ فاتجهنا صوبها وفعلنا ما فعلناه بسابقتيها، ومن يومها ظلت علاقتي بالبلدة مجرد زيارة لأمواتنا؛ أو لدفن أخي؛ أعقبه دفن والدي فأُمي.. رحمهم ربي جميعاً.
---------------------------
بقلم: حورية عبيدة