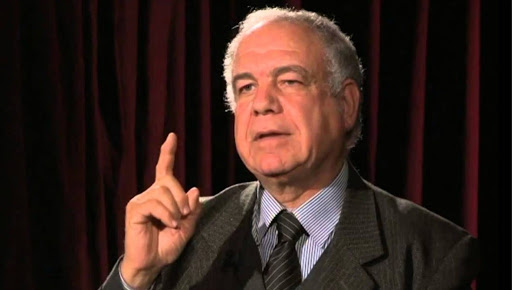يميل العقل البشرى إلى الهروب من"كوابيس" الواقع ومشكلاته، بالعودة إلى "فراديس" الماضى وتصوراته، وبدلاً من إعمال الإرادة لتغيير ما يتوجب تغييره من سلبيات، وإكمال ماينبغى إكماله من نقائص، وصنع حقائق جديدة، راهنة، تستحق أن تُعاش، يكون المهرب الخيالى هو الأسهل، بالرحيل إلى عوالم دارسة لن تعود، واستدعاء مثاليات ماضية من المستحيل إيقاظها، كحلٍ وهميٍ لأزمات ضاغطة، وهرباً من مواجهة تحديات آنية لا تحتمل التأخير، وإعلاناً لليأس من القدرة على مقاومة الأزمات التى تبدو متعذرة الحل، والمصاعب التى تبدو عصيّة على المواجهة!.
هكذا يهرب "الإسلاميون" إلى عصر الإسلام الذهبى، الذى مضى عليه قرون إثر قرون، وولّت أيامه ولن تعود، وكذلك يهرب "الليبراليون" إلى وهم كبير اسمه "العصر الذهبى" لليبرالية المصرية، عصر ماقبل ثورة 23 يوليو 1952، التى يكرهونها أيما كُرهٍ، ذلك العصر الذى أسبغوا عليه أوصافاً غير حقيقية، ومنحوه سمات غير واقعية، وصوروه بألوان ناصعة، نموذجية، لم تكن قائمة أبداً !.
وهذا أمرٌ طبيعى، فالإنسان دائم الحنين للماضى الذى ولّى ولن يرجع أبداً، وخصوصاً ذلك الماضى السحيق، الذى لم يعش لحظاته، أو يُعايش تفاصيله، ويميل إلى أن يُضفى عليه، مع مرور الزمن وكر الأحقاب، صفات العظمة والكمال، بل وربما التبجيل والقداسة!، وفى المقابل ينزع عنه كل مظهر من مظاهر الضعف والتردى!.
ولا يعنى تفنيد مزاعم "أيتام" العصر الملكى الراحل، نزع كل صفة حميدة فيه، أو نعته بما لم يكن فيه من مثالب، وأيضاً لا يعنى ذلك، بأى حالٍ من الأحوال، إنكار أن عصر 23 يوليو أيضاً لم يكن عصراً كامل النزاهة أو خالص المثالية، بل كان مثل كل عصر له مشاكله، وكجميع العهود له نقائصه، لم يخل من الأزمات، بل و"المصائب"، ولا خَلِىَّ من المتكسبين ونهّازى الفرص!.
وهذا أمرٌ طبيعى للغاية. فكل ماتقدم من أزمنة، بكل تجلياتها السياسية، وتفاعلاتها الحياتية، هى جزء من الخبرة البشرية، بها إيجابيات وسلبيات كل تجربة تاريخية، ولولا هذه الأخطاء والسلبيات، ماتعلم الإنسان وتطور، ولولا ما كابده من مشاقٍ، وما استوعبه من دروس مستفادة، مما اقترفه من أخطاء، بل ووقع فى براثنه من خطايا، لما تقدم خطوة واحدة إلى الأمام.
إن الانحياز الهستيرى لعهد الملكيّة المنقضى، والتطبيل لـ "ديمقراطيته" الراسخة، المزعومة، والانبهار بـ"عظمته" وإنجازاته، والحنين له، ولطقوسه، ولرموزه، ولأيامه، بل والترويج لاستعادة أمجاده ووقائعه، يعكس لدى البعض، حالة من حالات "النوستالجيا ـ Nostalgia" المرضية، حتى أنى دُعيت منذ مايقرب من خمسة عشر عاماً، إلى حفل فى قصر من أطلال الملكية البائدة على مداخل محافظة الجيزة، يُحتفى فيه، دورياً، بعض هؤلاء، بعصر الملكية ورموزها، ويُبجِّلون مظاهرها وتقاليدها، ومناسباتها وذكرياتها، إلى حد أنى شعرت وسطهم، كما لو كانوا شخصيات تؤدى أدواراً مرسومة فى فيلم ملحمى، روائى تاريخى، أو مسلسل درامى، أو وثائقى، يتناول تلك الفترة، وسط أثاث وتماثيل ومأكولات ومشروبات ذلك العصر، الذى يؤمنون بأنه كان أجمل العصور وأزهاها، وأن مصر خلاله كانت واحدة من الدول المتقدمة، تضارع أكثر بلدان العالم رُقياً وامتيازاً.
فهل كانت هذه الصورة صحيحة؟ّ، أم أنها مجرد مجموعة من التصورات المزخرفة، لا تصمد أمام الحقيقة بجفافها وصلابتها، ولا تلبث أن ترسب فى أول اختبار !.
مقاومة الحفاء: مشروع مصر القومى!
كانت مصر آنذاك، منقسمة إلى قسمين، وبالمناسبة لازالت: "مصر العِشّة" و"مصر القصر"، على حد تعبير الشاعر الكبير "أحمد فؤاد نجم"!.
ويصف أستاذ الاقتصاد المعروف، د. "جلال أمين"، فى إيجاز، حالة المصريين، قبل 23 يوليو1952 ، ويوجزها على النحو التالى:
" كانت الازدواجية الاجتماعية فى مصر فى 1950، تتمثل أساسا فى المفارقة الصارخة بين الريف والحضر، حيث يسود فى الريف، الذى كان يسكنه ما لا يقل عن 80% من السكان، الفقر والأمية والمرض، بينما تحظى المدن بالشوارع والمساكن الأنيقة، والمدارس الحديثة، وتوجد بها تقريبا كل ما تحظى به مصر من مستشفيات ومصحّات وأطباء، مصريين أو أجانب، وينافس سكانها فى مستوى معيشتهم سكان أكثر الدول تقدما.
(...) وكانت الطبقة العليا ضئيلة الحجم جدا، بالنسبة لمجموع السكان، وتتكون من ملاك الأراضى الكبار (أو الاقطاعيين إذا شئت) ومنهم الأسرة الملكية وحاشيتها.
كان لايزال الكثير من عائلات هذه الطبقة تجرى فى عروقها دماء تركية، ويعتزون بذلك، وينظرون إلى بقية المصريين على أنهم مجرد (فلاحين)، كما كانوا غارقين حتى الأذنين فى نمط الحياة الغربية، تختلط فى كلامهم اللغة العربية بلغة أجنبية، ويمارسون كل عادات الغرب فى المأكل والملبس والمسكن، فضلا عن المدارس التى يرسلون إليها أولادهم. كان كل هذا من شأنه أن يعزل هذه الطبقة عزلا شبه تام عن بقية المجتمع: لهم قصورهم ونواديهم وشواطئهم التى قد يراها بقية الناس من بعيد دون أن تطأها أقدامهم قط".
ولعل أوضح مايُشير إلى حقيقة وضعية الأغلبية المصرية المزرية، فى تلك الحقبة، والحديث لعالم التاريخ المصرى الحديث، الراحل، د."رءووف عبّاس" هو معرفة، أن "نسبة المُعدمين، فى ريف مصر، كانت تبلغ 76% عام 1937، وبلغت نسبتهم 70% من جملة السكّان، عام 1952"، أى أنها كانت تزيد باضطراد عاماً بعد عام!.
والأوقع أن نعلم أن "مقاومة الحفاء"، كان هو مشروع مصر القومى آنذاك، فقد كان ملايين من المصريين، وبالذات فى الريف، وبينهم مئات الآلاف من تلامذة "الكتاتيب" والمرحلة "الإلزامية"، فضلاً عن الفلاحين وعمال التراحيل، والكثير من قاطنى وعمال المدن أيضاً، غير قادرين على امتلاك ثمن حذاء بسيط ينتعلونه، فيسيرون حفاة فى عز القيظ وتحت سيول المطر!.
وفى مقال طريف وعميق للمؤرخ د."يونان لبيب رزق"، كتبه فى "ديوان الحياة المعاصرة"، عنوانه: "مقاومة الحفاء"، يُشير إلى حال معظم أبناء الشعب المصرى فى تلك الآونة، حيث "الفلاحون، رجالاً ونساءً، يذهبون إلى حقولهم شبه عارين، أما عمال الطبقات الدنيا، وكذلك جمهرة سكّان المدن، فيسترون أجسامهم بالكاد ببعض "الهلاهيل"، وبالطبع لم تتضمن هذه "الهلاهيل" غطاءً للقدم مهما كان نوعه!".
ويذكر د. "يونان" أنه بعد بناء الدولة الحديثة، فى النصف الأول من القرن التاسع عشر، لم يكن الفلاح المصرى، "الذى كان يشكل الغالبية العظمى من السكّان، ينتعل شيئاً فى قدميه، إلا إذا تم تجنيده وارتدى الزى العسكرى بالكامل، فلم يكن معقولاً أن يخوض الباشا الحروب التى خاضها بجيوش من الحفاة"!.
والأطرف والمُحزن أيضاً، أن الجنود بعد انتهاء مدة خدمتهم، كان عليهم أن يُسلموا "العهدة"، ومن بينها "الجزمة الميرى"، وكان عليهم ان يعودوا أدراجهم إلى القرى التى تحدّروا منها، كما أتوا مُهلهلى الملابس ... حفاة الأقدام !.
واستمر هذا الحال البائس حتى عهد المللك الأخير، فاروق، ومع اقتراب نُذر الحرب العالمية الثانية، (اكتشف) الحُكم فجأة، كما وصفت صحيفة "الأهرام"، (يوم 19 يونيو 1940)!، "أن كثيرين من طبقة العمّال والفقراء، يسيرون حُفاة الأرجل، ولمّا كانت حالة هؤلاء تُعرِّضهم لخطر الغازات السامة إذا استُعملت فى الغارات الجوّية، فقد اهتمت المصلحة بهذا الموضوع، وهى تبحث، بالاشتراك مع وزارة الشئون الاجتماعية، مشروعاً يرمى إلى توزيع نعال من المطّاط على المحتاجين، وقاية لهم من خطر الغازات"!.
ثم دخل القصر الملكى، بجلالة قدره، على الخط، حين ظهرت الدعوة إلى ما وصفه أصحابه بـ "المشروع القومى"، وهو مشروع "مقاومة الحفاء"!، نظراً لخطورة هذه الظاهرة على صحة الماكينات البشرية المنتجة: العمال والفلاحين، باختراق الديدان (وخاصة الإنكلستوما)، لأقدامهم، وأعلن "جلالة الملك"عن رغبته فى "ألا يمضى وقت طويل، إلا ويرى جميع "رعاياه" يرتدون النعال فى أقدامهم، شأنهم فى ذلك شأن الشعوب "المتقدمة"!، وقدّم "هبة ملكيّة سخيّة" مفتتحاً باب التبرعات لتحقيق هذا المشروع !.
وفيما تبرع أحد فقراء المصريين، بكل ما يستطيع لتحقيق هذا "الحلم"، وهو مبلغ "عشرة قروش"، لا يملك سواها، كان من المذهل أن (يتبرع) نفر من كبار الوجهاء والماليين ومُلاّك الأراضى والمحلات الكبرى، من الباشوات والباكوات: "طلعت حرب باشا، ودسوقى أباظة بك، ومحمد حسن العبد بك، ومحال "جروبى" و"بنزايون" و"عدس"، بمبلغ قدره سبعة عشر جنيهاً لاغير، كما سارعت البيروقراطية الحكومية للعب دورها المستمر حتى الآن، ففرضت تبرعات إجبارية فى المؤسسات الحكومية والمديريات، ثم لما انطلق نفير الحرب، توقف "المشروع" بالكامل، وأعلن "حسين سرى باشا" أن "قيام الحرب من شأنه أن يجعل أمر تنفيذ المشروع عاجلاً، أمراً غير ميسور"!.
و... كذبة ازدهار الاقتصاد المصرى:
ويروج أنصار العهد الملكى، لتقدم اقتصادى مزعوم، لم يكن له أدنى تَجَسُّدٍ، فى تلك الفترة، ويدللون على ذلك بأن انجلترا كانت مدينة لمصر، (بسبب خدمات قُدِّمت لها أثناء فترة الحرب العالمية الثانية)، وغيرها من الأوهام الشبيهة!.
ما أشبه الليلة بالبارحة!:
ويشير الباحث الاقتصادى، "محمد عادل زكى"، فى دراسة موثّقة، تناولت أوضاع الاقتصاد المصرى، منذ ماقبل الحملة الفرنسية، إلى الوقت الراهن، إلى أن هيمنة الدول الأجنبية على اقتصاد مصر، حولتَّه، مع الاحتلال البريطانى، (1882-1922)، "إلى اقتصاد تابع كليةً، يُصدّر المواد الخام، وفى مقدمتها القطن، للاقتصاد المتبوع، بريطانيا، ويستورد السلع والمنتجات الصناعية"، (التى يغلب عليها طابع المنتجات الاستهلاكية)!.
ويضيف أنه "مع الاحتلال البريطانى تم ربط مصر، سياسياً واقتصادياً، بالاقتصاد البريطانى الاستعمارى، وصارت زراعة الأرض مرتبطة بما تحتاجه الأسواق البريطانية، ومن ثم السوق الدولية، وبصفة خاصة ما تحتاجه من محصول القطن"، وأن هذا الأمر كان الدافع الحقيقى لزيادة رقعة الأرض الزراعية، من خمسة إلى سبعة ملايين فدان، كان مايزرع منها قطناً مليون ونصف المليون فدان، أغلبها كان مملوكاً لغير المصريين!.
ويذكر الباحث أنه فى حين أن ملكيات المصريين للأرض، كانت " تُقَسّمُ عادةً بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، فإن ملكية الأجانب كانت كبيرة دائمة، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، ففى سنة 1919 بلغت نسبة الملكيات الكبيرة للأجانب 92.9% من مجموع الملكيات الأجنبية، 93.0% فى عام 1929، 91.2% فى عام 1931 ، ثم وصلت إلى 90.9% فى عام 1949"!.
ويرصد الباحث مظهراً آخرَ من مخازى ذلك العصر، كان من أبرز الملامح فى "خريطة توزيع الملكية الزراعية"، عشية 23 يوليو1952: "التركيز الشديد فى ملكية الأرض الزراعية، والتزايد المستمر والسريع فى عدد صغار الملاك الزراعيين بالنسبة لرقعة الأرض الزراعية، فحوالى 0.4% من ملاك الأراضى الزراعية (كانوا) يملكون 34.2% من المساحة المزروعة فى مقابل 72% منهم يملكون 13.1% من هذه الأراضى، ويوجد من جهة ثانية حوالى 11 مليون مواطن معدم فى الريف" !.
ورغم تعدد المحاولات التى تقدم بها نفر من "عقلاء" الدولة والمجتمع، (محمد خطّاب، وابراهيم شكرى، وآخرين)، لإقرار قانون يُحد من الإفراط الجنونى فى تَمَلُّك الأرض، فى محاولة للحد من التفاوت الطبقى المريع، الذى كان سيقود، حتماً، إلى انفجار قريب لا مجال لتلافيه، "كان الفشل حليف جميع المحاولات المتعددة من قبل القوى الاجتماعية لإحداث التعديل فى خريطة توزيع الملكية فى الريف المصرى قبل 1952، فقد أعلنت البورجوازية الحاكمة مراراً رفضها التام لأى تقييد للملكية الزراعية. وهو الإجراء الذى اتخذته حكومة الثورة، وقامت بإعادة توزيع نحو مليون فدان لصالح صغار الفلاحين، مما أدى إلى توسيع قاعدة الملكية الصغيرة، فى مرحلة أولى، ثم تفتيتها، فى مرحلة ثانية، ثم تركيزها فى مرحلة ثالثة، حينما ابتلعت الملكيات الكبيرة الملكيات القزمية"!.
لا ديمقراطية أو ليبرالية، مع فقر وجهل!
وفى مثل هذه الأوضاع، كان لابد وأن ينتشر الفقر، والمجاعات، والأوبئة، ويسود الجهل والأمية، وينتعش الدجل، وتهيمن الخرافة، وأن تكون الوظائف المميزة، والمساكن الفاخرة، والشوارع الحديثة، وكذا المدارس المُجَهّزة، والجامعات المتطورة، ويكون ارتياد دار الأوبرا، ودور السينما، والتردد على المطاعم، والنوادى، المغانى، والمراقص ... إلخ، مقصوراً على أولاد "النخبة"، أو "الإيليت"، أو أفراد النصف فى المائة من زبدة المجتمع، وليس حَقّاً مستحقاً لباقى فئات المواطنين!.
وهذا المناخ المتردى، لا يمكن، بأى مقياس، أن يُنتج تجربة "ليبرالية" صحيحة، وإلا نكون مجموعة من الواهمين، غير العلميين، نبنى آراءنا على ركائز متهاوية، ونُشيِّد قصوراً من الرمال، ونعبد آلهة من "العجوة"، أو نسجد لأصنامٍ من الحجارة!.
فـ "الليبرالية" ليست اختراعاً تكنولوجياً، يمكن تشغيله، بمجرد كبسة على الزر، يستوى فى ذلك، إن كان المستخدم فوق ناطحة سحاب فى نيويورك، أو يمتطى جملاً فى جوف الصحراء!.
"الليبرالية" تجربة إنسانية، إبنة تطور تاريخى ـ اقتصادى مُحدد، وظروف اجتماعية وثقافية خاصة، ونتاج بيئة محددة، تعود إلى أوائل القرن الثالث عشر، حينما صدرت وثيقة "الماجنا كارتا"، عام 1215 فى انجلترا، وهى منذ ذلك الحين، شجرة تنمو باستمرار، وتشترط توافر تربة صالحة، ومناخ مُناسب، حتى تؤتى ثمارها!.
"الليبرالية" بنت عهود انتشار العلم، والإيمان بالمنهج العلمى، وشيوع النظرة المادية، بالمعنى الفلسفى، للحياة، وهى نتاج عصور"التنوير" و"النهضة"، وجهود "الإصلاح"، بل "الثورة" على الكهنوت الديني، وهى مُنتج للثورة الصناعية، والفتوحات العقلية والفكرية، قبل الفتوحات الجغرافية، وهى صدى شعارات الثورة الاجتماعية، ومفاهيم الحرية والإخاء والمساواة، فكيف لها أن تنبت وسط أشواك الاستبداد الدينى والسياسى، وفى غابة البؤس الاجتماعى، والجهل وغياب المعارف، والتعصب الدينى والاجتماعى والثقافى؟!.
وبعبارات أخرى، فإن الليبرالية هى المُعادل السياسى للفكر الرأسمالى الحديث، ومصر كانت دولة شبه إقطاعية، المسار الرأسمالى فيها كان فى بداياته المتعثرة، بل وحتى رأسماليوها كانوا من أصول فكرية محافظة، ينتمون إلى طبقة كبار المُلاّك، التى تنظر إلى باقى طبقات الشعب باستعلاء، أن لم يكن باحتقار، ولا ترى إلا فى نفسها، من يستحق قيادة "الأمة"، على نحو ما عبَّر الدكتور "أحمد لطفى السيد"، فيلسوف "حزب الأمة"، بقوله: إن زعماء الحزب من أعيان ووجهاء الأمة: "هم أصحاب المصالح الحقيقية، الأمر الذى يسوِّغ لهم، دون غيرهم، التصدى للعمل السياسى، دفاعاً عن مصالحهم، التى هى فى رأيهم "إجماع الأمة"!.
وهذا الأمر لم يكن مستغرباً، وحينما تعالت الأصوات مطالبة بـ "الدستور"و"الديمقراطية"، كتب السير"إلدن جورست"، المندوب السامى البريطانى، تقريراً مبنياً على استقصاء ميدانى، يطمئن الإدارة الاستعمارية فى لندن، على أن "القضية لا تعدو أن تكون شكلاً من "صخب الأفندية"، الذين يمكن إسكاتهم فى أى وقت"!( بعصا أو جزرة!)..
فالدستور مجرد حبر على ورق، تدهسه أقدام "أفندينا"، "ولى النعم"، متى أراد.. والانتخابات، إلا فيما ندُر، يُساق لها الناس كالقطيع، بأمر "الباشا" أو "العمدة" أو "الحكمدار" أو "البيه"، أو "المرشد" ... فأوامرهم لا تُرد، وتعليماتهم لا تُرفض!.
وعلى ذلك، فلم يكن غريباً ألا يحكم "حزب الأغلبية"، حزب "الوفد"، طوال "الحقبة الليبرالية المُدَّعاه، (1919 – 1952)، أى حوالى ثلث القرن، إلا ست سنوات وبضعة أشهر، وكان كلما انتُخب، بإرادة شعبية، "ديمقراطية"، تحرك خصومه فى القصر، ومن قوى وأحزاب الأقليات، لإقصائه، ولتعليق الدستور، وحتى لإعلان الأحكام العرفية، ومصادرة الحريات، وإبطال الصحف، وانقض على السلطة (ليبراليون) مستبدون من نوع "محمد باشا محمود"، أو"اسماعيل صدقى باشا"، "الأب الروحى" للرأسمالية المصرية، ورجل "اتحاد الصناعات الأول"، وصاحب جريمة اختلاق أو "فبركة"، "المؤامرة الشيوعية الكبرى"، عام 1946، التى اعتقل بموجبها أكثر من مائتى مثقف وسياسى ووطنى كبير، والذى يُفترض فيه أن يكون "الراعى الرئيسى" للتجربة "الليبرالية المصرية" المزعومة!.
فالديمقراطية الليبرالية حسب المقاسات المصرية، كانت، ولاتزال، ديمقراطية مُحكَمةَ التفصيل، ومضبوطة على مقاس الطبقات الغنية والحاكمة، وجاءت البرلمانات دائماً لاستكمال الوجاهة السياسية قبل أى شيء، ( أليس المثال الهادى أن تكون مصر قطعة من أوروبا !)، ومع ذلك لم تشهد مصر قَط ، برلماناً أسقط حكومة، أو وزارة، واحدة، منذ الانعقاد الأول، من خلال "مجلس شورى النواب"، عام 1866، بينما كان حل البرلمان لعبة الملك الفاسد والحكومات الاستبدادية، وقتما شاءت "الإرادة السامية" ومتى أرادت مشيئة "ولى النعم"!.
وتأسيساً على ماتقدم، فباسم ليبرالية "القص واللصق"، على النمط المصرى، الممتد عرضها الهزلى من أوائل القرن الماضى، وحتى الآن، فلم يكن مستغرباً أن ماتقدم كان مُمَهِّداً لأن يدخل برلماناتنا، فى الماضى، وأيضاً فى الحاضر، كما يكتب المؤرخ الكبير د."يونان لبيب رزق": "أعضاءٌ .. مكانهم الطبيعى ... هو السجن"!.
--------------------
بقلم: أحمد بهاء الدين شعبان